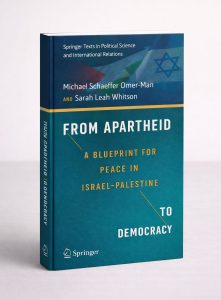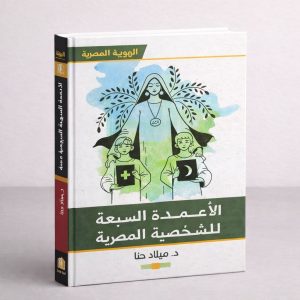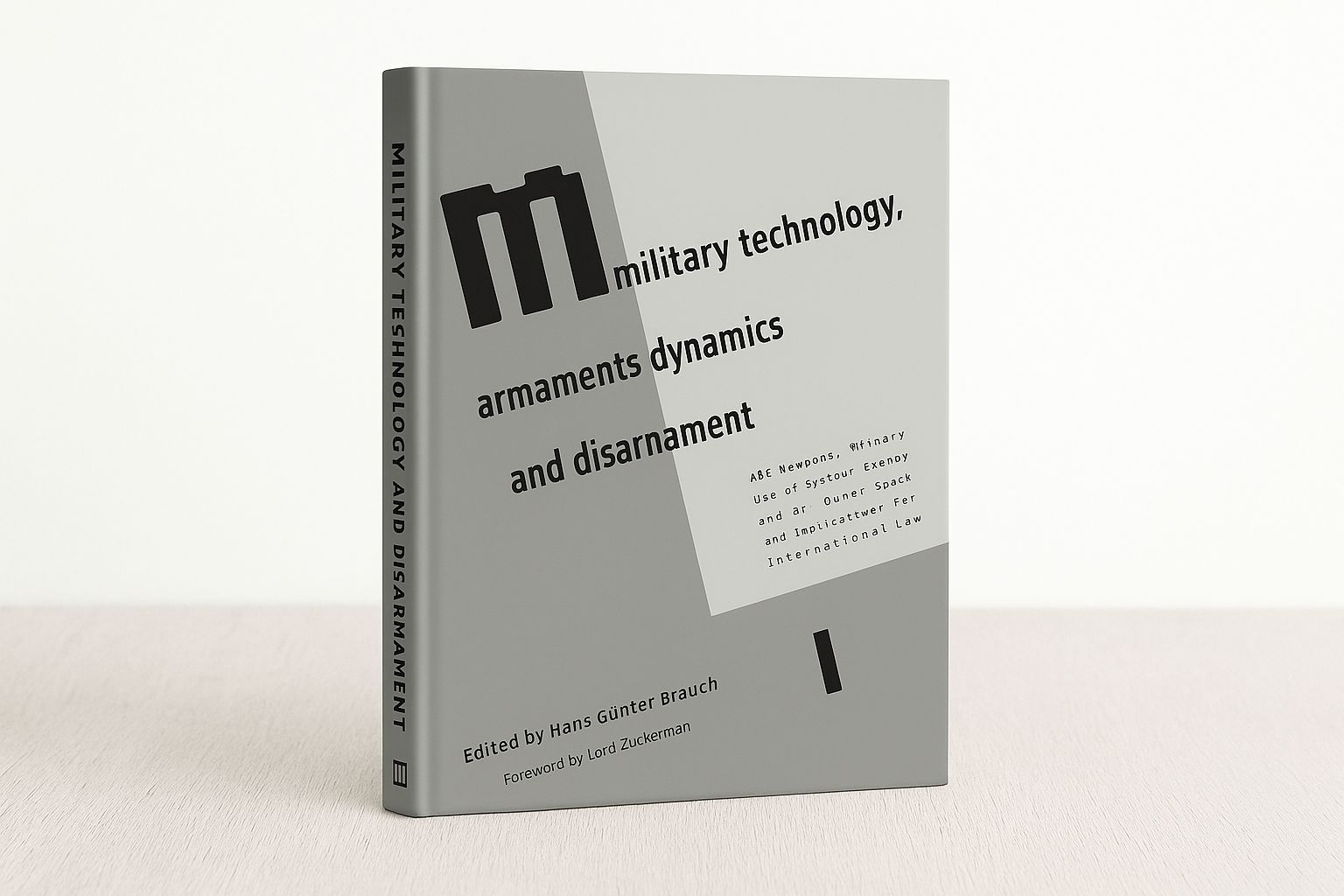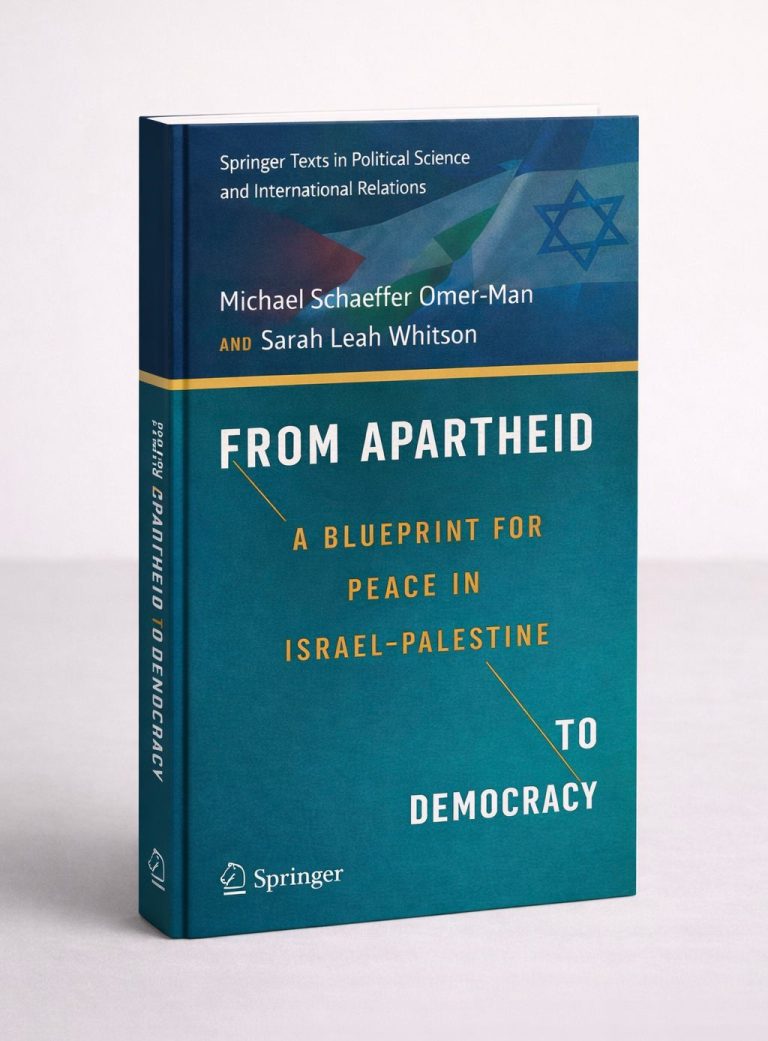يستعرض كتاب : ” Military Technology, Armament Dynamics and Disarmament: ABC Weapons, Military Use of Nuclear Energy and of Outer Space and Implications for International Law” التكنولوجيا العسكرية، ديناميكيات التسلح ونزع السلاح: أسلحة ABC، الاستخدام العسكري للطاقة النووية والفضاء الخارجي وانعكاساتها على القانون الدولي”. للكاتب “هانز جينتر براوخ”. التحليل الشامل للعلاقة المعقدة بين التطور التكنولوجي العسكري المتسارع واستراتيجيات التسلح ونزع السلاح، وذلك في فترة تاريخية حرجة هي نهاية الحرب الباردة. ويناقش بشكل خاص التحديات التي تفرضها أسلحة الدمار الشامل (النووية والبيولوجية والكيميائية) والاستخدامات العسكرية للطاقة النووية والفضاء الخارجي، مسلطًا الضوء على كيفية اختبار هذه التطورات لقدرة القانون الدولي على مواكبتها والتحكم فيها. والصادر في طبعته الأولي في عام 1990، عن دار النشر الأمريكية “سانت مارتن”، بنيويورك
الكاتب البروفيسور الألماني ” هانز جينتر براوخ ” ورئيس مجموعة دراسة IPRA حول تكنولوجيا الأسلحة ونزع السلاح وأبحاث السلام ودراسات الأمن الأوروبي (AFES-PRESSJ)، و أكاديمي مرموق متخصص في الدراسات الأمنية ومحاضر في معهد العلوم السياسية، جامعة هايدلبرغ، بالجريف ماكميلان بألمانبا.
يتكون هذا الكتاب من خمسة أجزاء، بحيث يستعرض الجزء الأول: التكنولوجيا العسكرية ونظرية ديناميات التسلح، بينما يناقش الجزء الثاني: التكنولوجيا العسكرية – حالة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ، ويناقش في الجزء الثالث: الاستخدام العسكري للطاقة النووية – حالة القاذفات والفضاء الخارجي، ويعرض في الجزء الرابع: التكنولوجيا العسكرية – الدفاع الصاروخي الباليستي ومبادرة الدفاع الاستراتيجي (حرب النجوم)، أما الجزء الخامس: الاستخدام العسكري للفضاء الخارجي – الآثار على القانون الدولي.
الجزء الأول: التكنولوجيا العسكرية ونظرية ديناميات التسلح
يشرح الكاتب في الجزء الأول كيف أصبحت التكنولوجيا العسكرية المحرك الأساسي لسباق التسلح العالمي، حيث لم يعد التنافس قائمًا فقط على الكم، بل على التطور النوعي المتسارع الذي يدفع باستمرار إلى إنتاج أسلحة جديدة أكثر تعقيدًا. هذا التطور يؤثر مباشرة على ديناميات التسلح ويقوّض فرص تحقيق الاستقرار الاستراتيجي الذي يعتمد على ضبط سباق التسلح، منع التصعيد في الأزمات، وضمان السيطرة على القرارات العسكرية. لكن، في الواقع، الاتفاقيات الدولية للحد من التسلح ركّزت غالبًا على الأعداد وأهملت البعد التكنولوجي، مما جعلها غير فعّالة. كما أن تشابك مصالح المجمع الصناعي–العسكري–السياسي يعزز هذا السباق ويعيق السيطرة عليه وينتج عن ذلك أن التكنولوجيا العسكرية تمثل في الوقت نفسه قوة دافعة للتسليح وعائقًا أمام ضبطه، مما يجعل من الضروري إدماج الضبط النوعي للتطور التكنولوجي مع الضبط الكمي، وتوجيه الموارد نحو التنمية والسلام بدلاً من سباقات التسلح.
الجزء الثاني التكنولوجيا العسكرية – حالة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية
يستعرض الكاتب في هذا الجزء ثلاثة نماذج من أسلحة الدمار الشامل ويوضح كيف يشكل كل منها تحديًا للسيطرة على التسلح. يبدأ بعرض الأسلحة النووية من الجيل الثالث مثل القنبلة النيوترونية، الليزر النووي المضاد للصواريخ، وسلاح النبضة الكهرومغناطيسية (EMP)، موضحًا كيف صُممت لتعظيم تأثيرات معينة وتقليل أخرى، مما يغيّر طبيعة الحرب التقليدية . ثم يناقش الاستجابات الدبلوماسية للتطورات العلمية في مجال الأسلحة البيولوجية، خاصة في المؤتمر الاستعراضي الثاني لاتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1986، حيث برزت الحاجة إلى مؤسسات علمية استشارية لمواكبة التطور التكنولوجي وضمان فاعلية نظام نزع السلاح . وأخيرًا، يتناول التسلح الكيميائي من منظور العرض والطلب والتكامل في العقيدة العسكرية، مبرزًا دور الاكتشافات التكنولوجية (مثل الغازات العصبية والعوامل النباتية) في استمرار برامج الأسلحة الكيميائية رغم الحظر الدولي، وخطورة انتشارها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية .
الجزء الثالث: الاستخدام العسكري للطاقة النووية: حالة القاذفات والفضاء الخارجي
يتناول الكاتب في هذا الجزء حالتين أساسيتين من توظيف الطاقة النووية عسكريًا خارج نطاق الأسلحة التقليدية. الأولى هي مشروع القاذفة ذات الدفع النووي في الولايات المتحدة خلال الأربعينيات والخمسينيات، والذي اتضح أنه سباق تسلح وهمي مع الاتحاد السوفيتي؛ حيث بُني على تقديرات استخباراتية مضللة وذعر سياسي، ما أدى إلى إنفاق أكثر من مليار دولار على مشروع لم يكن عمليًا تقنيًا ولا أخلاقيًا بسبب أخطار الإشعاع على الطواقم الجوية. وتتعلق الحالة الثانية باستخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، سواء لأغراض الدفع (الصواريخ النووية الحرارية، الدفع النبضي، الدفع الكهرو–نووي)، أو لتوليد الكهرباء عبر المولدات النووية، أو في تطوير أسلحة الطاقة الموجهة الفضائية. ويناقش الجزء أيضًا حوادث فعلية لانفجار مفاعلات نووية أو مولدات حرارية مشعة في الفضاء، ويعرض الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لوضع نظام رقابي على هذه الاستخدامات. لكن الاستنتاج الرئيس أن التكنولوجيا النووية في الفضاء ما زالت خارج السيطرة الفعلية، وتمثل خطرًا متزايدًا على الاستقرار الدولي .
الجزء الرابع: التكنولوجيا العسكرية: الدفاع الصاروخي الباليستي ومبادرة الدفاع الاستراتيجي (حرب النجوم)
يركز الكاتب في هذا الجزء على مبادرة الدفاع الاستراتيجي (SDI) التي أطلقها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 1983 والمعروفة باسم “حرب النجوم”، والتي مثّلت أكبر مشروع بحث وتطوير عسكري في التاريخ الحديث. الفكرة كانت بناء نظام متعدد الطبقات للدفاع ضد الصواريخ الباليستية باستخدام أسلحة طاقة موجهة مثل (الليزر وأشعة الجسيمات) وأنظمة “القتل الحركي”، بعضها قائم على الفضاء. يناقش الباحثون في هذا الجزء أبعاد مختلفة: فمنهم من رأى أن SDI تمثل تحولًا جوهريًا في طبيعة الحرب لأنها قد تُستخدم بشكل هجومي لتحقيق تفوق عسكري كامل دون تعريض الجنود للخطر ، بينما قدّم آخرون تقييمات تقنية متشككة حول جدواها وفاعليتها أمام إجراءات مضادة سوفيتية مثل الصواريخ السريعة والطعوم الفضائية . كما حذّر محللون من أن البرنامج يهدد الاستقرار الاستراتيجي لأنه يعطي إحساسًا بالحماية الذاتية مع بقاء التهديد النووي قائمًا للطرف الآخر . جزء من النقاش تناول أيضًا التناقضات في خطاب الإدارة الأمريكية حول أهداف البرنامج، ما إذا كان دفاعيًا بحتًا أو جزءًا من سباق تسلح جديد، حيث اعتبره البعض نتيجة لتأثير لوبي العلماء والعسكريين المقربين من ريغان أكثر من كونه ردًا مباشرًا على برامج سوفيتية .
الجزء الخامس: الاستخدام العسكري للفضاء الخارجي – الآثار على القانون الدولي
يركز الكاتب في هذا الجزء على البُعد القانوني الدولي لاستخدام الفضاء الخارجي عسكريًا، من خلال ثلاث دراسات. أولًا، يستعرض تطور النظام القانوني منذ أواخر الخمسينيات وحتى معاهدات رئيسية مثل معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية عام 1963 ، ومعاهدة الفضاء الخارجي 1967، ومعاهدة حظر تعديل البيئة 1977، واتفاقية القمر 1979، إضافة إلى معاهدة ABM 197 واتفاقية SALT II 1979، مبرزًا كيف حاولت هذه الصكوك الحد من عسكرة الفضاء . ثانيًا، يناقش التحديات التي فرضتها برامج الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية (ASAT) وأنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي الفضائية (BMD/SDI)، موضحًا أن معاهدة الفضاء الخارجي تقيد بعض الأنشطة لكنها لا تحظرها بشكل كامل، مما يخلق توترًا مع معاهدة ABM ثالثًا، يطبق تحليل قانون المعاهدات (اتفاقية فيينا 1969) على تفسير معاهدة ABM، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع المبنية على “مبادئ فيزيائية أخرى” (مثل الليزر أو أشعة الجسيمات) تظل خاضعة لأحكامها، وأن الاختبارات الميدانية لهذه الأنظمة تعتبر مخالفة، بينما الأبحاث وحدها لا تُعد انتهاكًا .
رغم أن الكتاب شاملا، إلا أن الكاتب أغفل عدة جوانب مهمة وهي:
- البُعد الاقتصادي–الاجتماعي المباشر: ركّز على سباق التسلح بين القوى الكبرى، لكنه لم يتناول بشكل كافٍ تأثير الإنفاق العسكري على التنمية الاقتصادية، الفقر، والعدالة الاجتماعية في الدول النامية.
- المنظور الإقليمي: ركّز على الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (الحرب الباردة)، بينما أغفل دور الشرق الأوسط، آسيا، وأفريقيا كمناطق متأثرة بشدة بانتشار الأسلحة.
- البعد الإنساني والأخلاقي: ناقش الأسلحة من منظور استراتيجي وقانوني، لكنه لم يمنح مساحة كافية لصوت الضحايا المدنيين أو الاعتبارات الإنسانية، خاصة مع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
- التكنولوجيا الرقمية والسيبرانية: مع أنه كتب في الثمانينيات، إلا أنه لم يستشرف تأثير الثورة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم جزءًا أساسيًا من ديناميات التسلح.
- دور الرأي العام والحركات الشعبية: ركّز على الحكومات والعلماء، لكنه لم يُبرز بما يكفي دور الحركات المناهضة للحرب ونزع السلاح (مثل حركات السلام الأوروبية أو حركة عدم الانحياز).
باحث في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب