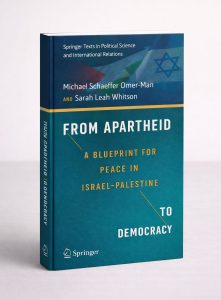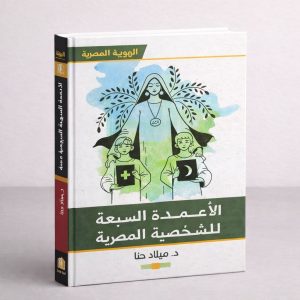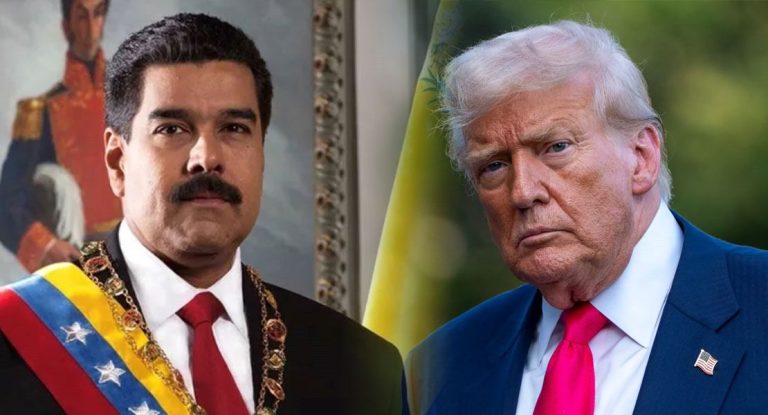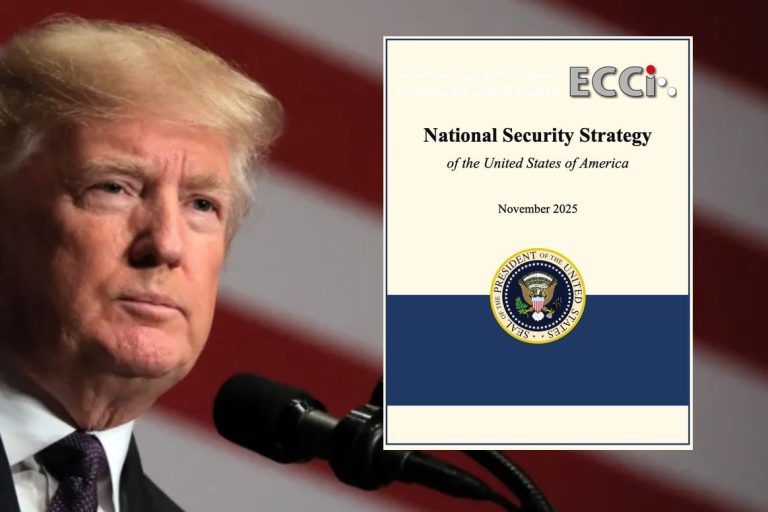مقدمة:
يشكّل الثالوث السياسي المكوَّن من السلطة، والمقاومة، والبلاغة السياسية[1] إطارًا نظريًا كاشفًا لفهم الكيفية التي تُنتج من خلالها السياسة ذاتها، لا بوصفها ممارسة مادية فحسب، بل كمنظومة لغوية ومعرفية تُعيد تشكيل الواقع وترتيب علاقات القوة داخله. فالسلطة، لا تستمد جوهرها من أدوات القهر وحدها، بل من قدرتها على إنتاج الخطاب وتطبيع هيمنته عبر اللغة، بما يجعل السيطرة تبدو عقلانية ومشروعة[2]. ومن ثمّ تتحوّل اللغة إلى أداة سلطة، ويصبح الخطاب ميدانًا للصراع الرمزي حول تعريف الحقيقة، وتحديد من يملك الحق في النطق بها.
والمقاومة، بهذا المعنى، هي محاولة لاستعادة القدرة على إنتاج المعنى، أي استرداد الحق في التشارك في هذا الفضاء الذي احتكرته السلطة السياسية والإعلامية والدبلوماسية معًا. أما البلاغة السياسية فهي نقطة الالتقاء بين السلطة والمقاومة، إذ تشكّل حقلًا يتقاطع فيه منطق الإكراه مع منطق الإقناع، وتتكشف من خلاله استراتيجيات الهيمنة والممانعة في آنٍ واحد، كون الصراع على الخطاب هو صراع على المعنى ذاته، وعلى تحديد من يُعرّف الواقع ومن يُقصى عن تعريفه[3].
ومن هنا، يغدو تحليل الخطاب السياسي ممارسة نقدية مقاومة لا تكتفي بوصف المضمون، بل تسائل البنية الرمزية التي تَشرعن الفعل السياسي وتُنتج الممكن والمستحيل داخله. فالخطاب ليس انعكاسًا للواقع بل أداة لتشكيله وإعادة إنتاجه بحسب رؤية فيركلوف[4]؛ ومن ثمّ فإن فعل التحليل ذاته يصبح مقاومة رمزية تسعى إلى إعادة توزيع سلطة المعنى وكشف ما يحجبه الخطاب من علاقات قوة، فيتحول النص السياسي إلى ساحة يتجاور فيها الوعي والسلطة، واللغة والأيديولوجيا.
تكتسب دراسة الخطابات السياسية، خصوصًا تلك الصادرة عن الفاعلين المؤثرين في بنية النظام الدولي، أهمية مضاعفة، إذ تكشف عن البنى الذهنية التي تُؤطر الممارسة السياسية وعن التمثّلات الخطابية التي تُعيد تعريف الذات والآخر وتوجّه الفعل الدبلوماسي والاستراتيجي. وفي هذا الإطار، يقدم خطاب توم باراك، رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي المقرّب من دوائر صنع القرار في واشنطن والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، نموذجًا بالغ الدلالة لما يعكسه من محاولات إعادة صياغة العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي ضمن رؤية تسعى إلى إعادة تعريف مفاهيم التحالف والاستقرار والأمن والتهديد، بما يخدم مشروعًا استراتيجيًا أمريكيًا متجدّدًا.
يقوم هذا التحليل على مقاربة متعددة المستويات تسعى إلى تفكيك البنية العميقة لخطاب باراك عبر محاوره الفكرية والرمزية:
- إعادة قراءة العقل السياسي الأمريكي في ضوء التوترات الإقليمية.
- تحليل الرؤية الأمريكية للعالم العربي كفضاء لإعادة إنتاج الهيمنة بأدوات ناعمة.
- استكشاف انعكاسات هذه الرؤية على هندسة التحالفات الإقليمية.
أولًا: إعادة قراءة العقل السياسي الأمريكي في ضوء التوترات الإقليمية:
يمتلك العقل السياسي الأمريكي بنية فكرية مميّزة تتجاوز حدود الممارسة السياسية اليومية لتتجذّر في ما يمكن وصفه بـ”الاستثنائية الأمريكية[5]“، أي ذلك الإحساس التاريخي بأن الولايات المتحدة ليست دولةً بين دول، بل مشروعًا حضاريًا له رسالة كونية تتعلق بإعادة تشكيل العالم وفق قيمه الخاصة. أسست هذه الفكرة لنسقٍ ذهني يرى في الذات الأمريكية مركزًا أخلاقيًا للعالم، وفي الآخر -خصوصًا غير الغربي- مجالًا لإعادة التهذيب أو الاحتواء أو الهيمنة.
هذا التصوّر لم يكن مجرّد خطاب ديني أو ثقافي، بل هو في جوهره عقيدة سياسية متكاملة تسكن عمق القرار الأمريكي، سواء في صياغة السياسات الخارجية أو في إنتاج الخطابات الموجِّهة للرأي العام. وتفترض الأدبيات أن لهذه الاستثنائية الأمريكية ثلاث ركائز رئيسية: الاختلاف عن أوروبا، والدور الفريد في التاريخ، والتحرر من قوانين التاريخ[6].
تجادل الأدبيات أن السياسة الخارجية الأمريكية كانت تقوم على مدرستين تفسيريتين يتناوبان مواضعهما في مواطن متفرقة من التاريخ الأمريكي وهي “مدرسة الانعزالية” و”مدرسة التدخل”، ولكن تقود النظرة الثاقبة إلى التوصل إلى إجابة مفادها أنه في كلتا الحالتين ظلت الرغبة في إصلاح العالم هي القوة الدافعة الدائمة، وظلت الانعزالية فترة انتقالية تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وإصلاح ذاتها قبل أن تعود لمدرسة التبشير أو التدخل[7].
وقد عبّر العديد من المفكرين الأمريكيين عن هذه النزعة الاستثنائية في العقل الأمريكي، من والتر ليبمان إلى صمويل هنتنغتون، حين ربطوا بين قيادة أمريكا للعالم هيمنةً وقوةً وبين “حماية النظام الليبرالي” أو “صيانة القيم الغربية”، ما يجعل العقل السياسي الأمريكي محكومًا بثنائية مستمرة قد أشار إليها نعوم تشومسكي: الدفاع عن القيم بوصفها مبررًا لاستخدام القوة[8]. هذه الثنائية تنتج خطابًا سياسيًا يمزج بين البراغماتية والتبشيرية، وبين الواقعية المصلحية والخلاصية الأخلاقية، بحيث يغدو الخطاب ذاته أداة لإعادة إنتاج هذه التناقضات اللفظية.
وفي هذا الإطار، لا يُمكن قراءة خطاب توم باراك بمعزل عن هذه البنية الذهنية التي تُشكِّل جوهر العقل السياسي الأمريكي. فهو لا يُعبّر عن صوتٍ فردي بقدر ما يُجسّد تمظهرًا دالًا لهذا العقل في لحظة مأزومة تحاول فيها الولايات المتحدة إعادة تعريف علاقتها بالشرق الأوسط في ظل تراجع نفوذها النسبي وصعود قوى منافسة كالصين وروسيا. ومن ثمّ، فإن تحليل خطابه يتيح لنا فهم الكيفية التي تعمل بها “الاستثنائية الأمريكية” في فترات الأزمات، حين تسعى إلى التكيّف دون التخلّي عن مركزيتها الرمزية.
تُظهر قراءة نقدية لهذا الخطاب أن الولايات المتحدة تمرّ بمرحلة انتقالية حاسمة في سياستها الخارجية عامةً، وفي مقاربتها للشرق الأوسط على وجه الخصوص، إذ يتجلّى “مبدأ ترامب[9]” بوصفه أحد أبرز تمثلات هذا التحول في الذهنية الأمريكية الحديثة. ولا يمكن فهم هذا المبدأ كقطيعة مع الاستثنائية الأمريكية، بقدر ما هو إعادة تأويلٍ لها في ضوء منطقٍ مصلحيّ أكثر صراحة وأقلّ تجميلًا بالقيم الليبرالية. فقد أعاد ترامب صياغة شعار “أمريكا أولًا” ليصبح محور العقيدة السياسية الجديدة، محوِّلًا الرسالة الكونية الأمريكية من مشروعٍ عالمي لتعميم الديمقراطية إلى مشروعٍ قومي يستند إلى البراغماتية الاقتصادية والأمنية.
ورغم ما يبدو من نزعة انكفائية أو انعزالية في هذا الشعار، إلا أنه في جوهره يعيد إنتاج النزعة التبشيرية ذاتها، ولكن بلغة القوة المجرّدة لا بلغة المثال الأخلاقي. فبدلًا من حماية “النظام الليبرالي الدولي”، غدا الحفاظ على الهيمنة الأمريكية هدفًا في حد ذاته، تُبرَّر باسمه سياسات الانسحاب كما التدخل على السواء.
ويمكن اعتبار خطاب باراك دليلًا عمليًا على صحة الفرضية التي تفترض أن الولايات المتحدة، سواء في طور الانعزالية أو التبشير، تظل مدفوعةً برغبةٍ دائمة في إصلاح العالم وإعادة تشكيله وفق تصوراتها الخاصة، بما يعزز موقعها كقوة دافعة ومهيمنة على النظام الدولي. ويتجلى ذلك بوضوح حينما سُئل باراك عن التدخل الأوروبي والدولي في دعم القضية الفلسطينية، فأعلن –رغم انتمائه إلى سياق انعزالي– أن هذا شأن داخلي يخصّ الولايات المتحدة وإسرائيل فحسب، في إشارةٍ إلى احتكار الحق في تعريف القضايا الدولية وتحديد من يُسمح له بالتدخل فيها.
كما يمكن ملاحظة أن الخطاب يُعيد تأويل الاستثنائية الأمريكية ضمن إطار واقعي براغماتي صريح، خاصةً في حديثه عن الدول غير الديمقراطية وطبيعة التحالفات معها، إذ عبّر عن دعمٍ واضح لما أسماه “الملوك المستنيرين”، في ما يُمثّل تبريرًا جديدًا لاستمرارية التحالف مع النظم غير الليبرالية تحت مظلة “الاستقرار” و”المنفعة المتبادلة”. وهو ما يكشف عن انزياحٍ في الخطاب الأمريكي من تبرير التدخل تحت ذريعة القيم، إلى تبريره تحت ذريعة المصالح، دون أن يتخلى في الجوهر عن مركزية الذات الأمريكية في قيادة العالم.
يتصل هذا التحول في جوهره بالبنية الداخلية لصناعة القرار الأمريكي، حيث شهدت المؤسساتية الديمقراطية الأمريكية مع صعود ترامب مرحلة من إعادة التشكل البنيوي يمكن توصيفها بظهور “الشخصانية الترامبية” كنسقٍ جديدٍ من ممارسة السلطة. إذ لم تعد الديمقراطية الأمريكية تدار وفق النموذج المؤسسي البيروقراطي الصارم الذي حكمها لعقود، بل اتجهت نحو نمط شخصاني تُختزل فيه الدولة في شخصية الزعيم، وتتحول فيه الكاريزما إلى مصدرٍ للشرعية السياسية، على حساب الرصيد المؤسسي والتقاليد الدستورية الراسخة.
في هذا السياق، لم يكن “مبدأ ترامب” مجرد تحوّل في السياسة الخارجية، بل انعكاسًا لتحوّلٍ أعمق في الذهنية الحاكمة داخل المؤسسات الأمريكية ذاتها. فقد أُعيد تعريف العلاقة بين الفرد والمؤسسة، بحيث تراجعت سلطة المؤسسات التقليدية –كالكونغرس ووزارة الخارجية ومراكز الخبرة– أمام سطوة القرار الفردي، وهو ما جعل من الخطاب السياسي الأمريكي نفسه انعكاسًا لصراعٍ خفي بين المؤسسية الديمقراطية التي تُمثّل روح النظام، وبين الفردانية الشعبوية التي تسعى إلى إعادة بناء الشرعية عبر مخاطبة العاطفة الجماهيرية لا العقل المؤسسي.
ويُجسّد خطاب توم باراك هذا التحوّل بوضوح لافت، إذ تكشف لغته عن إعادة تموضع الولاء السياسي من المؤسَّسة إلى الشخص، ومن الدولة إلى الزعيم. ففي مواضع متفرقة من خطابه، تتكرّر عبارات تُعيد صياغة السلطة في صورة ولاء شخصي مباشر، مثل قوله “أنا أوافق على سياسة الرئيس“، و”أنا مرتزق مدفوع لإنجاز المهام للرئيس“، و”بتوجيهٍ من رئيسي“. وهي تعبيرات تُظهر بوضوح أن الفاعل السياسي لم يعد يتحدث من موقع الشراكة المؤسسية، بل من موقع التفويض الشخصي، ما يجعل الخطاب ذاته أداةً لإعادة إنتاج هيمنة الزعيم وتكريس مركزية القرار الفردي داخل بنية الدولة.
وتنعكس هذه المقاربة الجديدة في مضامين الخطاب ذاته، حيث تظهر ملامح “مبدأ ترامب” في ميله إلى إعادة تعريف دور الولايات المتحدة من فاعلٍ مباشرٍ إلى موجّهٍ عن بُعد. ففي حديثه عن لبنان، صرّح باراك بعبارات تكشف بجلاء هذا التحول قائلًا: “هذا ليس عملنا. نحن لن نفعل ذلك. سنرشد. سنعطي نصائحنا. سنساعد. لكن عليهم أن يحلوا الأمر بأنفسهم”.
وبذلك، يتحول الخطاب السياسي إلى مرآةٍ تُعكس فيها الأزمة البنيوية للمؤسساتية الأمريكية في عهد ترامب: إذ لم يعد الخطاب تعبيرًا عن إرادة جماعية مؤسسية، بل عن صوتٍ تابعٍ للزعيم يكتسب شرعيته من القرب لا من الكفاءة، ومن الولاء لا من المبدأ. ومن ثمّ، يطرح هذا التحوّل تساؤلاتٍ جوهرية حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية في ظلّ هذا التداخل بين الكاريزماتية والفردانية من جهة، والمأسسة والعقلانية القانونية من جهة أخرى. فهل يمكن للنظام الأمريكي أن يحافظ على طابعه المؤسسي في ظل تغوّل الزعامة الفردية؟ أم أن التجربة الترامبية دشّنت بداية مرحلةٍ هجينة يمكن وصفها بـ”الديمقراطية الكاريزمية”، حيث تتلاقى المؤسساتية مع الشخصانية في بنيةٍ جديدة من الحكم؟
ثانيًا: الرؤية الأمريكية للعالم العربي:
تشكّل الخطابات السياسية الأمريكية تجاه العالم العربي امتدادًا لرؤية أيديولوجية راسخة تتجاوز اعتبارات السياسة الظرفية إلى بنية ثقافية متخيلة عن “الشرق” بوصفه فضاءً للفوضى واللاعقلانية يحتاج دائمًا إلى من “يرشده” أو “ينظمه”. هذه الرؤية، التي أعاد إدوارد سعيد تفكيكها في مفهوم الاستشراق الجديد، لا تزال حاضرة في الخطاب السياسي الأمريكي المعاصر، وإنْ اكتست ثوب الواقعية السياسية بدلًا من الخطاب الاستعلائي الصريح. فبدلًا من الحديث عن “رسالة الحضارة”، أصبح الحديث عن “الحوكمة الرشيدة” و”الإصلاح المؤسسي”، لكن الجوهر واحد: علاقات هيمنة تُمارَس باسم المعرفة والخبرة.
وقد انعكست هذه الرؤية بوضوح في خطاب توم باراك الذي يُعيد إنتاج التراتبية الاستشراقية ذاتها وإنْ بصيغة أكثر دبلوماسية. فهو يُظهر العالم العربي، من لبنان إلى الخليج ومصر والعراق، كحيّز غير قادر على إدارة أزماته إلا بتوجيهٍ أمريكي، فيقول مثلًا: “هذا ليس عملنا… سنرشد. سنعطي نصائحنا. سنساعد. لكن عليهم أن يحلوا الأمر بأنفسهم.” هذه العبارة تُجسّد ما يسميه الباحث روبرت كوكس بـ”الهيمنة عبر الإرشاد[10]“؛ إذ تتخفّى السيطرة خلف خطاب الشراكة والمساعدة.
كما تتجلّى في هذا الخطاب نزعة الثقافوية التبسيطية التي تختزل المشكلات السياسية في خصائص ثقافية مزعومة، كما في القول بأن العرب “لا يملكون كلمة للخضوع في لغتهم“، وهو تعبير يعيد إنتاج صورة العربي المتمرّد على النظام والعقلانية، ويكشف عن حتمية ثقافوية تنكر التاريخ والسياق الاجتماعي والسياسي لصالح التعميم الأنثروبولوجي.
ويتسع هذا التصور الاستشراقي ليشمل إيران وفلسطين في الوقت ذاته. فإيران تُقدَّم في الخطاب الأمريكي كنموذجٍ “للفوضى الممنهجة” التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتُبرّر بقاء المظلّة الأمنية الأمريكية في الخليج، بينما تُختزل فلسطين في كونها “قضية إنسانية” لا سياسية، تُدار بالمساعدات لا بالعدالة، وبالتهدئة لا بالحلول الجذرية. في المقابل، تُصوَّر إسرائيل بوصفها الحليف الطبيعي، والعقل المنظم في محيطٍ عربيٍّ تغلب عليه الانفعالات. هذه الجدلية الثلاثية (العربي – الإيراني – الإسرائيلي) تُشكّل أحد أعمدة الرؤية الأمريكية الجديدة للمنطقة، حيث يُعاد ترتيب الشرق الأوسط لا وفق ميزان القوة الفعلي، بل وفق هرمية حضارية ضمنية تحدد من يستحق القيادة ومن يحتاج الوصاية.
أما الإشارة إلى المسلمين بوصفهم “خمسة مليارات تهديد محتمل” فهي تعبّر عن امتدادٍ رمزي لـ”العقيدة الصليبية” التي ترى في الإسلام تهديدًا وجوديًا طويل المدى، لا سياسيًا فحسب بل حضاريًا. بهذا المعنى، يمكن القول إن الخطاب الأمريكي ما بعد الحادي عشر من سبتمبر قد انتقل من “الاستشراق الكلاسيكي” الذي ينظر إلى الشرق بعين الاستعلاء المعرفي، إلى “الاستشراق الأمني” الذي يُعيد تعريف الهويات على أساس الخطر والتهديد.
وتتفاوت تجليات هذه الرؤية بين الدول العربية وفق موقع كل منها في هندسة المصالح الأمريكية؛ فلبنان يُختزل في كونه بؤرةً للفوضى تحتاج إلى ضبط ذاتي، والخليج يُقدَّم بوصفه فضاءً للثروة يحتاج إلى ترشيدٍ اقتصادي تقوده واشنطن، بينما تُصوَّر مصر باعتبارها شريكًا “عاقلًا” لكنه بحاجة إلى تحديثٍ مؤسسي مستمر، والعراق ساحة اختبار دائمة لفكرة “إعادة البناء من الخارج”. هذه المقارنات لا تعبّر عن مواقف سياسية بقدر ما تكشف عن بنية فكرية متكرّرة في العقل السياسي الأمريكي: أن العالم العربي يُدار لا يُشارك.
ثالثًا: انعكاسات هذه الرؤية على هندسة التحالفات الإقليمية:
إذا كان المحوران السابقان قد أظهرا التحوّل في بنية الخطاب الأمريكي من المؤسسية إلى الشخصانية، ومن الواقعية السياسية إلى الاستشراق الثقافوي، فإن هذا المحور يكشف عن الامتداد العملي لتلك التحولات في إعادة هندسة التحالفات الإقليمية. فخطاب توم باراك لا يقدّم نفسه كتحليلٍ للعلاقات فحسب، بل كخارطة طريقٍ لإعادة صياغة بنية الاصطفافات في الشرق الأوسط بما يتوافق مع عقل ترامب وإدراكه؛ وهو عقلٍ لا يكتفي بتغيير السياسات، بل يسعى إلى إعادة تعريف معنى التحالف ذاته.
في هذا السياق، لم تعد التحالفات في المنظور الأمريكي ترتكز على الالتزامات الأمنية التقليدية كما كان الحال في الحرب الباردة، بل على قابلية الشركاء للتماهي مع النموذج الأمريكي في السلوك والمصلحة. فالشريك المثالي هو من يشارك واشنطن رؤيتها للعدوّ، ويُعيد إنتاج خطابها حول “الخطر الإيراني” أو “تهديد الإسلام السياسي”، دون أن يتطلب ذلك تدخلاً أمريكيًا مباشرًا. هكذا تتحول العلاقة من تحالفٍ متبادل المصالح إلى نظام إداري للولاء الخطابي، حيث تُقاس الثقة بمدى تشابه اللغة لا توازن القوة.
ويُبرز خطاب باراك بوضوح هذا التحول حين يتحدث عن دول الخليج بوصفها “الركائز الجديدة للنظام العربي” القادر على التطبيع والانفتاح، مقابل دولٍ أخرى لا تزال “أسيرة التاريخ” أو “رهينة الأيديولوجيا”. هنا يتجلّى ما يسميه جوزيف ناي بـ”القوة المعيارية” التي تُخضع الفاعلين الإقليميين عبر إغراء الانضمام إلى خطاب الحداثة والأمن، بدلًا من الإكراه العسكري المباشر[11]. وعليه فإن الولايات المتحدة –في هذا المنطق– لا تفرض التحالف بالقوة، بل تُقنع الأطراف بأن مصالحها تمرّ عبر البوابة الأمريكية، وبأن أي استقلالٍ عن هذا الإطار هو مخاطرة وجودية.
يتضح في خطاب باراك أن المنظور الأمريكي في تعريف الولاء لم يعد التعريف المرتبط بالولاء السياسي أو الالتزام بالدولة، بل على اقتصاد الولاء، حيث يُقاس الانتماء والفاعلية بالقدرة المالية والموارد الاقتصادية المتاحة للفرد أو المؤسسة. فالمقارنة بين الجيش اللبناني ومقاتلي حزب الله توضح كيف يُحسب الولاء بالقيمة المادية: دخل المقاتل مقابل قدرته على الاستمرار والمواجهة، بدلًا من الانضباط الرسمي أو الهياكل العسكرية التقليدية. هذا المنطق يتوسع ليشمل دول الخليج، فالإمارات تُقيَّم بقدرتها على الاستثمار التقني والاقتصادي، والسعودية بمواردها الرمزية وإدارتها الداخلية، وقطر بدورها كحلقة وصل استخباراتية نافعة، مما يجعل المال والموارد أداة قياس للتعاون الفعلي والالتزام بالمصلحة الأمريكية. وبهذا يتحوّل الاقتصاد إلى معيار عملي لإعادة ترتيب التحالفات، حيث يصبح الولاء المالي في كثير من الأحيان أقوى من الولاء السياسي أو الهيكلي، ويحدد مستوى الثقة والتفاعل مع السياسات الأمريكية في المنطقة.
كما يظهر في الخطاب ميل واضح إلى هندسة المشهد العربي عبر شبكة من التحالفات المتقاطعة لا المركزية؛ تحالفات تقوم على “المرونة” بدل الالتزام، و”الصفقة” بدل التحالف التاريخي. فالتحالف لم يعد يربط الدول بناءً على الانتماء الإقليمي أو القيمي، بل بناءً على القدرة على خدمة غاياتٍ محددة في لحظةٍ معينة. وهذا ما يُعيدنا إلى مفهوم “السيولة الجيوسياسية[12]“، حيث تتبدل مواقع الفاعلين تبعًا لحسابات قصيرة الأمد تُدار من مركز إدراكي واحد وهي واشنطن.
هذه البنية المرنة تُعبّر عن منطق إدارة ترامب نفسه في السياسة الخارجية منطق “الصفقة الدائمة” الذي لا يعترف بثوابت التحالف أو الخصومة، بل يتعامل مع المنطقة من منظور الربح الآني، من يمنح مكسبًا مباشرًا يُعتبر حليفًا، ومن يثقل الكفة يُترك لمصيره. وهكذا تتلاشى الحدود بين “التحالف” و”التبعية”، بين “الاستقلال” و”الاندماج”، لتنشأ طبقة جديدة من العلاقات تُدار بالتصورات والمصالح الإدراكية أكثر مما تُدار بالقوة الصلبة.
ختامًا، تكشف قراءة خطاب توم باراك أن التحولات في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ليست مجرّد تعديلات ظرفية، بل إعادة تشكيل للعقل السياسي الأمريكي ذاته. فالخطاب يعكس انتقالًا من مركزية الجغرافيا إلى مركزية الهوية والمصلحة، ومن الولاء المؤسسي إلى اقتصاد الولاء، ومن القيم الأخلاقية كمرجعية إلى توظيفها كأداة للهيمنة الرمزية. كما يجسّد الخطاب تداخل الاستشراق الأمني والبراغماتية الاقتصادية في صياغة السياسة الأمريكية، حيث تتقاطع اللغة الأخلاقية مع المنفعة السياسية لتنتج رؤية تُعيد تثبيت مركزية الولايات المتحدة في العالم عبر الإرشاد لا الاحتلال، والهيمنة الرمزية لا القهر المادي. وبذلك، يصبح خطاب باراك وثيقة تحليلية تكشف عن مرحلة جديدة في التفكير الأمريكي: مرحلة الهيمنة الناعمة المقنّعة بالإرشاد، التي تواصل مشروع الاستثنائية الأمريكية بأساليب أقل صدامًا وأكثر تعقيدًا.
[1] عماد عبد اللطيف، تحليل الخطاب السياسي: البلاغة، السلطة، المقاومة (كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، 2020) ص.20-21.
[2] ميشيل فوكو، إدارة الخطاب ونظام المعرفة، ترجمة: أحمد سلطان، وعبدالسلام بن عبدالعالي، دار النشر المغربية، المغرب، 1985.
[3] وليد عبدالحي، لغة الخطاب السياسي: المشكلة والحل، مذكرات غير منشورة، المحاضرة الخامسة عشر، جامعة اليرموك، 2013.
[4] Fairclough, Norman. Language and Power. London: Longman, 1989.
[5] Graham Wilson, Exceptionalism in a time of stress, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 32, 455-471.
[6] Ibid.
[7] Zoltan Peterecz, American Exceptionalism in American Foreign Policy. Heilde Restad, American Exceptionalism: An Idea That Made a Nation and Remade the World (London: Routledge, 2015) 99-104.
[8] مرجع سبق ذكره، وليد عبدالحي.
[9] إيمان عبد العزيز، كيف تعيد حرب غزة تشكيل هندسة التحالفات الأمنية في المنطقة العربية؟، مركز ترو للدراسات، 2025، https://truestudies.org/2820/ .
[10] Cox, Robert W. “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method.” Millennium: Journal of International Studies 12, no. 2 (June 1983). p.p. 162–175. https://doi.org/10.1177/03058298830120020701 .
[11] أسعد عبدالوهاب، فكر الهيمنة الأمريكية عند جوزيف ناي وبريجنسكي، مجلة تكريت للعلوم السياسية، ع10، 2017، ص.20-44.
[12] Lekakis, Eleftheria J. A Liquid Politics? Conceptualising the Politics of Fair Trade, Consumption and Consumer. Ephemera: Theory & Politics in Organization 12, No. 1, 2012, p.p.19–36. https://ephemerajournal.org/contribution/liquid-politics-conceptualising-politics-fair-trade-consumption-and-consumer
باحث مساعد في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب