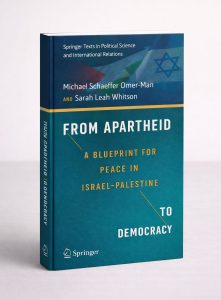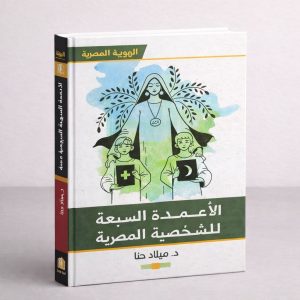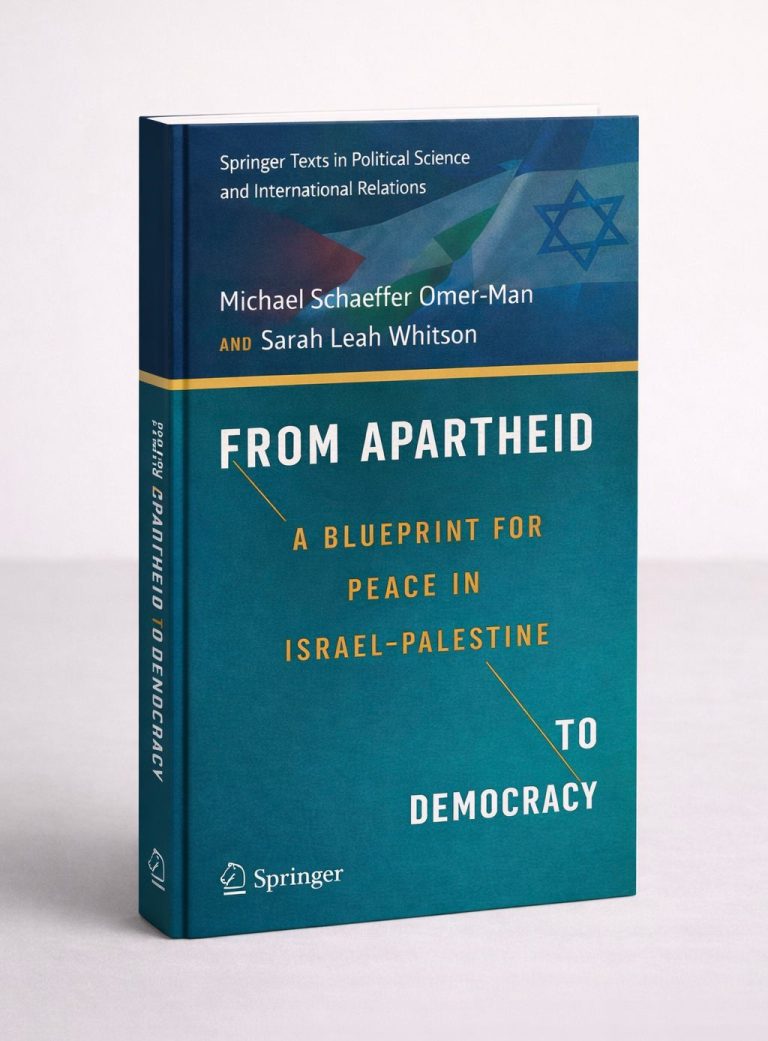يشهد الشرق الأوسط تحولات استراتيجية متسارعة تعيد تشكيل موازين القوى ونمط التحالفات، في ظل تراجع نسبي لبعض الفواعل التقليدية وصعود طموحات قوى إقليمية تسعى لإعادة رسم معالم النظام الإقليمي. وقد كشفت المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وإيران المتمثلة في ضربات إسرائيلية دقيقة استهدفت مواقع إيرانية داخل العمق الإيراني، وردود إيرانية محدودة في العمق الإسرائيلي عن تصاعد حدة التنافس على النفوذ، وفي الوقت ذاته عن تراجع قدرة طهران على فرض معادلة ردع متوازنة كما كان الحال في السنوات السابقة. وفي خلفية هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى القوى الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها تركيا وإسرائيل، باعتبارهما من أبرز اللاعبين الساعين إلى تعزيز أدوارهم القيادية في هذا السياق، إذ تتقاطع طموحاتهم عند نقطة الزعامة الإقليمية، وإن اختلفت أدواتهم وخطاباتهم ومجالات نفوذهم. [1]
لقد شكلت إيران لعقود فاعلًا مهيمنًا في معادلات الصراع الإقليمي، مستندة إلى شبكة معقدة من الوكلاء والميليشيات الممتدة من العراق وسوريا إلى لبنان واليمن. إلا أن هذا النفوذ بدأ يشهد حالة من الانكماش النسبي، بفعل الضغوط الاقتصادية والعسكرية والسياسية المتزايدة، وهو ما أعاد فتح المجال أمام قوى أخرى -ولا سيما تركيا وإسرائيل- لمحاولة ملء الفراغ وإعادة ترتيب أوراق النفوذ في المنطقة.[2]
في هذا السياق، تبرز تركيا كقوة ذات طموح أيديولوجي واستراتيجي متجدد، تحاول استعادة دورها القيادي في الشرق الأوسط من خلال أدوات القوة الناعمة والتدخلات المباشرة في الأزمات الإقليمية. في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تأمين موقعها كقوة عسكرية وتكنولوجية متفوقة، مدعومة بشبكة تحالفات جديدة تمتد من الخليج إلى شرق المتوسط.[3]
وبينما ينحسر النفوذ الإيراني، تتزايد التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين تركيا وإسرائيل: هل هي علاقة تنافس على القيادة الإقليمية وصياغة توازنات ما بعد إيران؟ أم أنها تتجه، براغماتيًا، نحو شكل من أشكال التعاون غير المعلن في هندسة شرق أوسط جديد يخدم مصالح الطرفين؟ تلك هي الإشكالية التي يسعى هذا المقال إلى تحليل أبعادها.
أولًا: خلفيات النفوذ الإيراني وملامح التمدد الإقليمي
يمثل النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إحدى السمات الأكثر تأثيرًا في تشكيل التوازنات الإقليمية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حيث سعت طهران إلى توظيف موقعها الجيوسياسي، ورمزيتها الثورية، وإمكانياتها العسكرية والاقتصادية، لبناء نموذج نفوذ يتجاوز الحدود القومية التقليدية، مستندًا إلى سرديات مذهبية ومظلومية تاريخية ورؤية استراتيجية ترى في التراجع داخل الحدود الإيرانية تقليصًا لدور الجمهورية الإسلامية كقوة إقليمية. وقد تمحورت هذه الرؤية حول فكرة “الهلال الشيعي” كإطار نفوذي يمتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت، مرورًا باليمن، مستندة إلى شبكة متداخلة من التحالفات مع الدولة المركزية أحيانًا، ومع كيانات غير رسمية في أغلب الأحيان.[4]
اعتمدت إيران على نمط من النفوذ غير التقليدي، يتمثل في دعم وتوجيه الجماعات المسلحة الموالية لها أيديولوجيًا أو المستفيدة من دعمها اللوجستي والسياسي، وفي مقدمتها “حزب الله” في لبنان، و”الحشد الشعبي” في العراق، و”الحوثيين” في اليمن، و”الجماعات المقاتلة الشيعية” في سوريا، و”حركة الجهاد الإسلامي” وفصائل أخرى في قطاع غزة. هذه الأدوات مكنتها من خوض حروب بالوكالة وتمديد نفوذها دون الانخراط المباشر في مواجهات مفتوحة مع خصومها الإقليميين أو الدوليين، وهو ما منحها قدرة على المناورة السياسية والعسكرية.[5]
في السياق ذاته، سعت طهران إلى بناء تحالفات عابرة للحدود مع أنظمة سياسية ودول مناهضة للهيمنة الغربية، مثل نظام بشار الأسد في سوريا، وأنظمة في أمريكا اللاتينية كفنزويلا، فضلاً عن توثيق علاقاتها مع روسيا والصين في إطار محور يتبنى خطابًا معاديًا للغرب. وقد منح هذا الانخراط بعدًا جيوسياسيًا أوسع للنفوذ الإيراني، تجاوز البعد المذهبي أو المحلي، ليأخذ طابعًا استراتيجيًا يستند إلى مبدأ “المقاومة” كغطاء أيديولوجي للتحركات الميدانية.[6]
وعلى المستوى الاقتصادي، ورغم العقوبات المتعددة المفروضة عليها، استفادت إيران من اقتصاد الظل والاقتصاد العسكري المرتبط بالحرس الثوري، لتغذية شبكاتها الإقليمية وتمويل عملياتها الخارجية. كما عملت على اختراق الأسواق المحلية في بعض الدول من خلال وكلاء وشركات، لا سيما في العراق وسوريا ولبنان، بما يعزز حضورها الناعم ويمنحها قدرة على الضغط غير العسكري في لحظات الصراع.[7]
لكن هذا النموذج التوسعي بدأ يواجه تحديات متصاعدة خلال العقد الأخير، نتيجة تآكل الموارد الداخلية بفعل العقوبات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط، وتراجع قدرة الدولة الإيرانية على إدارة نفوذها الخارجي بفعالية في ظل تصاعد الاستياء الشعبي الداخلي وتزايد التكلفة الاقتصادية والسياسية لمغامرات الخارج. كما أن انخراط قوى دولية وإقليمية مضادة، مثل إسرائيل وتركيا وبعض دول الخليج، في تقليص هذا النفوذ، أعاد صياغة بيئة الصراع على الزعامة الإقليمية في اتجاه أكثر ديناميكية وتعقيدًا.[8]
ثانيًا: محددات الدور التركي وعقيدة السياسة التركية
شهد الدور التركي في الشرق الأوسط تحولات جوهرية خلال العقدين الأخيرين، مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، حيث أعادت أنقرة صياغة أولوياتها الإقليمية والدولية، وانتقلت من موقع الهامش الأطلسي إلى فاعل طموح يسعى إلى قيادة إقليمية تتجاوز المحددات الجغرافية والثقافية التقليدية. لم تعد تركيا تكتفي بدورها في الناتو أو باعتبارها بوابة أوروبا نحو الشرق، بل أصبحت تسعى لبناء شبكة نفوذ قائمة على توظيف عناصر القوة الصلبة والناعمة معًا، وفق عقيدة تقوم على التوازن، والبراغماتية السياسية، والتمدد الناعم المدروس.[9]
أول محددات الدور التركي يتمثل في التحولات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة، حيث سعت تركيا إلى توسيع دائرة نفوذها في فضاءات كانت تُعد تاريخيًا ضمن المجال العثماني السابق، لا سيما في الشرق الأوسط، والبلقان، وآسيا الوسطى. وقد تزايد هذا التوجه مع تراجع النفوذ الأمريكي التقليدي، ودخول المنطقة في موجات من عدم الاستقرار بعد الغزو الأمريكي للعراق 2003، ثم الثورات العربية بدءًا من 2011، ما خلق فراغًا في السلطة الإقليمية سارعت تركيا إلى ملئه، مستندة إلى موقعها الجغرافي، وقوتها الاقتصادية، وقدرتها على المناورة السياسية.[10]
أما المحدد الثاني فيتمثل في البراغماتية التي طبعت السياسة الخارجية التركية، خاصة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي مكنت أنقرة من بناء شبكة علاقات متداخلة ومتناقضة أحيانًا مع قوى إقليمية ودولية متباينة، مثل روسيا من جهة، وحلف الناتو من جهة أخرى، أو قطر وإيران من جهة، وإسرائيل والإمارات من جهة ثانية، بحسب مقتضيات المصالح الاستراتيجية. فتركيا لم تعد تتعامل مع القضايا الإقليمية انطلاقًا من أطر أيديولوجية ثابتة، بل باتت توظف تحالفاتها وتوتراتها كأدوات ضغط ومساومة تخدم أهدافها الوطنية، الاقتصادية، والأمنية، وتدعم دورها كقوة توازن إقليمي.[11]
في المقابل، يشكل التمدد الناعم أحد أبرز ركائز العقيدة السياسية التركية في الشرق الأوسط، إذ اعتمدت أنقرة على أدوات الثقافة، والتعليم، والدين، والاقتصاد، لبناء نفوذ غير مباشر في دول عدة مثل ليبيا، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والسودان. وتمثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وجامعات التعليم الدولي، والمؤسسات الدينية، والمنح الدراسية، ووسائل الإعلام الناطقة بالعربية، أذرعًا ناعمة وظفتها أنقرة لتعزيز حضورها الإقليمي وتعميق صورتها كقوة صاعدة ذات طابع إسلامي معتدل ومتفاعل مع قضايا الشعوب. وقد سعت من خلال ذلك إلى تقديم نفسها كبديل نموذجي للنموذجين الإيراني والسعودي، خاصة بعد انكشاف كلفة الثورات المضادة في المنطقة.[12]
ويُضاف إلى ذلك البُعد العسكري-الأمني الذي أصبح عنصرًا متزايد التأثير في العقيدة التركية، من خلال بناء قواعد عسكرية في الصومال وقطر وشمال العراق، والتدخل المباشر في شمال سوريا وليبيا، فضلًا عن دعم حركات مسلحة أو قوى سياسية متحالفة معها في عدة دول. كما لعبت الصناعات الدفاعية التركية خاصة الطائرات المسيرة (Bayraktar TB2)دورًا محوريًا في توسيع مكانة تركيا كمصدر للتكنولوجيا الأمنية، ما أكسبها نفوذًا ماديًا ورمزيًا معًا.[13]
هذه المحددات الثلاثة (التوازن، البراغماتية، التمدد الناعم) تؤسس لعقيدة استراتيجية مرنة تعتمدها تركيا، وتتجلى بوضوح في كيفية إدارتها لعلاقاتها مع إسرائيل، علاقة تتسم بالتصعيد السياسي والتقارب الاقتصادي، بالاختلاف الإيديولوجي والتكامل البراغماتي، ما يطرح إشكاليات جوهرية حول موقع إسرائيل في حسابات أنقرة الجديدة، وهل ترى فيها منافسًا إقليميًا على قيادة المنطقة، أم شريكًا اضطراريًا في معادلة إعادة هيكلتها؟
ثالثًا: المصالح الإسرائيلية والعلاقة التركية الإسرائيلية (من التوتر إلى البراغماتية – من المنافسة إلى الشراكة)
مثلت إسرائيل، منذ تأسيسها، قوة إقليمية تسعى إلى ترسيخ تفوقها العسكري والسياسي في منطقة شديدة الاضطراب. وقد ظلت استراتيجيتها قائمة على مبدأ تفتيت الخصوم وتحييد التهديدات، مع توسيع شبكة التحالفات لتطويق الأعداء وتعزيز مشروعية وجودها في محيط عربي وإسلامي لا يزال يتعامل معها بحذر أو عداء. ومع تراجع أدوار بعض القوى التقليدية في المنطقة، مثل العراق وسوريا، وسقوط بعض الأنظمة المركزية بعد الربيع العربي، وجدت إسرائيل نفسها أمام فرصة لإعادة هيكلة توازنات الإقليم بما يخدم مصالحها الأمنية والجيوسياسية، لا سيما في مواجهة التهديد الإيراني.[14]
تركز المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط على ثلاث أولويات استراتيجية: أولًا، تحييد النفوذ الإيراني وأذرعه المسلحة في سوريا ولبنان وغزة، ثانيًا، منع تشكل جبهة إقليمية معادية تمتلك قدرات تكنولوجية أو عسكرية نوعية، وثالثًا، توسيع نطاق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، بما يعزز قبولها الإقليمي ويدمجها في منظومات التعاون الإقليمي، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا والأمن السيبراني. ومن هنا، تتحدد علاقتها مع تركيا ليس فقط في إطار ثنائي، بل ضمن مشهد إقليمي أكثر اتساعًا، حيث تتقاطع وتتناقض مصالح الطرفين أحيانًا، وتتقارب في أوقات أخرى.[15]
مرت العلاقة التركية-الإسرائيلية بمحطات متقلبة، تحكمها موجات من التوتر الأيديولوجي والاحتكاك السياسي، منذ مجزرة “مرمرة” عام 2010 التي شكلت نقطة ذروة في التدهور الدبلوماسي، وحتى التصريحات المتكررة من القيادة التركية الرافضة للاحتلال وممارساته في القدس وغزة. لكن رغم هذا التوتر الظاهري، ظل الخط الاقتصادي مفتوحًا بين البلدين، واستمرت العلاقات التجارية والسياحية في النمو، وهو ما يعكس ترجيح أنقرة لمعادلة الاختلاف السياسي مقابل التعاون الاقتصادي، في إطار ما يُعرف بالبراغماتية التركية.[16]
وعلى الجانب الإسرائيلي، لم تُغلق النوافذ الدبلوماسية مع أنقرة، إذ تنظر تل أبيب إلى تركيا باعتبارها فاعلًا لا يمكن تجاهله في معادلة شرق المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بملف الغاز، وأمن الملاحة البحرية، وموازين القوى في سوريا. كما أن أنقرة تمثل ثقلاً سنيًا يعادل التمدد الإيراني، وتربطها علاقات غير عدائية مع حركات الإسلام السياسي، وهي علاقات تسعى إسرائيل إلى مراقبتها عن قرب، وتوظيفها أحيانًا لكبح جماح الفصائل الفلسطينية الأكثر قربًا من طهران.[17]
في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الثنائية تقاربًا تدريجيًا، بدأ بإعادة تبادل السفراء، وتبادل رسائل التهدئة بعد زلزال تركيا 2023، مرورًا بلقاءات رسمية على مستوى رفيع بين الجانبين، وصولًا إلى تعاون محتمل في مجال تصدير الغاز التركي إلى أوروبا عبر إسرائيل. هذا التحول يعكس إدراكًا مشتركًا لدى الطرفين بأهمية الخروج من ثنائية الصراع والتقارب وفق مبدأ الشراكة المرحلية، التي لا تتطلب تطابقًا أيديولوجيًا، بل توازنًا في المصالح وضبطًا للتناقضات.[18]
إن العلاقة التركية–الإسرائيلية لم تعد تُفهم فقط من خلال منظور التحالف أو القطيعة، بل باتت تعكس نموذجًا إقليميًا جديدًا من العلاقات المعقدة، حيث تتداخل فيها ملفات الأمن، الطاقة، الاقتصاد، والموقع الجيوسياسي، ضمن مشهد إقليمي يعاد رسمه في ظل تراجع النفوذ الإيراني وظهور فراغ نسبي في الهيمنة. وفي هذا الإطار، لا تبدو تركيا منافسًا صريحًا لإسرائيل، كما لا يمكن اعتبارها شريكًا استراتيجيًا كاملًا، بل هي فاعل إقليمي يخوض مع إسرائيل لعبة معقدة من التوازنات المؤقتة والشراكات المحسوبة.[19]
وفي هذا السياق المتعدد الأبعاد، يُعد الفضاء السيبراني من المجالات الجديدة التي يتقاطع فيها الأمن القومي لكل من تركيا وإسرائيل. فمن جهة، تمثل إسرائيل إحدى الدول الرائدة عالميًا في تطوير تقنيات الأمن السيبراني، إذ تستحوذ على نحو 10% من السوق العالمية لحلول الأمن السيبراني، ويُنظر إليها باعتبارها “وادي السيليكون” الأمني في المنطقة. وقد أنشأت تل أبيب منذ العقد الماضي منظومات دفاع رقمية متقدمة لحماية منشآتها الحيوية، من شبكات الكهرباء إلى المنظومات العسكرية، وتصدر هذه التكنولوجيا إلى أكثر من 60 دولة. ومن جهة أخرى، تواجه تركيا تحديات متزايدة في هذا المجال، سواء من خلال تعرض مؤسساتها الحكومية لمحاولات اختراق، أو في ظل صراعها الداخلي مع الجماعات الكردية والتنظيمات العابرة للحدود التي تستخدم الفضاء الرقمي لأغراض التعبئة والتنسيق.[20]
وعلى الرغم من أن التعاون السيبراني بين أنقرة وتل أبيب لا يزال محدودًا وغير معلن بشكل مباشر، فإن البنية التحتية للقطاعين في كلا البلدين تُظهر إمكانات هائلة للتكامل أو التنافس. فتركيا من جانبها تسعى إلى تطوير صناعاتها السيبرانية محليًا، لكنها لا تزال تعتمد في بعض القطاعات على شراكات خارجية، ما يجعلها في موقع قابل للتفاعل مع التقنيات الإسرائيلية، خاصة في القطاعات غير العسكرية، مثل حماية البيانات المدنية، وتأمين الشبكات التجارية والمؤسسات المالية. وفي المقابل، تولي إسرائيل اهتمامًا خاصًا بمراقبة البنية الرقمية التركية، نظرًا لارتباط أنقرة ببعض حركات الإسلام السياسي، ولخشيتها من استخدام هذه الشبكات في تمويل أو تأطير أنشطة معادية لتل أبيب داخل الأراضي الفلسطينية. وهكذا، يتحول البعد السيبراني إلى مجال مزدوج في العلاقة بين الجانبين: مجال محتمل للتعاون في أوقات التهدئة، وميدان خفي للصراع في لحظات التوتر، في ظل صعوبة ضبط قواعد الاشتباك في الفضاء الرقمي.[21]
رابعًا: القضية الفلسطينية في ظل حكومة نتنياهو
تُشكل القضية الفلسطينية أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقات الإقليمية، إذ لا تقتصر أبعادها على الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني الداخلي، بل تنسحب إلى منظومة التوازنات الإقليمية والرمزية والدينية. وفي ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، دخلت القضية الفلسطينية مرحلة غير مسبوقة من الإقصاء السياسي والميداني، إذ تبنت الحكومة الإسرائيلية نهجًا تصعيديًا يميل إلى تكريس سياسة الضم الفعلي والتوسع الاستيطاني، دون أفق سياسي حقيقي للتفاوض أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.[22]
منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، التي توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، شهدت الضفة الغربية وشرق القدس تصاعدًا في سياسات تهويد الأرض، وتكثيفًا لاقتحامات المسجد الأقصى، إلى جانب تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، ما زاد من نسبة التوتر ووسع دائرة العنف. وجاء ذلك مع تراجع في دور السلطة الفلسطينية، وغياب شبه كامل لأي مبادرة سياسية جدية، في ظل تعويل حكومة نتنياهو على استمرار الانقسام الفلسطيني كعنصر يُسهم في تحييد القضية على المدى المتوسط.[23]
في هذا السياق، لا تُعد القضية الفلسطينية أولوية لدى نتنياهو إلا من زاويتين: الأمن الداخلي وتوظيفها إقليميًا. فعلى المستوى الأول، تعمل حكومته على فرض تهدئة أمنية قسرية عبر مزيج من الردع العسكري والإجراءات العقابية الجماعية، خاصة في غزة والضفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن نتنياهو يوظف القضية الفلسطينية لتبرير سياسات التطبيع مع دول عربية، عبر خطاب يقوم على الخطر الإيراني بديلًا عن مركزية فلسطين في السياسات العربية، وهو ما تجلى في الاتفاقيات الإبراهيمية، والتي سعى إلى توسيعها لاحقًا لتشمل دولًا مثل السعودية، رغم تعثر المسار مؤخرًا.[24]
تركيا بدورها، رغم مواقفها الإعلامية القوية المؤيدة للحق الفلسطيني، اتبعت في السنوات الأخيرة سياسة مزدوجة حيال القضية، تقوم على الفصل بين التصعيد السياسي وبين استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل. وقد شكل وجود نتنياهو في الحكم، وخاصة سياساته الاستفزازية في القدس وغزة، عائقًا معنويًا أمام أي شراكة استراتيجية تركية–إسرائيلية معلنة، ما يفسر استمرار العلاقات في المستوى التقني والاقتصادي دون تقدم كبير في العلاقات السياسية. كما يُدرك صناع القرار في أنقرة أن دعم القضية الفلسطينية بات جزءًا من الخطاب الرمزي لتركيا في توازنها مع العالم العربي، لكنه لا يُترجم إلى أدوات تأثير فعلي على سلوك تل أبيب، خاصة في ظل اختلال موازين القوى الدولية والإقليمية.[25]
وفي ضوء ما سبق، فإن القضية الفلسطينية في عهد نتنياهو لم تعد فقط ساحة صراع تقليدي، بل أصبحت ورقة تكتيكية في لعبة التوازنات الكبرى، سواء في الداخل الإسرائيلي، أو في العلاقات مع الدول العربية، أو حتى في العلاقات مع قوى إقليمية مثل تركيا. ويبدو أن استمرار هذه المعادلة مرهون بتغيرات جذرية، سواء في البنية السياسية داخل إسرائيل، أو في شكل الاصطفافات الإقليمية، أو في قدرة الفلسطينيين على إعادة إنتاج مشروع سياسي موحد يستعيد مركزية القضية.
خامسًا: مصالح تركيا في حالة انحسار النفوذ الإيراني
يشكل انحسار النفوذ الإيراني، سواء نتيجة الضغوط الغربية، أو التحديات الداخلية، أو التحولات في البيئة الإقليمية، فرصة استراتيجية لأنقرة لإعادة تثبيت موقعها القيادي في الإقليم، عبر توسيع هوامش التأثير وملء الفراغ الذي قد تتركه طهران، بما يخدم رؤيتها في بناء شرق أوسط متعدد الأقطاب، تكون فيه تركيا فاعلًا محوريًا لا غنى عنه. وفي هذا السياق، تتقاطع مصالح تركيا مع التراجع الإيراني في ثلاثة ملفات مركزية: الأمن الإقليمي، الطاقة، والمكانة السياسية.[26]
- الأمن الإقليمي ومؤشرات إعادة التموضع
تركيا تنظر إلى الأمن الإقليمي باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، خصوصًا في ضوء ما تعتبره تهديدات نابعة من انتشار الميليشيات المدعومة إيرانيًا في سوريا والعراق، وتنامي النفوذ الشيعي على حدودها الجنوبية. انحسار هذا النفوذ يفتح الباب أمام أنقرة لفرض نمط أمني بديل يقوم على إعادة توزيع القوى المسلحة المحلية في هذه المناطق، وفق ترتيبات تراعي مصالحها الأمنية، وعلى رأسها تحييد خطر حزب العمال الكردستاني (PKK) وأذرعه السورية.[27]
وقد بدأت ملامح هذا التموضع في شمال سوريا والعراق، حيث كثفت تركيا من عملياتها العسكرية، بالتوازي مع سعيها لرعاية توازنات محلية مع بعض العشائر والفصائل السنية، مستفيدة من تراجع الهيمنة الإيرانية في بعض المناطق الحدودية. كما أن ضعف الوجود الإيراني في العراق قد يعزز الدور التركي في ملفات المياه، والتجارة، وإعادة الإعمار، لا سيما في المحافظات ذات الغالبية السنية والتركمانية.[28]
- ملفات الطاقة والفرص الجديدة
تمثل منطقة الشرق الأوسط، وخاصة العراق وإيران، مصادر استراتيجية لإمدادات الطاقة، وقد شكلت تركيا لسنوات معبرًا رئيسيًا للنفط والغاز الإيراني إلى الأسواق الأوروبية. لكن مع فرض العقوبات الغربية المتصاعدة على طهران، وتعطل بعض خطوط التصدير، تجد تركيا نفسها أمام فرصة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، سواء من خلال نقل الغاز الأذربيجاني والعراقي، أو لعب دور الوسيط في شبكات الطاقة بين شرق المتوسط وأوروبا.[29]
كما أن تراجع النفوذ الإيراني في سوريا والعراق يمنح أنقرة مرونة أكبر لتوسيع استثماراتها في مشاريع البنية التحتية وخطوط الربط الكهربائي والأنابيب العابرة، وهو ما يعزز مكانتها الاقتصادية ويمنحها أدوات ضغط جيوسياسية جديدة. وفي هذا السياق، تندمج مصالح تركيا مع بعض مصالح إسرائيل، خاصة في حال تطوير مشاريع مشتركة لنقل غاز المتوسط عبر الأراضي التركية نحو الأسواق الأوروبية، كبديل للطرق الخطرة سياسيًا أو المكلفة اقتصاديًا.[30]
وتبرز أهمية هذه “الفرصة الجديدة” من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والطاقوية اللافتة: ففي عام 2024، سجلت تركيا تدفقًا قياسيًا في واردات الغاز الطبيعي بلغ 56.39 مليار متر مكعب، بنسبة زيادة 9.5% عن عام 2023، مما يعكس نموًّا مستقرًا في الطلب الأوروبي عبر الشبكة التركية. كما يشكل خط “تركي ستريم” (TurkStream) أحد أهم القنوات التي تربط الغاز الروسي بأوروبا، بسعة سنوية تقارب 31.5 مليار متر مكعب، وهو ما يمنح تركيا نفوذًا متصاعدًا في تحديد مسارات التوريد وأسعار السوق. أضف إلى ذلك أن مشروع “تاناب” TANAP لنقل الغاز الأذربيجاني، قد نقل حتى منتصف 2024 أكثر من 62 مليار متر مكعب نحو تركيا والأسواق الأوروبية، مما يكرس أنقرة كمحور عبور حيوي في مشهد الطاقة الإقليمي. وإذا أضيف إلى ذلك احتمال الربط الإسرائيلي–التركي في نقل غاز المتوسط، فإن تركيا تقف أمام تحول استراتيجي يجعلها محورًا بين المنتجين والمستهلكين، ويمنحها أداة ضغط ومرونة أعلى في التفاعل مع التوازنات السياسية والاقتصادية في مرحلة ما بعد انحسار إيران.[31]
- المكانة والمشروع الإقليمي
يُعد التراجع الإيراني فرصة لتفعيل المشروع التركي القائم على استعادة المكانة الإقليمية ضمن إطار العثمانية الجديدة أو التركيا الكبرى، وهي مشاريع سياسية–ثقافية تعبر عن تطلع أنقرة لقيادة توازنات المنطقة عبر خطاب إسلامي معتدل، واستثمارات اقتصادية واسعة، وتغلغل ناعم في المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في العالم العربي. وبالتالي انكماش النفوذ الإيراني يزيل حاجزًا مهمًا أمام هذا المشروع، خاصة في الدول التي كانت تدور ضمن المدار الإيراني مثل العراق، وسوريا، ولبنان، وحتى اليمن.[32]
كما أن مكانة تركيا كقوة سنية كبرى تزداد أهمية في ظل التراجع الرمزي لإيران، وهو ما يمنحها فرصة لاستقطاب القوى السنية غير الممثلة، أو الفواعل المجتمعية التي تبحث عن مرجعية سياسية غير خاضعة لنفوذ طهران. وهذا الأمر يتجلى في سعي تركيا لرعاية تيارات إسلامية ليست خاضعة لتأثير أيديولوجية شيعية، وتقديم نفسها كضامن لمعادلات التوازن الطائفي والسياسي، لا سيما في البيئات المنقسمة.[33]
وبالتالي، فإن انحسار الدور الإيراني لا يُعد مجرد تحول في موازين القوى، بل لحظة فارقة تسعى تركيا لاستثمارها بعناية، من أجل تثبيت حضورها كقوة توازن، وشريك إجباري، ومهندس محتمل لترتيبات إقليمية جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي للتحالفات وتُبنى على معادلة المصالح المتغيرة.
سادسًا: خريطة التحالفات الدولية والإقليمية-توازنات ما بعد الهيمنة التقليدية
يشهد العالم اليوم مرحلة إعادة تشكيل للتحالفات الدولية والإقليمية، تعكس تراجع ثنائية الحرب الباردة، وتآكل الأحادية القطبية الأمريكية، وتقدم مشهد معقد من الشبكات التحالفية المتقاطعة التي تتجاوز الانتماءات الإيديولوجية والاصطفافات التاريخية. وتتجلى هذه التبدلات بشكل واضح في منطقة الشرق الأوسط، حيث باتت التحالفات أكثر ديناميكية وأقل استقرارًا، مدفوعة بتغير مراكز القوة، وبروز فواعل من غير الدول، والتنافس بين القوى المتوسطة على أدوار الوكالة أو القيادة.[34]
- المحور الغربي ومحدودية الهيمنة التقليدية
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الطرف الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، من حيث القوة العسكرية، والنفوذ السياسي، والتحالفات الأمنية الممتدة، وخاصة عبر اتفاقيات دفاعية وعلاقات استراتيجية راسخة مع دول الخليج، وإسرائيل، وتركيا (العضو في الناتو). إلا أن الهيمنة الأمريكية لم تعد مطلقة كما في السابق، بل تواجه تحديات ناتجة عن الانسحاب التدريجي من بعض الملفات الإقليمية (كما في العراق وأفغانستان)، وعن التوترات الداخلية الأمريكية، والتوجه نحو إعادة التركيز على شرق آسيا في مواجهة الصين.[35]
في هذا السياق، تتجه واشنطن نحو إدارة المنطقة عبر شبكات من التحالفات الذكية أو المرنة، مثل منتدى النقب الذي يضم إسرائيل، والإمارات، والبحرين، والمغرب، ومصر، أو التحالفات الأمنية-التكنولوجية التي تسعى لدمج إسرائيل في منظومة الدفاع الإقليمي الخليجي ضد التهديدات الإيرانية. كما تعمل واشنطن على إعادة تأهيل علاقتها مع تركيا رغم التوترات المتكررة، إدراكًا لموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى روسيا وآسيا الوسطى.[36]
- التحالفات الآسيوية ومحور الشرق
في المقابل، تنامى الحضور الروسي–الصيني في المنطقة، عبر تحالفات مرنة تقوم على المصالح الاقتصادية، والدعم السياسي في المؤسسات الدولية، والتقارب مع الأنظمة المناهضة للغرب. وتشكل إيران مركز الثقل في هذا المحور، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع موسكو وبكين، خصوصًا بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع الصين لمدة 25 عامًا، والدعم الروسي لها في الملفات النووية والسورية.[37]
وقد تعزز هذا المحور مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران، مما ولد بيئة مناسبة للتعاون الاقتصادي والعسكري خارج إطار المنظومة الغربية. وتبدي كل من روسيا والصين استعدادًا لتقديم دعم تقني ودبلوماسي لأنظمة تواجه العزلة الغربية، مما يعمق من تقسيم العالم إلى جبهات استراتيجية متقابلة، وإن لم تكن متصارعة بشكل مباشر.[38]
- شبكة التحالفات الإقليمية الجديدة
على المستوى الإقليمي، برزت خلال العقد الأخير أنماط جديدة من التحالفات لا تقوم بالضرورة على الانتماء الطائفي أو الإيديولوجي، بل على تقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية، كما هو الحال في التحالف الثلاثي غير المعلن بين إسرائيل، واليونان، وقبرص حول غاز شرق المتوسط، أو في المحور الاقتصادي بين تركيا وقطر، أو التقارب بين إسرائيل وبعض دول الخليج تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية.[39]
في هذا السياق، تتحرك تركيا في فضاء خاص، حيث تقيم علاقات متنوعة مع قوى متناقضة، مثل التنسيق الأمني مع روسيا في سوريا، والمنافسة مع إيران على النفوذ في العراق، والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل رغم الخلاف السياسي. ويعكس هذا التعدد ميل أنقرة نحو ما يمكن تسميته بالتحالفات المتوازنة، التي لا تختلف مع طرف بشكل كامل، ولا تندمج كليًا في محور معين، بل توازن بين الجميع لتحقيق أكبر قدر من الاستقلال الاستراتيجي.[40]
بالمقابل، إيران خسرت جزءًا من تحالفاتها التقليدية بفعل أزماتها الداخلية والتنافس على الزعامة الإقليمية، وبدأت تواجه تراجعًا في التأثير على شركائها في العراق وسوريا ولبنان. كما أن بعض فصائل المقاومة بدأت تتجه إلى أنماط من الاستقلال النسبي، ما يحد من قدرتها على تشكيل محور إقليمي موحد تحت القيادة الإيرانية، على عكس ما كان قائمًا في العقدين الماضيين.[41]
- التحالفات الهجينة وتحولات المصالح
الملاحظ في خريطة التحالفات الراهنة هو بروز نمط من التحالفات الهجينة، التي تجمع بين التعاون والصراع في آن واحد، كما في العلاقة بين تركيا وإسرائيل، أو بين تركيا وروسيا، أو حتى بين مصر وقطر. وتستند هذه التحالفات إلى حسابات دقيقة تتعلق بالمصالح المشتركة في الطاقة، والاستثمارات، والأمن الإقليمي، دون التزامات أيديولوجية أو أمنية تقليدية.[42]
وهذا ما يعكس تحول المنطقة إلى بيئة سياسية مفتوحة على ترتيبات متغيرة، حيث لم يعد التحالف يُبنى على القرب العقائدي أو السياسي فقط، بل على مدى القدرة على تحقيق مكاسب متبادلة. ويشير ذلك إلى نهاية عصر المحاور الصلبة وصعود نمط التحالفات المتغيرة حسب السياق، حيث تلتقي مصالح تركيا مع روسيا في سوريا رغم التناقض حول نظام الأسد، أو تتقاطع مصالح إسرائيل مع الإمارات وتركيا في تصدير الغاز رغم الخلافات التاريخية.
سابعًا: الأدوات الإقليمية بين تركيا وإسرائيل
رغم اشتراك كل من تركيا وإسرائيل في الطموح نحو لعب أدوار قيادية في النظام الإقليمي الشرق أوسطي، إلا أن أدوات كل طرف في تحقيق أهدافه ومصالحه تختلف من حيث الشكل والمضمون، وتعكس تباينًا في العقيدة السياسية والموقع الجغرافي والانتماء الثقافي.
بالنسبة لتركيا، فإن أدواتها الإقليمية تعتمد بدرجة كبيرة على مزيج من القوة الناعمة والتدخل العسكري الانتقائي والتحالفات البراغماتية. فهي تستثمر في شبكات إعلامية، ومنظمات إنسانية، وأذرع تعليمية ودينية، مثل “وقف المعارف” و”الهلال الأحمر التركي”، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الاقتصادية داخل عدد من الدول العربية والإسلامية، لا سيما في شمال إفريقيا والبلقان. كما توظف تركيا وجودها العسكري المباشر في سوريا والعراق، وقواعدها في قطر والصومال وليبيا، كأداة ضغط ونفوذ، تمنحها موقعًا متقدمًا في ملفات أمن الحدود والطاقة ومكافحة الإرهاب. ويهدف هذا النمط من الأدوات إلى توسيع النفوذ التركي دون الاصطدام المباشر مع القوى الكبرى، مع الحفاظ على مرونة كافية لإعادة التموضع عند الضرورة.[43]
في المقابل، تعتمد إسرائيل بشكل أكبر على أدوات التفوق العسكري، والقدرة التكنولوجية، والتحالفات الأمنية والاستخباراتية، خاصة مع دول الخليج والولايات المتحدة. فقد بنت عقيدتها الإقليمية على الردع العسكري والتفوق النوعي في مجال الطائرات المسيرة، وأجهزة المراقبة، والدفاعات الجوية (مثل القبة الحديدية)، إضافة إلى تفوقها في قطاعات الأمن السيبراني والطاقة. وتعمل تل أبيب من خلال هذه الأدوات على تحييد التهديدات الوجودية (مثل إيران وحلفائها)، وتأمين حدودها، وتعزيز اندماجها في المنطقة من خلال اتفاقات تطبيع مدعومة بتعاون أمني وتكنولوجي متطور. كما توظف إسرائيل أدواتها السياسية والاستخباراتية للضغط على الأطراف الإقليمية، واختراق المجتمعات والدول عبر شبكات ناعمة ولكنها عالية التقنية.[44]
تُوظف هذه الأدوات لخدمة مصالح استراتيجية مختلفة: فتركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في المناطق السُنية، وضمان أمنها القومي من التهديدات الكردية، وكسب موطئ قدم دائم في معادلة شرق المتوسط وملف الطاقة. وهي تعتمد على أدوات مرنة تسمح لها بالمناورة، دون التورط في صراعات وجودية. أما إسرائيل، فتركز على الأمن الوجودي، ومنع تشكل أي محور معادي متماسك، وتثبيت نفسها كشريك لا غنى عنه في أمن الخليج وشرق المتوسط. لذلك، تميل إلى أدوات أكثر صلابة وأقل مرونة، لكنها فعالة في إحداث الردع السريع.[45]
وفي حين تميل تركيا إلى إدارة صراعاتها الإقليمية بأسلوب تدريجي وتراكمي، تعتمد إسرائيل على الضربات الاستباقية والحسم العملياتي. هذا التباين في الأدوات يعكس اختلافًا في الإدراك الاستراتيجي لدى كل من الطرفين، لكنه لا يمنع – بل أحيانًا يفرض – التقاء مصالح ظرفي، كما في ملفات الطاقة، والتوازن مع إيران، واستقرار المتوسط. فالاختلاف في الأدوات لا يلغي إمكانية الشراكة المؤقتة، بل قد يكون محفزًا على صياغة نمط تعاوني تقني مرحلي، يقوم على تبادل المنافع دون تقارب سياسي شامل.[46]
ثامنًا: السيناريوهات المحتملة
مع انكماش الدور الإيراني في الإقليم نسبيًا، برزت تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين تركيا وإسرائيل، باعتبارهما فاعلين رئيسيين يسعيان إلى صياغة أطر جديدة للنظام الإقليمي. وتُعد العلاقة بين الطرفين معقدة وغير نمطية، حيث تتقاطع فيها المصالح والتوترات، وتتبدل وفق السياقات المحلية والدولية. وفي ضوء المعطيات الراهنة، يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار هذه العلاقة: شراكة جيوسياسية مرنة، عودة إيرانية تعيد التوازن، أو منافسة إقليمية صريحة دون شراكة.
- سيناريو شراكة جيوسياسية مرنة
يقوم هذا السيناريو على فرضية أن تركيا وإسرائيل ستسعيان، براغماتيًا، إلى بناء نمط من الشراكة المرنة التي لا تتطلب تحالفًا استراتيجيًا عميقًا، لكنها تتيح لهما التعاون في ملفات محددة ذات مصالح متقاطعة، مثل الطاقة، وأمن الملاحة، والتكنولوجيا، والتجارة. وقد ظهرت ملامح هذا السيناريو خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل تبادل السفراء، والتصريحات الإيجابية المتبادلة، والانفتاح على مشاريع مشتركة في مجال تصدير غاز شرق المتوسط.
تركيا، في هذا السياق، تدرك أن انكماش الدور الإيراني يفتح المجال أمام إسرائيل لتوسيع نفوذها، لكنها لا تسعى بالضرورة إلى عرقلة ذلك، بل إلى ضبطه بما لا يهدد طموحاتها في الإقليم. ومن هذا المنطلق، قد تقبل أنقرة بتقاسم النفوذ في بعض المساحات الجغرافية، مقابل شراكات اقتصادية تتيح لها تعزيز دورها كممر إقليمي للطاقة ومركز للنقل واللوجستيات.
من جانبها، ترى إسرائيل أن تركيا تظل قوة لا يمكن تجاهلها في أي ترتيبات تخص سوريا والعراق وشرق المتوسط، وبالتالي فإن التنسيق معها ولو بشكل محدود يصب في مصلحة الأمن الإقليمي. هذا السيناريو يُحتمل في ظل غياب تصعيد سياسي جديد، وتوفر إرادة لدى الطرفين لتجاوز الاعتبارات الأيديولوجية، وهو ما يتسق مع اتجاهات العلاقات الدولية الحديثة القائمة على الشراكات المرنة عوضًا عن التحالفات الصلبة.
- سيناريو احتمالية عودة إيرانية لإعادة التوازن
في هذا السيناريو، تعود إيران إلى الساحة الإقليمية كلاعب فعال، إما نتيجة رفع أو تخفيف العقوبات الغربية، أو نجاحها في تجاوز أزماتها الداخلية، أو نتيجة تحولات دولية تُفضي إلى تفاهمات مع واشنطن أو بكين. وفي حال تحققت هذه العودة، فإن المنطقة قد تشهد إعادة بناء للمحاور القديمة، يتعزز فيها محور المقاومة، وتستعيد طهران قدرتها على توجيه أذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
عودة النفوذ الإيراني بهذا الشكل من شأنها أن تدفع تركيا وإسرائيل إلى إعادة تقييم حساباتهما. فقد تجد تركيا نفسها في موقع وسط بين طموحها في قيادة المنطقة وتحدي التمدد الشيعي في جوارها الجغرافي المباشر، ما قد يدفعها إلى تعزيز تعاونها غير المعلن في بعض الأحيان مع قوى مناهضة لإيران، بما فيها إسرائيل.
في المقابل، فإن إسرائيل ستعتبر عودة إيران تهديدًا وجوديًا متجددًا، خصوصًا في ظل استمرار برنامجها النووي ونفوذها على الفصائل المسلحة. لذا، فإن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تقارب تركي-إسرائيلي في بعض الملفات الأمنية، لكنه في الوقت ذاته قد يعرقل فرص الشراكة المستقرة بسبب اختلاف أولويات الطرفين في التعامل مع إيران، فبينما تميل إسرائيل إلى الردع الشامل، تسعى تركيا عادة إلى التوازن والاحتواء.
بالتالي، فإن عودة إيران قد لا تؤدي إلى شراكة كاملة بين أنقرة وتل أبيب، لكنها قد تُنتج نمطًا من التفاهم المرحلي، في ظل شعور مشترك بالحاجة إلى كبح جماح التمدد الإيراني دون الدخول في محور صدامي صريح.
- سيناريو منافسة لا شراكة
يفترض هذا السيناريو أن تركيا وإسرائيل ستتجهان إلى نمط من المنافسة الإقليمية المباشرة أو غير المباشرة، في ظل تصاعد الطموحات المتعارضة، وغياب تهديد مشترك كافي لتوحيد الجهود. ويفترض هذا المسار أن كليهما يرى نفسه الأحق بقيادة الإقليم أو توجيه توازناته، سواء عبر التحالفات، أو الأدوات الاقتصادية، أو النفوذ العسكري–الأمني.
تركيا، في هذا السياق، قد ترى في توسع التطبيع العربي–الإسرائيلي تهديدًا لمكانتها في العالم الإسلامي، وتتعامل مع محاولات إسرائيل لبناء منظومة أمنية في الخليج وشرق المتوسط على أنها تحجيم لدورها التاريخي. كما أن التنافس في مجالات الدفاع، والطاقة، والتكنولوجيا قد يحول العلاقة إلى فكرة أن أي مكسب لإسرائيل يُعد خسارة لتركيا، والعكس صحيح.
من جانبها، قد تنظر إسرائيل إلى المشروع التركي في المنطقة بوصفه تغليفًا معتدلًا لطموح إسلامي يناقض رؤيتها لدور الدولة القومية الحديثة في الإقليم. كما أن الدعم التركي لبعض الفصائل الفلسطينية، والعلاقة مع حركات الإسلام السياسي، يثيران مخاوف إسرائيل من توظيف تركيا لهذا النفوذ في إضعاف مكانتها الاستراتيجية.
هذا السيناريو يُحتمل في حال غياب بيئة دولية داعمة للشراكة، وتصاعد الأزمات الثنائية، أو حدوث تحولات حادة، مثل تغيرات في القيادة السياسية لأي من الدولتين أو اشتعال صراعات حدودية في شرق المتوسط أو سوريا. وهو سيناريو لا يعني بالضرورة صدامًا عسكريًا، بل منافسة ناعمة–صلبة تُدار عبر أدوات متعددة، من الإعلام، إلى الاقتصاد، إلى التوازنات العسكرية بالوكالة.
تشير هذه السيناريوهات الثلاثة إلى أن مستقبل العلاقة بين تركيا وإسرائيل سيتوقف بدرجة كبيرة على المتغيرات الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها موقع إيران في المعادلة. ومع انحسار النفوذ الإيراني، تظل الفرصة قائمة لشراكة تركية-إسرائيلية مرنة تقوم على المصالح لا القيم. لكن في حال استعادة إيران لدورها، أو تصاعد التناقضات بين الطموحين التركي والإسرائيلي، فإن المنطقة قد تتجه إما إلى سباق نفوذ جديد، أو إلى تحالفات مضادة تعيد تقسيم أدوار القيادة في الإقليم.
ختامًا، إن العلاقة بين تركيا وإسرائيل لا تزال تتسم بطابع مزدوج يجمع بين التعاون البراغماتي والتنافس الإقليمي المكتوم، مما يجعل من الصعب توصيفها في إطار شراكة استراتيجية مستقرة. فبينما تتقاطع مصالح الطرفين في بعض الملفات، مثل الطاقة والتوازن مع إيران، فإنهما لا يزالان على طرفي نقيض في قضايا أخرى، أبرزها القضية الفلسطينية، ومواقفهما من بعض الفاعلين الإقليميين. ومن ثم، فإن أي تقارب بين الطرفين يظل مشروطًا بمتغيرات إقليمية ودولية تتجاوز إرادتهما المباشرة.
يُعد مصير النفوذ الإيراني في الإقليم أحد أبرز المحددات التي تؤثر في طبيعة العلاقة التركية–الإسرائيلية. فتراجع الحضور الإيراني، سواء نتيجة الضغوط الغربية أو التغيرات الداخلية في طهران، يفتح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، وهو ما يمكن أن يدفع نحو صيغة من التنسيق بين أنقرة وتل أبيب. غير أن هذا التراجع لا يزال هشًا ومذبذبًا، حيث أظهرت إيران قدرتها على المناورة واستعادة بعض أوراقها الإقليمية رغم العقوبات والعزلة. لذلك، فإن التنافس بين تركيا وإسرائيل على ملء فراغ النفوذ الإيراني قد يكون أكثر حضورًا من فكرة تقاسم هذا الفراغ في إطار شراكة استراتيجية دائمة.
أما المتغير الأمريكي، فإنه يظل عنصرًا حاسمًا في ضبط إيقاع العلاقة بين الطرفين. فالإدارات الأمريكية المتعاقبة أثرت بشكل واضح على كيفية تموضع كل من تركيا وإسرائيل داخل النظام الإقليمي، سواء من خلال الدعم السياسي والعسكري، أو من خلال توجيه مسارات التحالفات. في حال تبنت واشنطن مقاربة تشجع على تقارب إقليمي واسع في مواجهة إيران أو روسيا، فقد تفتح المجال أمام تقاطع مصالح تركي–إسرائيلي أوسع. أما إذا ساد اتجاه انعزالي أو تقليص للوجود الأمريكي، فإن الطرفين سيتصرفان كقوتين مستقلتين، لكل منهما أجندته الخاصة، وهو ما قد يؤدي إلى تباعد أكبر في الأولويات.
في السياق ذاته، تلعب دول الخليج دورًا متزايدًا في تشكيل البيئة الإقليمية، سواء عبر تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو عبر الانفتاح الاقتصادي والأمني على تركيا. وتُدرك أنقرة وتل أبيب أن الخليج لم يعد ساحة محايدة، بل أصبح شريكًا نشطًا في موازين القوى، وقد يتجه إلى بناء اصطفافات جديدة تعيد تعريف أدوار الطرفين. وفي حال استمر الخليج في تعزيز علاقاته مع إسرائيل دون استبعاد تركيا، فقد نشهد ترتيبات جديدة تقوم على إدارة التنافس لا القطبية الثنائية، بينما سيتراجع احتمال أي تحالف إقليمي متماسك يضم الطرفين تحت سقف واحد.
في ضوء كل ما سبق، يصعب الحديث عن شراكة استراتيجية تركية–إسرائيلية بمعناها التقليدي. فرغم ما يشهده المشهد من تقارب ظرفي، وتنسيق تقني في بعض المجالات، فإن العلاقة تظل محكومة بمنطق التوازنات المؤقتة والمصالح المتغيرة. وما لم يحدث تحول جذري في بنية النظام الإقليمي، أو تغير حاسم في مواقف الفاعلين الدوليين، فإن هذه العلاقة ستظل أقرب إلى “تحالف الضرورة” منها إلى “شراكة الاستقرار”، تبنى وتتفكك حسب اتجاه الأوضاع الجيوسياسية، لا وفق منطق الثوابت الاستراتيجية.
المصادر
[1] Salim Çevik, Turkey’s Repositioning in the Middle East’s Emerging Order, 17 June 2025, Arab center Washington DC.
https://arabcenterdc.org/resource/turkeys-repositioning-in-the-middle-easts-emerging-order
[2] Iranian drones launched towards Israeli targets as US reportedly moves B-2 bombers to Guam – as it happened, 23 June 2025, The Guardian.
[3] Cengiz Çandar, Turkey’s “Soft Power” Strategy: A New Vision for a Multi-Polar World, Policy Brief.
https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/110009/25/788659995.pdf?utm
[4] مسفر بن صالح الغامدي، النفوذ الإيراني في حوض البحر الأحمر أهداف ومعوقات البقاء في إقليم حيوي، نُشر في ديسمبر 2017، مجلة الدراسات الإيرانية.
[5] أحمد جلال محمود، سياسات إيران الإقليمية في المنطقة العربية وتأثيرها على أمن الشرق الأوسط، نُشر في نوفمبر 2020، مجلة بحوث الشرق الأوسط.
https://mercj.journals.ekb.eg/article_122376.html
[6] د/عبدالله عيسى الشريف، سياسات واشنطن في الشرق الأوسط وتمدد النفوذ الإيراني، نُشر في 27 أكتوبر 2021، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الوزراء.
https://www.idsc.gov.eg/Article/details/6260
[7] النفوذ الإيراني في شرقي إفريقيا.. الأدوات والاستراتيجيات، نُشر في مارس 2020، النتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية.
[8] مستقبل النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط في ظل العقوبات الأمريكية، نُشر في مايو 2019، رؤية تركية، دورية محكمة في الشؤون التركية والدولية.
[9]حسن عبدالحمزة حمودي، العقيدة السياسية لصانع القرار التركي وأثرها في المؤسسة العسكرية بعد عام 2002، نُشر في 2020، معهد العلمين للدراسات العليا بجمهورية العراق.
https://alalamain.edu.iq/storage/1742774822_DeWslxcAMlYkEeTV.pdf
[10] د/ عزة بنت عبدالرحيم، المحددات الداخلية والخارجية للسياسة التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط من 2005 إلى 2015، نُشر في 2019، كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة طيبة بالمدينة المنورة.
https://ehjc.journals.ekb.eg/article_89605_5ac7b3bd388ff59d596a9d6caf527e4e.pdf
[11] إعداد بلندي لامي، ترجمة أسماء عبده، السياسة الخارجية التركية في عصر حزب العدالة والتنمية: ما بعد داود أوغلو، أركان للدراسات والأبحاث والنشر.
https://arkansrp.com/studies/turkish-foreign-policy-during-akp.pdf
[12] غدير حسين، التفاعلات المتبادلة بين السياسة الخارجية التركية والسياسة الخارجية السعودية 2002-2016 (دراسة مقارنة)، نُشر في 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجامعة اللبنانية.
http://dspa.ul.edu.lb/static/uploads/files/master-thesis/2017/m-0007-2017.pdf
[13] داليا رشدي عرفات، التوجه التركي للهيمنة الإقليمية والنهوض الدولي: رؤية تحليلية، نُشر في يوليو 2022، مجلة كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف.
https://jocu.journals.ekb.eg/article_248877_96ed0e074aea98fc1f8c5b9405dd632e.pdf
[14]نهاد أبو غوش، العلاقات التركية- الإسرائيلية: مصالح عميقة وتوتّر فوق السطح، نُشر في 4 يناير 2021، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.
[15] إسلام المنسي، سيناريوهات محتملة:إلى أين يتجه التنافس التركي الإسرائيلي على سوريا؟، نُشر في 22 أبريل 2025، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
[16] Understanding Turkey’s response to the Israel-Gaza crisis, 7 December 2023, BROOKINGS.
[17]نزار عبدالقادر، العلاقات التركية – الإسرائيلية: بين التحالف الاستراتيجي والقطيعة تركيا تتوسع شرقًا على حساب إسرائيل والغرب، نُشر في 2010، مجلة الدفاع الوطني اللبناني.
[18] ما تأثير التنافس التركي – الإسرائيلي على العملية الانتقالية ومستقبل سوريا؟، نُشر في 12 أبريل 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[19] دكتور أحمد جلال محمود، سياسات إيران الإقليمية في المنطقة العربية وتأثيرها على أمن الشرق الأوسط، نُشر في 2018، كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس.
https://mercj.journals.ekb.eg/article_122376_b2eb87b80f1d167a951205c8076addf4.pdf
[20] العلاقات التركية الإسرائيلية.. محطات من المد والجزر، نُشر في 14 أبريل 2025، الجزيرة نت.
[21] هل تتحول “الحرب الكلامية” بين إسرائيل وتركيا إلى حرب حقيقية؟، نُشر في 10 أبريل 2025.
[22] عزمي بشارة، صفقة ترامب نتنياهو، نُشر في 2020، المركز العربي للأبحاث والدراسات.
[23] سعيد أبو علي، الخلفيات الفكرية والآفاق المستقبلية لخطة تهجير غزة الترامبية “دراسة مُحكمة”، نُشر في أبريل 2025، جامعة القدس.
https://dspace.alquds.edu/items/8eb7e35e-8a41-4dd1-bc5d-30cea07dc920
[24] عزمي بشارة، طوفان الحرب على فلسطين في غزة، نُشر في 2024، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
[25] الخيارات والتوجهات الفلسطينية لمواجهة حكومة نتنياهو، نُشر في 9 مارس 2023، مركز رؤية للتنمية السياسية.
[26] لماذا يتواصل توتر العلاقات التركية الإسرائيلية قبل حرب غزة وبعدها؟، نُشر في يناير 2024.
[27] محمد غنيم، آثر العلاقات التركية الإيرانية على الأمن القومي العربي، نُشر في أكتوبر 2022، مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية جامعة السويس.
https://psej.journals.ekb.eg/article_269883_bbc56fc1a08082a69bb33963f9b79baf.pdf
[28] غدى حسن قنديل، التنافس التركي الإيراني في آسيا الوسطى، نُشر في أبريل 2022، مجلة الدراسات الإيرانية.
[29] حيدر عبدالجبار، التنافس السياسي والاقتصادي التركي-الإيراني وانعكاساته الإقليمية، نُشر في 2015، كلية العلوم السياسية والعلاقات الاقتصادية الدولية جامعة النهرين بالعراق.
https://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_1_38.pdf
[30] د/ محمد عز العرب، تعزيز النفوذ.. كيف توظف تركيا التحولات الجيوسياسية بعد سقوط الأسد؟، نُشر في 1 يونيو 2025، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/News/21437.aspx
[31] Russian pipeline gas exports to Europe down 18% m/m in June, data shows, 2 July 2025, Reuters.
[32] حكومة نتنياهو تشكل خطرًا على اليهود في كل مكان، نُشر في 12 يونيو 2025، نيويورك تايمز.
https://new.idscapp.gov.eg/share/news/details/82535
[33] كرم سعيد، تركيا وإيران حدود التوتر، نُشر في 24 فبراير 2021، مجلة السياسة الدولية.
https://www.siyassa.org.eg/News/18032.aspx
[34] ماري ماهر، مواجهة محسوبة: لماذا تصاعدت التوترات بين تركيا وإيران؟، نُشر في 23 مارس 2025، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
[35] تحولات الشرق الأوسط: صراع النفوذ والبرنامج النووي الإيراني، نُشر في 18 يناير 2025، وكالة أنباء حضرموت.
https://wah.news/post/amp/93323
[36] هل تعيد مسارات الحرب الإيرانية الاسرائيلية تشكيل خريطة الشرق الأوسط؟، نُشر في 17 يونيو 2025، وكالة شهاب الإخبارية.
[37] تراجع مكانة إسرائيل الإقليمية.. إنجازات عسكرية بلا عمق إستراتيجي، نُشر في 12 مايو 2025، الجزيرة نت.
[38] د/ عبدالرؤوف مصطفى، انعكاسات التحولات الدولية الراهنة على التنافس التركي-الإيراني في الشرق الأوسط، نُشر في 5 يوليو 2022، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.
[39] حرب الظلال: من يُمسك بخيوط الشرق الأوسط؟، نُشر في 25 يونيو 2025.
[40] د/ عبدالرؤوف الغنيمي، مُستَقبل المشروع الجيوسياسي الإيراني على ضوء التطوُّرات الإستراتيجية الإقليمية، نُشر في 29 يناير 2025، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.
[41] إعادة التفكير في السلوك الإيراني ودوره الإقليمي، نُشر في 16 أبريل 2025، الشرق نيوز.
[42]د/ خالد العزي، التحالفات الاقتصادية الجديدة بظل القطبية الناشئة: ملامح عصر جيو – اقتصادي جديد، نُشر في 6 يونيو 2025، جريدة الحرة بيروت.
[43] “تركيا وإسرائيل تخاطران بالانزلاق نحو المواجهة” – فايننشال تايمز، نُشر في 4 يوليو 2025، بي بي سي عربية.
https://www.bbc.com/arabic/articles/c0rv0025978o
[44] زيد اسليم، حرب غزة غيّرت معادلة التجارة بين تركيا وإسرائيل، نُشر في 27 مارس 2025، الجزيرة نت.
[45] التنسيق والتنافس بين تركيا وإسرائيل على الثروات والمياه في سوريا، نُشر في 3 يوليو 2025، موسوعة الاقتصاد.
[46] تدهور التجارة بين تركيا وإسرائيل.. ما هي الخسائر والبدائل؟، نُشرفي 27 مايو 2024، CNBC عربية.
باحث في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب