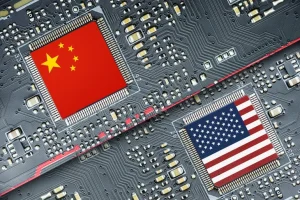تمثل منطقة غرب إفريقيا واحدة من أكثر الساحات الجيوسياسية تعقيدًا وتغيرًا في القارة الإفريقية، وذلك بفعل ما تشهده من ديناميات متسارعة في هيكلها السياسي، وتغيرات واضحة في خريطة النفوذ الإقليمي والدولي. فبين موجات الانقلابات العسكرية، وصعود أنظمة حكم جديدة تسعى إلى الابتعاد عن النفوذ الفرنسي والتقليدي، وتزايد السخط الشعبي من النخب التقليدية، برزت هذه المنطقة بوصفها نقطة صراع مستحدث بين قوى دولية وإقليمية، تسعى كل منها لإعادة تحديد مصالحها وأدوارها في فضاء استراتيجي متحول[1].
لقد أدى هذا التحرك المتصاعد إلى تغيير هيكلة الدولة في دول مثل مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، حيث تضائل التأثير الفرنسي المتعارف عليه لمصلحة قوى بديلة كروسيا، التي تدخلت عن طريق قنوات أمنية غير رسمية مثل مجموعة فاغنر، مستغلة الفراغ السياسي وأجواء عدم الشرعية التي اتسمت بها علاقات السلطة في تلك الدول. وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز موقعهما سواء من خلال الوجود العسكري (كما في النيجر)، أو عبر استراتيجيات التأثير الاقتصادي والاستثمار على المدى الطويل (كما تفعل الصين عبر مبادرة الحزام والطريق)[2].
تثير هذه التحولات تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الاستقرار السياسي في غرب إفريقيا، ونطاق قدرة الأنظمة الجديدة على تأسيس شرعية وطنية مستقلة ذات سيادة، في ظل استمرار التبعية البنيوية للخارج، وتصاعد التنافس بين الفاعلين الدوليين على الموارد الاستراتيجية ومواقع النفوذ، كذلك تفرض هذه الديناميات تساؤلات أعمق حول مصير التكامل الإقليمي ومؤسسات الحكم المشترك مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، التي تواجه تحديات وجودية بفعل النزاعات المتصاعدة بين الدول الأعضاء، والقرارات الفردية بالانسحاب أو تعليق العضوية[3].
بناءً على ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أبعاد التنافس الدولي والإقليمي على المنطقة وتأثيره على طبيعة التحولات والتغيرات السياسية الجارية في غرب إفريقيا، من خلال تتبع أنماط التحول في أنظمة الحكم. كما تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مضمونها أن التنافس الدولي في ظل أن الدول نفسها هشة وضعيفة سياسيًا، وبالتالي ذلك يعيق نشوء نموذج استقرار داخلي قادر على تجاوز البُنى الاستعمارية القديمة.
السياق التاريخي والسياسي لغرب أفريقيا: من الإرث الاستعماري إلى ديناميات التحول
شكل الإرث الاستعماري في غرب إفريقيا الأساس التاريخي لضعف الدولة الوطنية المعاصرة، حيث أُسست الكيانات السياسية على أسس خارجية لم تحترم التنوع الإثني والثقافي[4]، وتوارثت نخب ما بعد الاستقلال بنى بيروقراطية نخبوية مرتبطة بالمستعمر أكثر من ارتباطها بالمجتمع المحلي، وقد أسهم هذا الإرث في إنتاج نمط من (الدولة النيوباتريمونيالية)، وهي نظام هرمي اجتماعي يستخدم فيه الرعاة موارد الدولة لضمان ولاء رعاتهم من عامة السكان. وهي علاقة غير رسمية بين الرعاة والتابعين تمتد من أعلى مستويات الدولة وصولًا إلى أفراد القرى الصغيرة، كما أنها تقوض المؤسسات السياسية وسيادة القانون وأنها ممارسة فاسدة. وبالتالي تقوم على شخصنة السلطة وتوزيع المنافع وفق الولاءات لا الكفاءة، مما أضعف مؤسسات الحكم وأدى إلى استدامة الهشاشة السياسية والاجتماعية[5]. ومع فشل مشاريع التنمية الوطنية في العقود الأولى للاستقلال، أصبح الجيش فاعلًا سياسيًا محوريًا، لا سيما خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين استخدم خطاب مكافحة الفساد والتبعية لتبرير الانقلابات العسكرية[6].
رغم موجة التحول الديمقراطي التي اجتاحت المنطقة في التسعينيات، إلا أن التعددية السياسية ظلت سطحية، حيث حافظت النخب التقليدية على سلطتها من خلال الشبكات الزبائنية[7]، بينما أُفرغت المؤسسات من دورها التمثيلي الفعلي. وزادت الانقسامات الإثنية من تعقيد المشهد السياسي، إذ لم تنجح معظم الدول في تجاوز الولاءات الأولية نحو مشروع وطني جامع، مما جعل الهوية الإثنية أداة للصراع السياسي بدل أن تكون عنصرًا للتنوع البناء. هذا الواقع البنيوي، المقترن بضعف سيادة القانون وانتشار الفساد، جعل الدولة في غرب إفريقيا عاجزة عن احتكار العنف أو بسط نفوذها على الأطراف الحدودية، الأمر الذي عزز دور الجماعات المسلحة والفاعلين الخارجيين في ملء الفراغ، وكرس بالتالي حالة مستمرة من عدم الاستقرار البنيوي[8].
أولًا: التنافس الدولي والإقليمي في غرب إفريقيا-صراع النفوذ وإعادة تشكيل المجال الجيوسياسي
أصبحت منطقة غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة مسرحًا متقدمًا للتنافس بين القوى الكبرى والإقليمية، حيث تتفاعل تحولات النظام الدولي مع هشاشة الدولة الوطنية لتعيد صياغة تموضعات استراتيجية جديدة، فغياب الاستقرار المؤسسي، وتفكك النظام الإقليمي، وانهيار الترتيبات الأمنية السابقة، دفع عددًا من الفاعلين الدوليين وعلى رأسهم فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، والصين، إلى الانخراط في مسارات متباينة للنفوذ، في الوقت الذي تتقدم فيه قوى إقليمية كنيجيريا والمغرب والجزائر بأجندات متقاطعة تتراوح بين الأمن، والاقتصاد، والدبلوماسية الدينية. ويكشف هذا التنافس المتعدد الأبعاد عن أن غرب إفريقيا لم تعد مجرد هامش جغرافي ملحق بمراكز القوة، بل باتت نقطة اختبار حاسمة لترتيب القوى عالميًا، وتوازن المصالح إقليميًا[9].
- فرنسا – انحسار الدور التقليدي وتآكل شرعية النفوذ التاريخي
مثلت فرنسا الفاعل الأجنبي الأكثر تأثيرًا في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية لغرب إفريقيا لأكثر من ستة عقود، مستندة إلى ما يُعرف بمنظومة “فرانس أفريك”، وهي شبكة من العلاقات الزبائنية التي سمحت لباريس بإعادة إنتاج نفوذها الاستعماري ضمن ترتيبات شكلية من السيادة الوطنية. وقد مكن هذا النموذج فرنسا من تأمين مصالح استراتيجية حيوية تشمل السيطرة على الموارد الطبيعية، والتدخل السياسي في عمليات انتقال السلطة، وفرض النموذج الفرانكوفوني في التعليم والإعلام والإدارة[10].
غير أن العقدين الأخيرين شهدا بداية تحول بنيوي في علاقة دول غرب إفريقيا بفرنسا، تعزز بشكل متسارع خلال الفترة بين 2020 و2025، ليتحول من تراجع تكتيكي إلى أزمة شرعية متكاملة. فقد واجه الوجود الفرنسي رفضًا متصاعدًا في الشارع، خاصة بين الأجيال الشابة، حيث يُنظر إلى باريس كمصدر لإدامة التبعية والهيمنة لا كشريك تنموي. وقد بلغ هذا التوتر ذروته في الانسحابات العسكرية المتتالية: أولًا من مالي في أغسطس 2022، ثم من بوركينا فاسو في أوائل 2023، وأخيرًا من النيجر في أواخر 2023، بعد موجة من الانقلابات التي حملت نخبًا عسكرية ترفض علنًا النفوذ الفرنسي وتطالب بتغيير جذري في معادلة العلاقات الدولية[11].
*على المستوى العسكري – سقوط السردية الفرنسية في مكافحة الإرهاب:
أظهرت تجربة باريس العسكرية في منطقة الساحل، بدءًا من عملية “سيرفال” (2013) ثم “برخان” (2014–2022)، محدودية فعالية التدخلات الفرنسية في القضاء على الجماعات الإرهابية. بل إن هذه الجماعات تمددت جغرافيًا، وازدادت جرأتها، مما أفقد باريس حجتها الأمنية كمبرر للوجود العسكري، وعزز الخطاب الشعبي المناهض للتدخل الخارجي. كما ساهمت تقارير الانتهاكات ضد المدنيين، إلى جانب ضعف التنسيق مع الجيوش الوطنية، في فقدان الثقة بشرعية هذا الحضور[12].
*على المستوى السياسي – انهيار آلية الوصاية غير الرسمية:
فشلت فرنسا في منع سلسلة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات مدنية كانت تُعد حليفة لها، لا سيما في مالي، غينيا، بوركينا فاسو، والنيجر. ولم تملك باريس سوى التلويح بالعقوبات، دون القدرة على التأثير الفعلي في مسارات الحكم. لقد أظهرت هذه الأحداث نهاية فعالة لمنطق “الوصاية اللينة”، حيث لم تعد النخب العسكرية التي ترى نفسها امتدادًا لتيار السيادة الوطنية تقبل بتلقي التعليمات من باريس، وبدأت بتشكيل تحالفات استراتيجية بديلة مع روسيا، أو الانفتاح الاقتصادي على الصين وتركيا.[13]
*على المستوى الاقتصادي – تآكل الامتيازات الاستراتيجية:
تعرضت المصالح الاقتصادية الفرنسية في غرب إفريقيا لضربات موجعة. ففي النيجر، علقت السلطات العسكرية تصدير اليورانيوم نحو فرنسا، مما يُنذر بتداعيات خطيرة على قطاع الطاقة النووية الفرنسي الذي يعتمد جزئيًا على هذا المورد. كما تواجه الشركات الفرنسية، مثل “أورانو” و”توتال”، صعوبات متزايدة في تجديد امتيازاتها، أو حماية استثماراتها وسط بيئة سياسية متقلبة وعدائية نسبيًا.
أما على صعيد العملة، فقد تراجعت شرعية الفرنك الإفريقي الذي طالما شكل أحد أدوات الهيمنة الاقتصادية مع تنامي الدعوات لإنهاء ربطه بالخزانة الفرنسية، وتزايد مشاريع إصدار عملات وطنية أو إقليمية، أبرزها مبادرة “الإيكو” في غرب إفريقيا[14].
*الخطاب السيادي الجديد – تحدي لرمزية الفرانكوفونية:
اللافت أن تراجع النفوذ الفرنسي لم يكن تقنيًا أو ظرفيًا فقط، بل مسه تحول ثقافي وخطابي أعمق، تمثل في تصاعد نقد الفرانكوفونية كمنظومة ثقافية مقيدة للهوية الوطنية، وفي بروز رموز سياسية وعسكرية تروج لخطاب مناهض للاستعمار الثقافي، مما ينذر بانحسار طويل الأمد للنفوذ الفرنسي إذا لم يقابل بتحول جوهري في نمط الشراكة.[15]
تواجه فرنسا في غرب إفريقيا لحظة مفصلية، تتطلب منها إما تفكيك نموذج “فرانس أفريك” وإعادة بناء العلاقات على أسس الندية والاحترام المتبادل، أو القبول بالانكفاء الاستراتيجي لصالح قوى جديدة تتفوق في سرعة التكيف ومرونة الأدوات. لقد أصبح من غير الممكن استعادة النفوذ السابق عبر أدوات القوة التقليدية، بل باتت الشرعية الشعبية، والسيادة الوطنية، وتنوع الشراكات، العوامل الحاسمة في رسم ملامح النظام الإقليمي الجديد في غرب إفريقيا.
- روسيا – الصعود عبر الفراغ الأمني واستثمار الخطاب السيادي
في ظل تراجع الهيمنة الفرنسية والأمريكية، برزت روسيا كفاعل بديل يتموضع على تخوم الدولة في غرب إفريقيا، موظفة أدوات هجينة تجمع بين الدعم العسكري عبر مجموعة فاغنر والدبلوماسية الناعمة، لا سيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وقد تمكنت موسكو من فرض حضور رمزي وميداني متنامي، خصوصًا بعد توقيع اتفاقات أمنية مع الحكومات العسكرية الجديدة، حيث حلت عناصر فاغنر محل القوات الفرنسية في حماية النخب، وتأمين منشآت الدولة، ومرافقة عمليات مكافحة التمرد[16].
*الحضور الأمني عبر مجموعة فاغنر
منذ عام 2021، كثفت روسيا حضورها العسكري غير النظامي في غرب إفريقيا من خلال نشر مقاتلي مجموعة فاغنر، المرتبطة بشكل وثيق بمؤسسة الأمن الروسي والكرملين، وذلك تحت غطاء دعم الأنظمة العسكرية في مكافحة الجماعات المسلحة. مثلت مالي نقطة الانطلاق المركزية لهذا التمدد، حيث أبرم المجلس العسكري الحاكم اتفاقًا مع فاغنر بعد انسحاب القوات الفرنسية، مما شكل تحولًا في التموضع الاستراتيجي داخل المنطقة. [17]
ورغم الطابع الأمني المعلن لهذه الشراكة، إلا أن فاغنر تمثل عمليًا أداة متعددة الوظائف في السياسة الخارجية الروسية، تجمع بين الدور القتالي، وحماية الأنظمة، واستغلال الموارد، وترسيخ النفوذ الجيوسياسي. فبالتوازي مع مهامها العسكرية، تنخرط المجموعة في عمليات اقتصادية واسعة النطاق تشمل السيطرة على مناجم الذهب، وتحصيل عوائد جمركية، وتوقيع عقود أمنية وشركات غامضة للواجهة التجارية. وبهذا، يتحول التدخل الروسي من مجرد دعم عسكري إلى مشروع نفعي متكامل، يدر عوائد مباشرة لصالح موسكو، في الوقت الذي تتولى فيه فاغنر كلفة العمليات من دون أعباء دبلوماسية أو مساءلة دولية رسمية[18].
وقد وثقت تقارير أممية ومنظمات حقوقية ارتكاب فاغنر لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في مالي، شملت مذابح جماعية، واعتقالات تعسفية، واعتداءات جنسية، واختفاءات قسرية، نُسبت إلى تنسيق مباشر مع الجيش المالي. وقد دعت الأمم المتحدة حكومة باماكو إلى التحقيق في هذه الجرائم، محذرة من احتمال تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يفتح الباب أمام مساءلة دولية مستقبلية. [19]
وفي أعقاب مقتل مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، عام 2023، وتفكك البنية التقليدية للمجموعة، بدأت روسيا في إعادة هيكلة أدواتها الأمنية في إفريقيا من خلال تشكيل ما يُعرف بـ الفيلق الإفريقي، وهو كيان عسكري شبه رسمي يُعد إما امتدادًا وظيفيًا لفاغنر أو بديلًا تدريجيًا لها، يُدار بإشراف من وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر. وقد واصل هذا الفيلق الانتشار في مناطق النفوذ نفسها، مستفيدًا من البنية التحتية والمصالح الاقتصادية التي أسستها فاغنر، بما في ذلك شبكات التعدين والنقل، والعقود الأمنية الخاصة، مما يعني أن موسكو لم تنهي استراتيجيتها في غرب إفريقيا، بل أعادت موضعتها لتفادي الضغط الدولي، وضمان استمرار العوائد الاقتصادية والجيوسياسية. [20]
وتكشف هذه المعادلة عن أن التدخل الروسي في غرب إفريقيا لم يعد مجرد رهانا أمنيًا، بل تحول إلى منظومة استراتيجية قائمة على التغلغل المتعدد المستويات، حيث تتقاطع شبكات المصالح العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، في إطار نموذج نفوذ لا مركزي يتجاوز الدولة الروسية الرسمية، لكنه يُوظف في خدمة مشروعها الإمبراطوري الجديد. بهذا، تصبح فاغنر ومعها الفيلق الإفريقي أدوات لإعادة إنتاج مفهوم النفوذ بدون قواعد، يتيح لموسكو خوض صراع متعدد الأبعاد في القارة الإفريقية دون التقيد بالأطر التقليدية للعلاقات الدولية أو الالتزامات القانونية.
*الاستراتيجية الاقتصادية: مشاريع الطاقة والبنية التحتية
في سياق التنافس الدولي على الموارد والأسواق الإفريقية، تحاول روسيا ترسيخ موطئ قدم اقتصادي في غرب إفريقيا، عبر مشاريع نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ترتبط غالبًا بصفقات أمنية أو بدعم سياسي للأنظمة العسكرية الحاكمة. وعلى الرغم من أن الحضور الروسي في هذا المجال لا يزال ناشئًا وهامشيًا من حيث الحجم مقارنة بالصين أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن موسكو تُوظف هذه المشاريع كجزء من استراتيجية نفوذ شاملة تعتمد على التداخل بين الاقتصاد والأمن والدبلوماسية. [21]
في مالي، على سبيل المثال، وقعت الحكومة الانتقالية مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي لتطوير مشروع تعدين الليثيوم في منطقة بوغولا، وهو مورد استراتيجي عالمي يدخل في صناعات البطاريات والتكنولوجيا المتقدمة. كما تم الإعلان عن خطة لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط في منطقة سانانكوروبا في مالي، من خلال شراكة بين شركة روسية ووزارة الطاقة المالية، وهو ما يُظهر اهتمامًا روسيًا متزايدًا بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بوصفه مدخلًا غير تقليدي للنفوذ وتوسيع العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
وتتجاوز هذه المبادرات مالي، حيث تبدي روسيا اهتمامًا متزايدًا بالدخول في مشاريع البنية التحتية في كل من بوركينا فاسو وغينيا والنيجر، من خلال اتفاقيات للتعاون في مجالات الطاقة والنقل والتعدين. ففي غينيا، على سبيل المثال، تواصل شركة RUSAL الروسية (إحدى أكبر شركات الألومنيوم في العالم) تشغيل مناجم البوكسيت، مما يربط الوجود الروسي بالموارد المعدنية الحيوية. كما جرى توقيع اتفاقيات تمهيدية مع النيجر لتعزيز التعاون في الطاقة النووية والتنقيب عن المعادن النادرة، وهو ما يعكس توجهًا روسيًا نحو الاستثمار في السلع الإستراتيجية التي يمكن أن تُوظف سياسيًا في التنافس مع القوى الغربية. [22]
مع ذلك، فإن الوزن الكلي للاستثمارات الروسية في القارة الإفريقية لا يزال محدودًا جدًا، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن روسيا لا تمثل سوى أقل من 1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، مقارنة بالصين التي تتجاوز حصتها 16%، أو فرنسا والاتحاد الأوروبي الذين يحتفظون بنفوذ مالي وتجاري مستقر نسبيًا. وتُظهر هذه الأرقام أن موسكو، بخلاف القوى الاقتصادية الكبرى، لا تعتمد على ثقل استثماري شامل، بل تركز على مشاريع استراتيجية ذات طابع انتقائي، غالبًا ما تكون مرتبطة بصفقات أمنية أو بمكافآت سياسية لأنظمة غير ديمقراطية.[23]
ومن هذا المنظور، فإن الاقتصاد بالنسبة لروسيا لا يُمثل بُعدًا مستقلًا، بل يُدمج ضمن شبكة مركبة من أدوات التأثير، حيث تصبح مشاريع الطاقة والتعدين رافعة سياسية وأمنية تُستخدم لترسيخ التحالفات وتعويض محدودية القوة المالية. فالمقاربة الروسية لا تسعى إلى تحويل غرب إفريقيا إلى سوق للتجارة التقليدية، بقدر ما تستهدف السيطرة على الموارد الاستراتيجية، وضمان ولاء النخب العسكرية، وبناء قواعد نفوذ بديلة عن المنظومة الغربية.
وهكذا، فإن الاستراتيجية الاقتصادية الروسية في غرب إفريقيا ليست مجرد محاولات تنموية، بل تدخل في إطار مقاربة جيوسياسية تستخدم الاقتصاد كأداة تكميلية لفرض نفوذ سياسي وأمني، وتستغل في ذلك هشاشة الدولة الوطنية، والحاجة الماسة لدى الحكومات الانقلابية إلى الاعتراف الدولي والدعم التقني.
*الدبلوماسية متعددة الأطراف: قمم روسيا-إفريقيا
في إطار سعيها لتوسيع نفوذها خارج المجال السوفيتي السابق، اعتمدت روسيا مقاربة دبلوماسية متعددة الأطراف مع القارة الإفريقية، تُوجت بعقد قمتين بارزتين في سوتشي عام 2019، وسان بطرسبرغ في يوليو 2023، جمعت خلالها الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء ووفود 49 دولة إفريقية، من بينها غالبية دول غرب القارة. وشكلت هذه القمم منصة لإعادة تموضع روسيا كفاعل دولي غير استعماري يسعى لبناء علاقات ندية مع إفريقيا، في مواجهة الهيمنة الغربية التقليدية.
خلال قمة 2023، أعلنت موسكو عن خطة عمل شاملة من 181 بندًا لتطوير التعاون مع الدول الإفريقية، شملت مجالات الأمن والدفاع، والتجارة، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والثقافة. كما تعهدت روسيا بإلغاء ديون بقيمة 23 مليار دولار كانت مستحقة على دول إفريقية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية مجانية لبعض الدول التي تعاني من أزمات إنسانية، مثل مالي وبوركينا فاسو وإريتريا، كرد مباشر على انسحابها من اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا. [24]
ورغم الرمزية القوية لهذه المبادرات، فإن الكثير من الاتفاقيات المعلنة لم تترجم إلى مشاريع عملية على الأرض، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار، حيث لا تزال حصة روسيا من إجمالي التبادل التجاري مع إفريقيا لا تتجاوز 2%. ويعزى ذلك إلى ضعف البنية التحتية المالية الروسية في القارة، والعقوبات الدولية التي تُعقد عمليات التحويل والدفع، فضلًا عن محدودية الشركات الروسية العاملة خارج قطاع التعدين والدفاع.
ومع ذلك، تُظهر الشراكات النوعية في غرب إفريقيا نمطًا مختلفًا، إذ تفضل العديد من العواصم، خصوصًا في الدول التي شهدت انقلابات (مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر)، التعامل مع روسيا على أساس “اللاعب غير المتدخل”، أي الذي لا يفرض شروطًا سياسية أو حقوقية، ولا يُطالب بإصلاحات ديمقراطية مقابل الدعم العسكري أو الاستثماري. وتُعد هذه اللامشروطية السياسية أحد أبرز عوامل الجاذبية في التعاون مع موسكو، لا سيما لدى الأنظمة العسكرية التي تبحث عن دعم دولي دون مساءلة داخلية أو خارجية.
كما يُنظر إلى روسيا باعتبارها شريكًا واقعيًا يقدم أدوات أمنية مباشرة كالتدريب، والمعدات، والدعم الاستخباراتي دون الدخول في تعقيدات بيروقراطية أو مشروطيات حقوق الإنسان، وهو ما يميزها عن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، وقعت موسكو اتفاقيات تعاون دفاعي مع مالي (2021)، وبوركينا فاسو (2023)، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا، تضمنت توريد الأسلحة، وتبادل المعلومات الأمنية، ونشر مستشارين عسكريين .[25]
أما في المجال الاقتصادي، فقد تم التوقيع على اتفاقيات استثمارية في مجالات التعدين (الذهب والبوكسيت والليثيوم)، والطاقة الشمسية، والنقل، أبرزها في مالي وغينيا. ويُعزز هذا النهج ما يُعرف بـ”الواقعية الاقتصادية”، حيث تُوظف الموارد كضمانات للتعاون الأمني والسياسي، دون المرور بمسارات إصلاحية معقدة.
بالتالي، فإن دبلوماسية القمم الروسية الإفريقية لا تُقاس بحجم التبادل التجاري المباشر فقط، بل بما تمنحه من شرعية وغطاء سياسي لحضور متزايد لروسيا في فضاءات الصراع والفراغ الجيوسياسي، وهو حضور تُحدده معادلة “الدعم مقابل الولاء”، لا “التنمية مقابل الإصلاح”. وتكشف هذه الاستراتيجية عن رغبة موسكو في ترسيخ “علاقات استراتيجية طويلة الأمد”، تُعيد بناء تحالفات خارج الفلك الغربي، وتفتح أمامها فضاءات نفوذ جديدة وسط نظام دولي آخذ في التحول.
- الولايات المتحدة – أمننة العلاقات وتحديات الفاعلية السياسية
رغم أن الولايات المتحدة لم تكن فاعلًا تقليديًا في غرب إفريقيا بالحجم نفسه الذي تحظى به في شرق أو شمال القارة، إلا أن مصالحها الحيوية في المنطقة ارتبطت بثلاثة محاور أساسية، مكافحة الإرهاب، حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، والحد من النفوذ الصيني والروسي المتصاعدين. ومع تصاعد الاضطرابات السياسية وتعدد الانقلابات العسكرية، أصبحت السياسة الأمريكية أكثر تركيزًا على الأمن، وأقل التزامًا بأجندات التحول الديمقراطي، مما كشف عن تحولات جوهرية في أولوياتها الاستراتيجية.
*الدور الأمني – هندسة التحالفات وتوسيع قواعد الاستخبارات
تُعد منطقة الساحل وغرب إفريقيا ساحة محورية في العقيدة الأمنية الأمريكية في إفريقيا، لا سيما في ظل تصاعد تهديد الجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة. وقد استثمرت واشنطن في بناء شبكة عسكرية واستخباراتية مرنة، ترتكز على قاعدة أغاديز 201 الجوية شمال النيجر، والتي تُعتبر أكبر منشأة للطائرات بدون طيار خارج الأراضي الأمريكية، تُستخدم لتنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة واغتيالات دقيقة في عمق منطقة الساحل.
إلى جانب ذلك، تدير الولايات المتحدة برامج تدريب وتأهيل للقوات المسلحة في كل من نيجيريا، السنغال، غانا، وكوت ديفوار، من خلال مبادرات مثل AFRICOM (القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا)، وTSCTP (برنامج مكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى). وقد ساهم هذا الوجود في بناء شراكات أمنية “منخفضة التكلفة” تؤمن المعلومات الاستخباراتية وتوفر أدوات الردع، دون التورط المباشر في العمليات البرية.
غير أن فاعلية هذه المقاربة تراجعت بفعل الانسحابات القسرية، كما في حالة النيجر التي طالبت مؤخرًا القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، في سياق إعادة تشكيل تحالفاتها بعيدًا عن القوى الغربية، وهو ما يطرح تساؤلات حول استدامة النموذج الأمني الأمريكي في المنطقة في ظل تمدد النفوذ الروسي. [26]
*الدور الاقتصادي – تجارة محدودة ومصالح استراتيجية غير متوازنة
اقتصاديًا، لا تشكل الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدول غرب إفريقيا مقارنة بالصين أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن حضورها يُركز على قطاعات استراتيجية عالية الحساسية، مثل النفط، الغاز، والمعادن النادرة. وقد دعمت واشنطن، عبر وكالة التنمية الأمريكية (USAID) وذراعها التمويلي DFC (مؤسسة تمويل التنمية الدولية)، مشاريع استثمارية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة، إلا أن حجم هذه الاستثمارات ظل محدودًا مقارنة بالقوى الأخرى، ويصطدم عادة بمعوقات بيروقراطية وشروط سياسية ثقيلة.
ومع عودة ترامب إلى الحكم، تُشير التوجهات الجديدة إلى تراجع دعم المبادرات التنموية طويلة الأمد، والتركيز على الاستثمار فقط في المشاريع ذات العائد المباشر للمصالح الأمريكية، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني والطاقة. كما يدعو عدد من المحافظين في الكونغرس إلى إعادة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة والمساعدات التنموية في القارة، بحجة أن العوائد لا تتناسب مع التكاليف، وهو ما يعكس تحولًا نحو سياسة خارجية أكثر نفعية وأحادية.
*الدور الدبلوماسي – خطاب ديمقراطي متردد وتراجع الهيبة الرمزية
دبلوماسيًا، حاولت إدارة بايدن بين عامي 2021 و2024 توظيف خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان كأداة ناعمة لمواجهة النفوذ الصيني والروسي، إلا أن الانقلابات العسكرية المتلاحقة وضعت واشنطن أمام اختبار مزدوج، إما الالتزام بالمبادئ الليبرالية وقطع العلاقات، أو تبني الواقعية الاستراتيجية والاستمرار في التواصل الأمني مع الأنظمة الجديدة.
وقد اختارت واشنطن الخيار الثاني، حيث لم تُدرج مالي، أو بوركينا فاسو، أو النيجر ضمن الدول المعاقَبة بالكامل، بل استمرت في بعض برامج الدعم الفني والتدريب. هذا التناقض بين المبادئ والمصالح أضعف من مصداقية الخطاب الأمريكي، وأعطى القوى المنافسة حجة لإبراز واشنطن كقوة انتقائية ومزدوجة المعايير.
أما في ظل إدارة ترامب (2025)، فتبدو الدبلوماسية الأمريكية في طور الانكفاء الجزئي، مع غياب الاهتمام بالمؤسسات متعددة الأطراف، وتقليص الانخراط في الملفات الحقوقية والديمقراطية، مقابل التركيز على أجندات ضيقة تشمل، مكافحة الهجرة، السيطرة على تدفقات السلاح، وتأمين مصادر الطاقة والمعادن. [27]
تُظهر السياسة الأمريكية في غرب إفريقيا ميلًا متزايدًا نحو أمننة العلاقة مع النظم الحاكمة، على حساب تعزيز الاستقرار الديمقراطي والتنمية المستدامة. وتبدو واشنطن اليوم أقل قدرة على لعب دور “الموازن الأخلاقي” الذي لطالما رفعت شعاره، وأكثر تركيزًا على أدوات القوة الصلبة والمصالح الجيوسياسية الآنية. وهذا ما يمنح خصومها، خصوصًا روسيا والصين، مساحة أوسع للتمدد داخل فراغات القوة التقليدية الأمريكية، مستفيدين من تصاعد النزعة السيادية لدى دول المنطقة، واستعدادها لقبول شراكات “بلا مشروطية سياسية”.
- الصين – من الاقتصاد إلى النفوذ الاستراتيجي غير التصادمي
تمثل الصين اليوم أحد أبرز الفاعلين غير الغربيين في المشهد السياسي والاقتصادي لغرب إفريقيا، مستفيدة من تراجع الحضور التقليدي للقوى الغربية، وتنامي المطالب التنموية لدول المنطقة، وبحثها عن شركاء لا يربطون التعاون الاقتصادي بشروط سياسية. وتُعد الصين القوة الدولية الوحيدة التي استطاعت مواءمة مصالحها الاقتصادية مع خطاب “عدم التدخل في الشؤون الداخلية”، ما عزز من جاذبيتها لدى الأنظمة التي صعدت إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية، أو تلك التي تواجه تحديات تنموية مزمنة. [28]
*استراتيجية “الحزام والطريق” – شبكة نفوذ عبر البنية التحتية
أطلقت الصين في عام 2013 مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الربط التجاري والاقتصادي العالمي عبر تمويل وتشييد مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، وتوسعت تدريجيًا لتشمل غرب إفريقيا بوصفها بوابة استراتيجية نحو أسواق الأطلسي وممرات الطاقة.
الدول الغربية المنخرطة في المبادرة: نيجيريا (الاقتصاد الأكبر في إفريقيا)، غانا، السنغال، سيراليون، غينيا، كوت ديفوار، بنين، مالي، الرأس الأخضر، وتغطي هذه الدول ممرًا حيويًا على المحيط الأطلسي وداخل الساحل، وتوفر فرصًا استثمارية في مجالات الموانئ والمناجم والطاقة والنقل. [29]
أبرز المشاريع المرتبطة بالحزام والطريق في غرب إفريقيا:
• نيجيريا:
مولت الصين مشروع خط السكك الحديدية بين لاجوس وكانو بقيمة تقارب 11 مليار دولار، وشاركت في بناء مطار العاصمة أبوجا الدولي، إلى جانب مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة، مثل تطوير شبكات كهرباء الريف. وفي مايو 2025، وافق بنك التصدير والاستيراد الصيني على حزمة تمويل بقيمة 652 مليون دولار لبناء طريق يربط ميناء ليكي العميق بمصفاة دانغوتي.
• غانا:
وسعت الصين ميناء تيما، فرفعت قدرته الاستيعابية إلى أكثر من 3.7 مليون حاوية سنويًا. كما مولت مشاريع في الطاقة المتجددة، ووقعت اتفاقيات استغلال موارد البوكسيت، مقابل تمويل طرق وجسور ومنشآت عامة، في صفقة أثارت جدلًا داخليًا بشأن رهن الموارد الطبيعية. [30]
• السنغال:
أنشأت الصين منطقة اقتصادية خاصة خارج داكار، وهي الأولى من نوعها في غرب إفريقيا، إضافة إلى استثمارات في تطوير الطرق والموانئ، وتمويل بناء استاد أولمبي وطني بالعاصمة. [31]
• سيراليون وغينيا:
عززت الصين حضورها في قطاع الذهب والبوكسيت من خلال شراكات مع شركات التعدين الوطنية، كما مولت مشروعات لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، وبنت طرقًا سريعة لربط المناطق الداخلية بالساحل.
• كوت ديفوار وبنين:
تشمل الاستثمارات الصينية مشاريع في الزراعة والبنية الرقمية، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء، وإنشاء مراكز تدريب مهني تقني تمولها شركات صينية ضمن سياسة توطين المعرفة. [32]
*القوة الناعمة – التعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية
تعتمد الصين على استراتيجية طويلة الأجل للقوة الناعمة في غرب إفريقيا، لبناء علاقات شعبية ونخبوية بعيدة عن الطابع الاستعماري الغربي التقليدي: [33]
• المعاهد الكونفوشيوسية: أنشأت الصين عدة معاهد في جامعات غربية إفريقية، مثل: جامعة غانا، جامعة كيب كوست، جامعة لاغوس (نيجيريا)بهدف تعليم اللغة الصينية وتعزيز التفاهم الثقافي.
• المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي: تقدم الصين آلاف المنح سنويًا للطلبة الأفارقة، وتوفر برامج تدريبية للعاملين في قطاعات الزراعة، الطاقة، والإدارة العامة.
• المساعدات الطبية والتكنولوجية: خلال أزمة “كوفيد-19”، أرسلت الصين كميات ضخمة من اللقاحات والمعدات الطبية لدول غرب إفريقيا، مما عزز صورتها كقوة إنسانية. [34]
*الأدوار الأمنية والدبلوماسية – الحضور الناعم في المجال السيادي
رغم طابعها غير التصادمي، فإن الصين بدأت تدريجيًا بناء بنية أمنية ناعمة في القارة، عبر:
• مبادرة الأمن العالمي: أطلقتها بكين عام 2022، وتروج فيها لفكرة الأمن التشاركي القائم على احترام السيادة وعدم التدخل، وهو خطاب يتماشى مع مزاج الأنظمة العسكرية الحالية في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو.
• مشاركات رمزية في عمليات حفظ السلام: تساهم الصين بقوات رمزية في بعثات الأمم المتحدة (مثل مينوسما في مالي)، وتدرب عناصر شرطة ومهندسين عسكريين في دول متعددة.
• الوساطة في النزاعات: تلعب الصين أدوارًا غير مباشرة في حل النزاعات، كما أظهرت في دعم جهود إعادة الاستقرار السياسي في غينيا بعد الانقلاب، دون فرض شروط على النظام الجديد. [35]
*التحديات البنيوية – الديون والشفافية والارتباطات الاستراتيجية
رغم النجاحات الاقتصادية، تواجه الصين في غرب إفريقيا انتقادات متزايدة حول:
• تصاعد الديون السيادية: العديد من المشاريع الصينية تعتمد على قروض طويلة الأجل، مما يُثير مخاوف من “فخ الديون” وفقدان السيطرة على أصول استراتيجية كما حدث في بعض الدول الآسيوية.
• ضعف الشفافية: الاتفاقيات بين الحكومات والشركات الصينية غالبًا ما تكون غير معلنة بالكامل، مما يثير اعتراضات من منظمات المجتمع المدني حول فقدان الرقابة والمساءلة.
• الاعتماد على العمالة الصينية: يتهم البعض الصين بتقليص فرص العمل المحلية عبر جلب عمال صينيين حتى في المشاريع الصغيرة، مما يضعف الأثر التنموي المباشر. [36]
تُظهر التجربة الصينية في غرب إفريقيا نموذجًا بديلًا من “الهيمنة غير الاستعمارية”، يرتكز على أدوات الاقتصاد والتمويل والدبلوماسية الثقافية، دون التدخل في النظم السياسية أو فرض نماذج حكم. وهذا ما يجعل الصين شريكًا مفضّلًا لدى عدد من الأنظمة الحاكمة، خصوصًا في سياق ما بعد الانقلابات، حيث يُنظر إلى بكين كقوة داعمة للتنمية بلا مشروطية سياسية. [37]
ومع ذلك، فإن استدامة هذا النفوذ ستظل رهينة بقدرة الصين على تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التنمية المحلية، وتجنب تكرار أنماط التبعية الاقتصادية، خاصة في ظل منافسة شرسة من قوى أخرى، وفي بيئة سياسية شديدة التقلب.
ثانيًا: تأثير التنافس الدولي على التحولات السياسية في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر
- مالي – بين تحولات النخب وصعود النظام العسكري في ظل التنافس الدولي
تُمثل مالي اليوم حالة نموذجية على التحولات العميقة في النظم السياسية لغرب إفريقيا، حيث أدت الانقلابات العسكرية المتتالية (2020 و2021) إلى إسقاط نخبة مدنية-بيروقراطية كانت تحكم منذ بداية المرحلة الديمقراطية في تسعينيات القرن الماضي، وظهور نخبة عسكرية جديدة تُعيد تعريف علاقات الدولة داخليًا وخارجيًا. [38]
*تحولات النخب: من التحالف المدني الغربي إلى النخبة العسكرية السيادية
النخب القديمة: طوال العقدين الماضيين، حكمت مالي نخبة مدنية مدعومة من الغرب، تمثلت في أحزاب تقليدية مثل “التجمع من أجل مالي (RPM)”، وتحالفت مع مؤسسات مالية دولية، واعتمدت في شرعيتها على الانتخابات التعددية والدعم الفرنسي-الأمريكي، إلا أن هذه النخبة فشلت في احتواء التدهور الأمني، وتورطت في قضايا فساد، وفقدت قدرتها على ضبط المشهد السياسي أو كسب رضا الشارع، خاصة بعد سقوط شمال البلاد بيد الجماعات المسلحة عام 2012.
النخبة الجديدة: جاءت الانقلابات بقيادة المقدم أسيمي غويتا لتعكس صعود جيل جديد من الضباط الشباب، الذين يحملون خطابًا سياديًا، مناهضًا للتدخل الأجنبي، ويعتمدون على دعم شعبي نسبي في المدن الكبرى، مدعومًا بدعاية إعلامية ومواقف معادية للنفوذ الفرنسي، ومتقاربة مع روسيا.
هذه النخبة العسكرية الجديدة لا تملك خلفيات حزبية تقليدية، بل تستند إلى شبكات أمنية-بيروقراطية وإلى تحالفات داخل الجيش، وتُحاول بناء “مشروعية بديلة” تقوم على السيادة، الأمن، والانفصال عن المنظومة الغربية. [39]
* أثر التنافس الدولي على إعادة تشكيل النخب
تراجع فرنسا وصعود روسيا: أدى الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية (عملية برخان) وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد باريس إلى انهيار التحالف التقليدي بين النخب المالية القديمة وفرنسا. وفتحت هذه الدينامية الطريق أمام تقارب مع موسكو، التي دعمت السلطة الجديدة عبر نشر مجموعة فاغنر، وتقديم مساعدات أمنية، ومنح دراسية، وخطابات داعمة في الأمم المتحدة. [40]
الولايات المتحدة والغرب: ورغم استمرار التعاون الأمني المحدود مع واشنطن، إلا أن الولايات المتحدة نأت بنفسها عن دعم النظام الجديد بشكل مباشر، مما ساهم في هامش استقلالية أوسع للنخب العسكرية، وأضعف من قدرة المجتمع الدولي على فرض شروط سياسية (مثل العودة السريعة للانتقال الديمقراطي).
روسيا كممول للشرعية البديلة: استطاعت روسيا أن تتحول إلى “ضامن خارجي” للنظام الجديد، عبر توفير الحماية الأمنية والدعم السياسي، مقابل منحها موطئ قدم استراتيجي، وامتيازات اقتصادية في قطاع التعدين. وهذا التحول جعل من التنافس الدولي عاملاً جوهريًا في ترسيخ النخبة العسكرية الجديدة، وتعميق الشرخ بينها وبين القوى الغربية.
* إعادة هيكلة النظام السياسي
تحالف عسكري-مدني موالي للسلطة: أنشأ النظام العسكري مؤخرًا ما يُعرف بـ”الهيئة الانتقالية لإعادة بناء الدولة”، وهي تضم عناصر من المجتمع المدني الموالي للجيش، وزعامات تقليدية ودينية، في محاولة لصياغة تحالف سياسي جديد يمهد لـ”جمهورية ثالثة” تنهي إرث المرحلة السابقة.
تأجيل الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية: رغم الوعود المتكررة بالعودة إلى الحكم المدني، تم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، وهو ما يعكس رغبة النخبة العسكرية في تكريس وجودها لفترة أطول، تحت ذريعة ضرورة استعادة الأمن أولاً، وهو منطق تدعمه موسكو ضمنيًا، وتتحفظ عليه باريس وواشنطن. [41]
تشكل مالي حالة دراسية معبرة عن التغير في النخب السياسية الإفريقية في ظل التنافس الدولي المتصاعد، حيث أدى فشل النخبة المدنية التقليدية، والفراغ الاستراتيجي الذي خلفه انسحاب فرنسا، إلى صعود نخبة عسكرية سيادية تتقاطع مصالحها مع القوى غير الغربية، خصوصًا روسيا. ويبدو أن هذه النخبة الجديدة بصدد ترسيخ مشروع سياسي-أمني بديل يتحدى المنظومة الليبرالية التقليدية، ويعيد صياغة معايير الحكم والتحالفات في المنطقة. [42]
- بوركينا فاسو: من الدولة الهشة إلى مشروع الاستقلال السيادي
تعيش بوركينا فاسو منذ عام 2022 واحدة من أعمق التحولات السياسية في تاريخها الحديث، حيث شهدت انقلابين متتالين أطاحا بالنخب الحاكمة التقليدية، وأسفرا عن صعود نخبة عسكرية شابة بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري، وسط تصاعد في التحديات الأمنية والتدخلات الدولية المتنافسة. وقد أدت هذه التحولات إلى إعادة هندسة النظام السياسي ومصادر الشرعية، في ظل انسحاب القوى الغربية، وتصاعد النفوذ الروسي.
* تغير النخب السياسية: من حكم المدنيين إلى قيادة عسكرية من الجيل الشاب
النخب السابقة (ما قبل 2022): كانت النخب السياسية في بوركينا فاسو تمثل امتدادًا لمرحلة ما بعد التحول الديمقراطي في 2014، بعد الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري. تمثلت هذه النخب في تحالفات مدنية بقيادة الرئيسين روش مارك كريستيان كابوري ومن بعده بول هنري سانداوغو داميبا، وكانت تحظى بدعم فرنسي وأوروبي قوي، وبتمويلات من الاتحاد الأوروبي والوكالات التنموية الغربية، مقابل الالتزام بمسار الانتخابات، وتعزيز الديمقراطية الشكلية، ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع باريس وواشنطن. [43]
غير أن هذه النخب فشلت في السيطرة على التدهور الأمني في البلاد، خاصة في الشمال والشرق، حيث تمددت الجماعات الإرهابية، وتزايدت الهجمات على الجيش والمدنيين. كما تراجعت شرعيتها في أوساط الشباب والجيش بسبب اتهامات بالفساد والتواطؤ مع مصالح أجنبية.
النخبة الجديدة: قاد الضابط الشاب إبراهيم تراوري (34 عامًا) انقلابًا في سبتمبر 2022، أطاح بالحكومة العسكرية بقيادة داميبا، تحت شعار إعادة السيادة، والتصدي لعدم الكفاءة في مواجهة الإرهاب، وتحرير البلاد من الهيمنة الفرنسية. يمثل تراوري نخبة عسكرية جديدة من الجيل الشاب، نشأت في قلب المؤسسة العسكرية، وتحمل توجهات سيادية راديكالية، وتُقدم خطابًا يمزج بين العدالة الاجتماعية، القومية الإفريقية، ورفض التبعية للغرب. [44]
هذه النخبة تعتمد في شرعيتها على الاحتجاجات الشعبية المناهضة لفرنسا، وتحالفات أفقية مع النخب العسكرية في مالي والنيجر، وتبدو أكثر انسجامًا مع محور روسي-صيني صاعد في المنطقة.
* أثر التنافس الدولي في إعادة تشكيل النخبة ونظام الحكم
الانسحاب الفرنسي ونهاية النفوذ التقليدي: في يناير 2023، طلبت بوركينا فاسو رسميًا من القوات الفرنسية مغادرة أراضيها، منهية بذلك عقدًا من التعاون العسكري الذي بدأ مع عملية “سرفال” ثم “برخان”. هذا الانسحاب لم يكن فقط مؤسسيًا، بل عكس تغيرًا جذريًا في التحالفات السياسية، وتخلي النخبة الجديدة عن السردية الغربية للأمن والديمقراطية، لصالح نموذج سيادي أكثر استقلالية.
روسيا كبديل أمني واستراتيجي: لجأت النخبة الحاكمة الجديدة إلى توطيد العلاقات مع روسيا، حيث تتعاون بوركينا فاسو حاليًا مع عناصر من مجموعة فاغنر أو ما يُعرف حديثًا بـ”الفيلق الإفريقي”، ضمن اتفاقات غير معلنة لكنها فعالة على مستوى العمليات الأمنية. وتشير تقارير إلى وجود مستشارين روس، وتنسيق عسكري غير رسمي مع موسكو، يترافق مع خطاب سياسي يعادي النفوذ الغربي، ويُروج لـتحرير القرار الوطني من الهيمنة الأوروبية.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في موقف المتفرج: رغم انتقادات غربية واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الإعلام في عهد تراوري، إلا أن واشنطن وبروكسل لم تتخذا خطوات عقابية حاسمة، مما يُظهر ضعف أدوات الضغط الغربي في ظل رغبة تراوري في تنويع الشراكات الدولية وتفكيك الاعتمادية التقليدية.
* إعادة هندسة النظام السياسي: من الديمقراطية الشكلية إلى النظام العسكري القومي
تفكيك المؤسسات الانتقالية القديمة: ألغت الحكومة العسكرية الجديدة الكثير من القوانين المرتبطة بالمجتمع المدني، وجمدت عمل الأحزاب التقليدية، وحدت من نشاط الإعلام المستقل، في سياق يسعى إلى إعادة صياغة الدولة على أسس جديدة لا تُشبه ما قبل 2022. كما بدأ النظام في إنشاء منصات شعبية بديلة مثل “حركة الوطنيين المستقلين” التي تدعم تراوري بشكل مباشر.
خطاب الهوية الإفريقية ومناهضة الاستعمار: تبنى تراوري ومجموعته خطابًا رمزيًا قويًا يرتكز على القومية الإفريقية، والإرث الثوري للزعيم توماس سانكارا، ما يعزز شرعيته لدى الشباب والحركات المناهضة للاستعمار. هذا التوظيف الرمزي ساعد في شرعية الحكم العسكري شعبويًا، وتقويض شرعية النخب التقليدية المرتبطة بالغرب. [45]
إن التحولات في بوركينا فاسو لا تُعبر فقط عن أزمة حكم أو فشل مؤسسات، بل تعكس تغيرًا بنيويًا في من يُمثل السلطة، وكيف تُدار الدولة، ولأي أهداف تُوظف. فصعود نخبة عسكرية جديدة من جيل شاب، واختيارها الانفصال عن الغرب والتموضع ضمن محور روسي-إفريقي سيادي، يُعيد رسم خريطة النخب والتحالفات السياسية في غرب إفريقيا. ويبدو أن التنافس الدولي لم يعد مجرد خلفية للصراعات الداخلية، بل أصبح محركًا مباشرًا لإعادة هندسة السلطة وتوزيع القوة داخل الدولة.
- النيجر: من قاعدة غربية إلى عقد سيادي جديد
شهدت النيجر في يوليو 2023 تحولًا سياسيًا جذريًا بإطاحة الرئيس المنتخب محمد بازوم على يد الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وقد مثل هذا الانقلاب ذروة التحولات التي تعصف بغرب إفريقيا، حيث اتخذ مسار النيجر أبعادًا غير مسبوقة نتيجة طبيعتها الجيوسياسية الحساسة، وموقعها الاستراتيجي في صلب المصالح الغربية، وتحديدًا الأمريكية والفرنسية. هذا التحول أسفر عن صعود نخبة عسكرية جديدة تتبنى خطابًا سياديًا متشددًا، وساهم التنافس الدولي في تعميق الفجوة بين النخبة القديمة المرتبطة بالغرب، والجديدة التي تميل شرقًا نحو روسيا وشركاء غير تقليديين.
* تحولات النخبة: من النخبة المدنية ذات المرجعية الغربية إلى النخبة العسكرية السيادية
النخبة السابقة: كان الرئيس محمد بازوم يمثل استمرارية لمنظومة سياسية مدنية نشأت منذ التحول الديمقراطي مطلع الألفية الجديدة، بدعم فرنسي وأوروبي وأمريكي. وقد ارتكزت شرعيته على الانتخابات المنتظمة، وتحالفه الوثيق مع باريس وواشنطن، والتزامه بالسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، والتعاون الأمني الوثيق في ملف مكافحة الإرهاب في الساحل.
غير أن شرعية بازوم تآكلت بفعل التحديات الداخلية، مثل الفساد، التفاوت الاقتصادي، وتمدد الجماعات المسلحة، إلى جانب تصاعد شعبي ضد الحضور الفرنسي في البلاد، واعتبار هذا التحالف امتدادًا للتبعية الاستعمارية، لا سيما في أوساط الجيش والشباب. [46]
النخبة الجديدة: الجنرال تياني ومجلس الدفاع عن الوطن، جاء انقلاب 26 يوليو 2023 ليُعيد ترتيب موازين القوى الداخلية، حيث أطاح الحرس الرئاسي بنظام بازوم، وشكل المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. تُجسد هذه النخبة العسكرية انفصالًا حاسمًا عن النظام السابق، ورفضًا صريحًا للنفوذ الغربي، حيث بادرت بطرد السفير الفرنسي، وإلغاء اتفاقيات الدفاع، وإنهاء التعاون مع القوات الأمريكية، بما في ذلك إغلاق قاعدة أغاديز 201 التي تعد مركزًا استخباراتيًا محوريًا لواشنطن في إفريقيا.
تعتمد النخبة الجديدة على خطاب سيادي يمزج بين الدفاع عن الكرامة الوطنية، ورفض الهيمنة الغربية، وإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس أكثر استقلالية، كما نسقت مع حكومتي مالي وبوركينا فاسو في تشكيل تحالف دول الساحل، كجبهة مضادة للمنظومة الإقليمية التقليدية (الإيكواس). [47]
* التنافس الدولي وأثره على بنية السلطة والنخب
انسحاب فرنسي وأمريكي متدرج: منذ الانقلاب، اتخذت النيجر موقفًا تصادميًا تجاه الغرب. ففي البداية رفضت باريس الاعتراف بشرعية النظام الجديد، لكن سرعان ما اضطر الفرنسيون إلى سحب قواتهم البالغة 1500 جندي، وإغلاق قواعدهم في نيامي، بفعل الضغط الشعبي والسياسي. كما أعلنت واشنطن في مارس 2024 عن تعليق التعاون الأمني مؤقتًا، وبدأت مفاوضات لإعادة تقييم تمركزها في النيجر.
هذا الانكفاء الغربي أضعف النخب القديمة المرتبطة بتلك العواصم، وأفسح المجال أمام صعود نخب عسكرية وشعبية جديدة، ترى في القطيعة مع الغرب شرطًا ضروريًا لبناء سيادة وطنية فعلية.
روسيا والفيلق الإفريقي: في المقابل، بدأت روسيا في تعزيز علاقاتها العسكرية والدبلوماسية مع النيجر، عبر توقيع اتفاقيات تعاون أمني، وتقديم مساعدات تقنية في مجال مكافحة الإرهاب، وتدريب القوات الخاصة. وتشير تقارير استخباراتية إلى دخول عناصر من “الفيلق الإفريقي” – الامتداد الجديد لمجموعة فاغنر – للعمل في النيجر، خصوصًا في المناطق الحدودية القريبة من مالي وبوركينا فاسو.
كما استقبل وفد روسي رفيع في نيامي خلال صيف 2024، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتعليم، والدفاع، مما يؤكد رغبة النخبة الجديدة في تنويع الشراكات، والرهان على المحور الروسي كبديل عن المنظومة الغربية.
*إعادة هيكلة النظام السياسي: من الديمقراطية الانتخابية إلى الشرعية الثورية
إلغاء المؤسسات القائمة والتحضير لإطار دستوري جديد: قامت السلطة العسكرية الجديدة بحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وأعلنت عن بدء مشاورات وطنية لتأسيس نظام سياسي بديل “يعكس الإرادة الشعبية”. وقد طُرحت عدة سيناريوهات تشمل إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، وهيكلة إعلام الدولة، وإنشاء آليات بديلة لتمثيل المجتمع، بعيدًا عن الأحزاب التقليدية المرتبطة بالنخبة المدنية القديمة. [48]
الشرعية الثورية والشعبية كبديل عن الانتخابات: تسعى الحكومة العسكرية في النيجر إلى تثبيت شرعيتها عبر أدوات غير انتخابية، تشمل الدعم الشعبي في العاصمة، والتظاهر ضد فرنسا، والانخراط في خطاب المظلومية الاستعمارية. كما تستثمر في بناء هوية وطنية جديدة قائمة على المواجهة مع الغرب، والتقارب مع الحلفاء الجدد.
تُظهر الحالة النيجرية أن التنافس الدولي لم يعد مجرد عامل خارجي، بل أصبح قوة داخلية في تشكيل النخب وصياغة التحالفات. فبينما مثل الدعم الغربي في السابق ركيزة أساسية لشرعية الأنظمة المدنية، فإن التراجع الأمريكي والفرنسي أفسح المجال أمام نخب عسكرية جديدة تستثمر في القطيعة مع الغرب، وتستمد شرعيتها من خطاب التحرر والسيادة. وهكذا، باتت النيجر اليوم ساحة مركزية في حرب باردة جديدة تدور رحاها في غرب إفريقيا، حيث لم تعد الانتخابات ولا المساعدات التنموية هي أدوات الحكم، بل التحكم في التحالفات الاستراتيجية وتوظيف الفاعلين الدوليين في بناء السلطة.
ثالثًا: تداعيات التنافس الدولي في غرب إفريقيا
*التداعيات السياسية – تفكك النظام الإقليمي وصعود نظم هجينة
إضعاف المؤسسات الإقليمية والشرعية الانتخابية: أدى التنافس الدولي المتصاعد في غرب إفريقيا إلى تقويض فاعلية المؤسسات الإقليمية، وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس). فعقب سلسلة الانقلابات في مالي (2020، 2021)، غينيا (2021)، بوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، عجزت الإيكواس عن فرض إجراءات رادعة فعالة، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية، وتباين مواقف أعضائها، وكذلك بروز قوى داعمة للأنظمة العسكرية مثل روسيا، مما منح تلك الأنظمة هامشًا واسعًا للمناورة والمقاومة. [49]
صعود نخب عسكرية جديدة بخطاب سيادي مناهض للغرب: أدت التوازنات الدولية إلى تشجيع نخب عسكرية وسيادية جديدة على الصعود إلى الحكم، مستفيدة من الانسحاب النسبي للقوى الغربية وتصاعد الدعم الروسي والصيني. باتت هذه النخب تقدم نفسها كبديل للمنظومة الليبرالية المرتبطة بالانتخابات والغرب، وتعتمد شرعيتها على الخطاب المناهض للاستعمار، والانفصال عن شبكات النفوذ الفرنسي، والمطالبة باستعادة السيادة الوطنية.
المشهد السياسي الداخلي وتآكل الإجماع الوطني: التدخلات الدولية عززت حالة الاستقطاب السياسي الداخلي، حيث باتت النخب المحلية تصطف بناء على تحالفاتها الخارجية، مما أدى إلى تآكل مفهوم الدولة الوطنية الجامعة، وتعدد مراكز النفوذ. في بعض الدول، مثل مالي والنيجر، تراجع دور الأحزاب التقليدية، بينما برزت قوى جديدة مدعومة إما من دوائر روسية أو محسوبة على مشاريع صينية أو تركية. [50]
*التداعيات الاقتصادية – فرص جديدة مقابل هشاشة الاستقلال المالي
زيادة الاعتماد على الشركاء غير الغربيين في التمويل والاستثمار: ساهم التنافس الدولي في إعادة تشكيل الشراكات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. فبعد عقود من هيمنة فرنسا ومؤسسات التمويل الغربية، باتت الصين وروسيا وتركيا تقدم نفسها كشركاء بديلين من خلال القروض الميسرة، والمساعدات الغذائية، ومشروعات الطاقة والبنية التحتية. إلا أن هذا التحول لم يكن دائمًا دون كلفة، إذ ترافق في بعض الحالات مع ديون مرتفعة وشروط تفاوضية غير شفافة، خاصة في الشراكات مع بكين. [51]
تعميق التبعية الاقتصادية بنمط جديد: على الرغم من محاولة بعض الدول، مثل النيجر وبوركينا فاسو، فك الارتباط مع المنظومة الاقتصادية الغربية خصوصًا التابعة لفرنك CFA، فإنها اتجهت في المقابل نحو تبعية جديدة لأنظمة اقتصادية موازية لا تقل خطورة، تقوم على الاعتماد على استثمارات صينية أو عقود روسية في قطاعات حيوية كالطاقة والتعدين. ما زالت البنية الاقتصادية لغرب إفريقيا، في الغالب، غير قادرة على التفاوض من موقع الندية، مما يتركها عرضة لأزمات سيولة، أو ضغوط ديون، أو اعتماد مفرط على المانحين الجدد.
فرص للبنية التحتية والطاقة مقابل غياب استراتيجية تنموية متكاملة: من جهة أخرى، وفرت بعض الشراكات الدولية (خاصة الصينية) فرصًا غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية من طرق وسكك حديد وموانئ، كما دعمت روسيا ومؤسسات صينية مشاريع الطاقة المتجددة والموارد المعدنية (مثل الليثيوم والذهب واليورانيوم). إلا أن هذه الاستثمارات غالبًا ما تفتقر إلى التكامل الاقتصادي الوطني، وتُنفذ في عزلة عن الصناعات المحلية أو التوظيف الداخلي، مما يحد من أثرها التنموي طويل المدى. [52]
*التداعيات الأمنية – عسكرة المجال السياسي وتآكل سيادة الدولة
اتساع عسكرة السلطة وتنامي دور الجيوش: أحد أخطر آثار التنافس الدولي هو تحويل الجيوش إلى أدوات حكم مباشرة، خاصة في ظل الدعم الخارجي لأنظمة عسكرية مناهضة للديمقراطية. باتت العسكرة تُستخدم كوسيلة لبناء الشرعية، حيث تُبرر الحكومات العسكرية وجودها عبر خطاب مكافحة الإرهاب أو مقاومة النفوذ الغربي، وتستند في ذلك إلى دعم عسكري واستخباراتي من قوى مثل روسيا، أو في بعض الأحيان الصين وتركيا. [53]
تراجع فعالية الجيوش الوطنية أمام الجماعات المسلحة: ورغم التوسع في التعاون الأمني، فإن فعالية الجيوش الوطنية لم تتحسن بشكل كبير، لا سيما في مواجهة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود. فبعض الشراكات الجديدة (مثل الاعتماد على مجموعة فاغنر أو الفيلق الإفريقي) جاءت على حساب التنسيق الإقليمي، بل وفي بعض الأحيان فاقمت الانتهاكات، مما ساعد في تجنيد المزيد من السكان المحليين لصالح الجماعات المسلحة.
تعدد الفاعلين الأمنيين وتفكك السيادة الأمنية: أدى تنوع الشراكات الأمنية إلى تعدد مصادر القرار الأمني، مما أضعف من قدرة الدول على فرض سيطرة موحدة على أراضيها. ففي بعض الدول مثل مالي والنيجر، نجد قوات روسية، ومرتزقة، وجيوش محلية، وقبائل مسلحة، وتنظيمات جهادية تتقاسم النفوذ في جغرافيا معقدة، وهو ما يهدد بتفكك وحدة الدولة من الداخل. [54]
لقد عمق التنافس الدولي في غرب إفريقيا من هشاشة الدولة الوطنية، وخلق نمطًا جديدًا من الصراعات والسياسات يعتمد على استبدال الهيمنة الغربية بأنماط جديدة من النفوذ الخارجي، دون تحقيق استقلال فعلي أو تنمية مستدامة. فعلى الرغم من بعض المكاسب الظاهرة، فإن الواقع الإقليمي يشهد تفككًا متسارعًا في المؤسسات، وتنازعًا داخليًا على الشرعية، وتحولًا في طبيعة السلطة نحو نظم هجينة لا هي ديمقراطية ولا مستقرة. وبالتالي، فإن مستقبل المنطقة بات مرهونًا ليس فقط بالتوازنات الدولية، بل بقدرة شعوبها ونخبها الوطنية على استعادة زمام المبادرة، وبناء نموذج سيادي متوازن لا يقوم على الارتهان لقوة بعينها. [55]
رابعًا: السيناريوهات المستقبلية
تمثل التحولات السياسية الجارية في غرب أفريقيا منعطفًا حاسمًا يتوقف عليه مستقبل الإقليم، حيث تتنافس ثلاثة مسارات محتملة تختلف في فرص تحققها وفي ما تنطوي عليه من إمكانيات وتحديات. وتعتمد هذه السيناريوهات على المعطيات السياسية والأمنية والاجتماعية والجيواستراتيجية التي تشكل المشهد الحالي.
السيناريو الأول: اللا استقرار المركب وتفاقم التفكك الإقليمي
في هذا السيناريو، تمضي المنطقة نحو مسار من الفوضى الأمنية والجمود السياسي، نتيجة تصاعد التنافس الدولي غير المنضبط، وغياب قدرة النخب المحلية على بناء توازنات داخلية مستقرة. إذ يؤدي توغل الشركات العسكرية الخاصة مثل “فاغنر”، وتراجع فعالية الإيكواس، إلى تفكك منظومة الردع الإقليمي، مع اتساع نطاق الجماعات المسلحة العابرة للحدود. كما يؤدي هذا التنافس إلى إنتاج نخب سلطوية جديدة موالية لقوى دولية محددة، دون قدرة فعلية على ممارسة الحكم الرشيد، مما يعمق فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. وبهذا، تتحول غرب إفريقيا إلى مجال نفوذ متنازع عليه، تسوده الولاءات العسكرية والمؤسسات الضعيفة، وتنتج فيه الأزمات الاجتماعية موجات مستمرة من النزوح والهجرة.[56]
السيناريو الثاني: توازن نفوذ هش ونشوء نظم هجينة
يرجح هذا السيناريو مسارًا وسطًا تتحقق فيه تسويات ضمنية بين القوى الدولية الكبرى (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي)، عبر تقاسم النفوذ والمصالح في الإقليم بدلًا من التصادم المباشر. وتظهر في هذا السياق حكومات انتقالية أو نظم هجينة تجمع بين الطابع العسكري والمدني، وتحظى بدعم تقني وتمويلي مقابل التزام نسبي بالاستقرار والأمن. كما تنشط المبادرات التنموية والبنية التحتية، لا سيما المدعومة من الصين، في ظل قبول غربي ضمني بشرعية الأمر الواقع. ورغم هذا، يبقى هذا التوازن هشًا، نظرًا لغياب إصلاحات جوهرية في نظم الحكم، واستمرار الانقسامات الداخلية، مما يجعل استدامة الاستقرار مرهونة بتوازنات خارجية أكثر من كونها نابعة من إرادة وطنية.[57]
يمثل هذا السيناريو الأكثر واقعية على المدى القريب، نظرًا لتقاطع عدد من العوامل الموضوعية التي تجعله المرجح بين السيناريوهات المطروحة. فالدول الغربية، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة، لم تعد تمتلك أدوات الهيمنة الكاملة كما في السابق، بينما لا تزال روسيا والصين تفتقران إلى بنية نفوذ راسخة ومستدامة، مما يدفع باتجاه توازن قوى هش يتيح لكافة الأطراف موطئ قدم محدود دون قدرة طرف واحد على الهيمنة الشاملة.
في هذا السياق، تتشكل نخب هجينة داخل الدول الإفريقية، تجمع بين الولاء العسكري والمشروعية الشعبية المؤقتة، وتحاول التنسيق مع أكثر من فاعل دولي لضمان التمويل والحماية، مما يؤدي إلى نظم سياسية انتقالية غير مكتملة. ويُتوقع أن تستمر هذه الوضعية في ظل غياب مشروع إقليمي موحد أو عقد اجتماعي وطني جامع داخل الدول المعنية.
ورغم أن هذا السيناريو يوفر نوعًا من الاستقرار الأدنى، إلا أنه يُبقي على هشاشة بنيوية في مؤسسات الدولة، ويُرسخ التبعية المتبادلة بين النخب الحاكمة والفاعلين الدوليين، مما يجعل أي تحسن حقيقي مرهونًا بتغير داخلي عميق لم تتهيأ شروطه بعد
السيناريو الثالث: إعادة التشكل الإقليمي واستعادة السيادة الوطنية
يمثل هذا السيناريو مسارًا إصلاحيًا ينهض من الداخل، حيث تتصاعد الضغوط الشعبية والنقابية والمدنية لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإنهاء الهيمنة الدولية على القرار الوطني. تبدأ بعض الدول، مثل بوركينا فاسو أو النيجر، بتجارب انتقالية جديدة تستند إلى تحالف مدني-عسكري إصلاحي، وتسعى لتحييد التأثيرات الدولية السلبية، مع إعادة تفعيل مؤسسات الحكم المحلية. كما يُعاد إحياء دور “الإيكواس” كفاعل تكاملي لا كأداة عقابية، وتُطلق مبادرات اقتصادية تكاملية تقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي المشروط. هذا السيناريو، وإن بدا بعيد المدى، إلا أنه مرهون بنضج الوعي السياسي المحلي، وظهور قيادات جديدة تتجاوز ثنائية التبعية والانقلاب، وتطرح مشروعًا وطنياً سياديًا جامعًا.[58]
ختامًا، تكشف هذه الدراسة، من خلال تتبع التنافس الدولي وما أثر عليه في التحولات السياسية العميقة في دول غرب إفريقيا، عن لحظة مفصلية في تاريخ الإقليم، تنبئ بانهيار البنية السياسية التي أرستها مرحلة ما بعد الاستعمار، وصعود ديناميكيات جديدة تعيد رسم خريطة السيادة، والتحالفات، والمجال الجيوسياسي.
لقد مثلت الانقلابات العسكرية المتتابعة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ثمرة مباشرة لتراكمات تاريخية من الفشل التنموي، والارتهان السياسي، والتدخل الخارجي، لكنها – في الوقت ذاته – لم تكن مجرد رد فعل ظرفي، بل تعبير عن إرادة إعادة هندسة مفهوم الدولة والتحالفات وفق منطق مغاير. في هذا السياق، لا يمكن فصل الحضور الروسي أو الصيني عن حالة الفراغ الاستراتيجي التي خلفها تراجع النفوذ الفرنسي، ولا عن إخفاق النموذج الليبرالي الغربي في معالجة التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات الإفريقية.
لقد تبين أن السردية الغربية حول “الديمقراطية كأداة للاستقرار” لم تجد لها ترجمة عملية في الواقع الإفريقي، إذ ظلت الانتخابات تُجرى في بيئة من الفقر والتهميش والفساد، بينما تحولت مكافحة الإرهاب إلى مشروع عسكري خارجي مفروض، لم يسفر سوى عن توسع الفوضى الأمنية. وضمن هذا الإطار، أصبح التنافس الدولي في المنطقة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد صراعًا بين قوى كبرى فحسب، بل أداة تستخدمها النخب المحلية لإعادة ترتيب علاقاتها وتحالفاتها، إما لتعزيز الشرعية الجديدة أو لضمان البقاء السياسي.
في المقابل، كشفت حالات مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن الحديث عن التحرر من الاستعمار الجديد لا يكتمل دون مشروع داخلي يعيد بناء مؤسسات الدولة، ويحقق تنمية اقتصادية قائمة على الإنتاج الوطني، لا على الارتهان الريعي أو التمويل الخارجي. كما أن بروز تحالف الساحل كإطار بديل عن الإيكواس يشير إلى اتجاه نحو تفكيك النظام الإقليمي التقليدي، بما ينذر بإعادة تشكل المنظومة الأمنية والسياسية في غرب إفريقيا على أسس تتجاوز النموذج الليبرالي والمؤسسي الموروث عن فترة ما بعد الاستقلال.
إن الغرب الإفريقي اليوم يقف على عتبة نظام إقليمي جديد، تتجاذبه رؤيتان: الأولى تتجه نحو ترسيخ الاستقلال الفعلي وبناء شراكات متعددة قائمة على المصالح المتبادلة، والثانية قد تعيد إنتاج التبعية، وإن تحت عناوين جديدة. وبين هاتين الرؤيتين، يكمن التحدي الأكبر في مدى قدرة الدول الإفريقية على تحويل لحظة السيادة إلى مشروع مؤسسي مستدام، يحصنها من التدخلات الخارجية، ويمنح شعوبها فرصة للعيش في فضاء سياسي واقتصادي عادل ومتماسك.
المصادر:
[1] د/ أحمد علي سالم، التحولات السياسية في غرب إفريقيا: مداخل للفهم، أغسطس 2024، مركز الحضارة للدراسات والبحوث.
https://www.researchgate.net/publication/383679957_althwlat_alsyasyt_fy_ghrb_afryqya_mdakhl_llfhm
[2] حسن سكران، تداعيات الوجود الفرنسي على النشاط التجاري في غرب أفريقيا، أغسطس 2023، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، المملكة المغربية.
https://journals.ekb.eg/article_341155_0556c061dd94a2d547b5c191ef2fb7b1.pdf
[3] د/ فلاح خلف كاظم، النظم السياسية في قارة أفريقيا المرحلة الثالثة، 2023، الجامعة المستنصرية.
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/11/11_2023_01_17!09_28_29_PM.pdf
[4] دعاء عبدالنبي حامد، نظرية ما بعد الاستعمار في ظل تداعيات العولمة: دراسة فلسفية تحليلية من منظور إفريقي، نُشر في 3 يونيو 2024، قراءات أفريقية.
[5] د/ محمد عبدالكريم أحمد، قراءة في كتاب “الدين والسياسة في إفريقيا”..علامة جديدة في طريق الدراسات الإفريقية، نُشر في 15 فبراير 2024، قراءات أفريقية.
[6] د/ محمد عاشور مهدي، الإسلام في أفريقيا من الإرث الاستعماري إلى تحديات العولمة، نُشر في 11 سبتمبر 2016، مركز الحضارة للدراسات والبحوث.
[7] ملخص بحوث الكتاب “142” الحركات الإرهابية في أفريقيا: الأبعاد والاستراتيجيات، نُشر في 6 سبتمبر 2020، مركز المسبار للدراسات والبحوث.
[8] محمود سامح همام، الصراعات الجيوسياسية في كونفدرالية دول الساحل: تقييم استراتيجي لدور الفاعلين الدوليين، نُشر في 19 سبتمبر 2024، المركز الديمقراطي العربي.
[9] ألكسندر تشيكاشيف، ترجمة: مروة أحمد عبدالحليم، نُشر في 23 أبريل 2025، المجلس الروسي للشؤون الدولية.
[10] التنافس الدولي في أفريقيا: التحولات والآفاق، نُشر في 12 يناير 2024، الملف المصري، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/News/21283.aspx
[11] د/جيهان عبدالسلام عباس، ثلاثية التنافس الاقتصادي العالمي في إفريقيا، نُشر في 16 يناير 2025، قراءات أفريقية.
[12] President Macron says France will end its military presence in Niger, pull its ambassador after coup, 25 Sep 2023, APNEWS.
https://apnews.com/article/france-niger-military-ambassador-coup-0e866135cd49849ba4eb4426346bffd5
[13] Orano halts uranium output at Niger’s Arlit mine amid financial strain, 24 Oct 2024, rFi.
[14] For West African juntas, CFA franc pits sovereignty against expediency, 13 Feb 2024, Reuters.
[15] ‘Time to move on’: France faces gradual decline of influence in Africa, 2 Jun 2025, france24.
https://www.france24.com/en/africa/20250102-france-faces-gradual-decline-of-influence-in-africa
[16] د/أميرة محمد عبدالحليم، التنافس الدولي على أفريقيا بعد مرور عام على الحرب الروسية-الأوكرانية، نُشر في 27 فبراير 2023، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/News/17822.aspx
[17] Africa, the new frontline between the West and Russia.
[18] Russia’s Wagner mercenaries are leading a campaign of terror in Mali, 11 Mar 2025, Washington Post.
https://www.washingtonpost.com/world/2025/03/11/russia-wagner-mali-mercenaries-putin
[19] ايهاب عياد، “الأمن الجيوسياسى للقرن الأفريقى وديناميات القوى الفاعلة” “الآفاق المستقبلية لإعادة الصياغة الجيوسياسية “، مجلة السياسة والاقتصاد.
https://jocu.journals.ekb.eg/article_181406.html
[20] UN calls for Mali to probe alleged executions by army and Russian mercenaries, 1 May 2025, APNEWS.
[21] Russia, Mali discuss joint lithium and solar projects, 26 Sep 2024, Reuters.
https://www.reuters.com/business/energy/russia-mali-discuss-joint-lithium-solar-projects-2024-09-26
[22] Decoding Russia’s Economic Engagements in Africa, 6 Jan 2023, Africa center.
[23] عرض حول تطور التعاون الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا، نُشر في 27 فبراير 2025، الجزيرة.
[24] Second Russia-Africa Summit ends with commitments towards cooperation across key sectors, 31 July 2023, peoples dispatch.
[25] Russia-Africa summit fails to deliver concrete results, CHATHAM House.
https://www.chathamhouse.org/2023/08/russia-africa-summit-fails-deliver-concrete-results
[26] قواعد أمريكية في غرب أفريقيا ضمن استراتيجية واشنطن لتثبيت نفوذها في القارة، نُشر في يناير 2024.
[27] كيف تتجه الولايات المُتحدة لتعزيز تموضعها في غرب إفريقيا؟، نُشر في 29 سبتمبر 2024، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
[28] د/ محمد عبدالكريم أحمد، الصين تُعزّز وجودها في غرب إفريقيا: بنين وما بعدها!، نُشر في 28 أغسطس 2024، قراءات أفريقية.
[29] Nigeria approves $652 million China Exim Bank road finance package, 6 May 2025, Retuers.
[30] The Belt and Road Initiative: Impact on Ghana’s development, IPRCC.
https://www.iprcc.org/article/4JW4Led4QGh?utm
[31] China’s “Belt and Road Initiative” Arrives in West Africa.
https://maritime-executive.com/editorials/china-s-belt-and-road-initiative-arrives-in-west-africa
[32] The Belt and Road Initiative: Impact on Ghana’s development, brlc.
https://www.brlc.org.cn/content/content_8797132.html?utm
[33] China’s Belt and Road Initiative: A Curse or Blessing for African Countries, IRPJ.
[34] منظمة إيكواس تدعو الجزائر ومالي إلى الحوار والتهدئة، نُشر في 10 أبريل 2025، الجزيرة نت.
[35] نيجيريا.. من “حرب بيافرا” إلى أكبر اقتصاد في أفريقيا، نُشر في 24 أغسطس 2024، الجزيرة نت.
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2012/1/16/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
[36] د/ أحمد عسكر، لماذا تهتم الصين بمنطقة غرب أفريقيا؟، نُشر في 18 سبتمبر 2022، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/News/17612.aspx
[37] استراتيجية الانفتاح المغربي في منطقة غرب افريقيا، نُشر في 17 أكتوبر 2017، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
[38] مالي: النظام السياسي، قراءات أفريقية.
[39] د/ حمدي عبدالرحمن حسن، معضلة النيجر: لماذا تخسر فرنسا نفوذها في غرب أفريقيا، نُشر في 9 أغسطس 2023، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/News/20971.aspx
[40] عاصم محمد حسن، أفريقيا في عصر التحول الإجتماعي، 2023.
[41] د/ حمدي عبدالرحمن حسن، حوارات أفريقية: كيف نفهم أفريقيا؟، 11 يناير 2023، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/News/17736.aspx
[42] د/ شيماء محي الدين، تحولات الاستراتيجية الروسية في أفريقيا: من الرابح؟، نُشر في 13 يوليو 2021، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.
[43] بوركينا فاسو تنهي اتفاقا عسكريا مع فرنسا عمره 62 عاما، نُشر في 2 مارس 2023، سكاي نيوز عربية.
[44] بوركينا فاسو تنهي التعاون العسكري مع فرنسا… هل هي القطيعة؟، نُشر في 2 مارس 2023، صحيفة الشرق الأوسط.
[45] بوركينا فاسو تحتفل بانتهاء عمليات فرنسا على أراضيها، نُشر في 20 فبراير 2023، العربية.
[46] بهاء محمود، الصراع الدولي في النيجر، نُشر في 26 أغسطس 2023، قراءات أفريقية.
[47] انقلاب النيجر: اختبار للتحالفات الإقليمية وانكشاف للمصالح الدولية، نُشر في أغسطس 2023، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/Media/Malafat/Niger-Final.pdf
[48] د/ حمدي عبدالرحمن حسن، معضلة النيجر: هل انتهت إمبراطورية الغرب في أفريقيا؟، نُشر في 23 مارس 2024، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
https://acpss.ahram.org.eg/News/21143.aspx
[49] د/ أحمد على سالم، التحولات السياسية في غرب إفريقيا: مداخل للفهم، نُشر في 26 أغسطس 2024، مركز الحضارة للدراسات والبحوث.
[50] حسناء بهاء رشاد، الاستعمار الأوروبي وجذور التحديات النظامية للدول الإفريقية، نُشر في 4 مايو 2025، قراءات أفريقية.
[51] نسرين الصباحي، مُعضلة “الأمن والديمقراطية” في غرب إفريقيا.. بوركينافاسو نموذجًا، نُشر في 10 مارس 2022، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
[52] أحمد صدقي اليماني، الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وأثره الإقليمي والدولي، نُشر في 28 أبريل 2025، قراءات أفريقية.
[53] انقسام إقليمي.. نهاية عضوية ثلاث دول في الإيكواس، نُشر في 29 يناير 2025.
[54] النفوذ الروسي في إفريقيا: الدوافع والإستراتيجية والأدوات، نُشر في 30 يناير 2024، أبعاد للدراسات الاستراتيجية.
[55] الاتجاهات الحاكمة لمستقبل الانقلابات في الساحل الإفريقي، نُشر في 2 أكتوبر 2023، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
[56] د/ حمدي عبدالرحمن، استشراف الاتجاهات الكبرى في الساحل الإفريقي 2024، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
[57] معضلة “الإيكواس”.. خارطة طريق للتكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، نُشر في 6 أكتوبر 2024، قراءات أفريقية.
[58]د/ خيري عبدالرازق جاسم، مشكلة الحكم في ساحل العاج، دراسات دولية.
file:///C:/Users/hp/Downloads/jcis,+63-82.pdf
باحث في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب