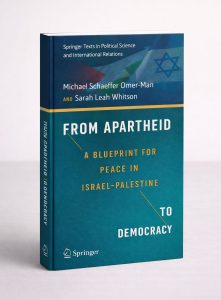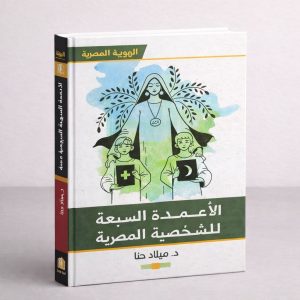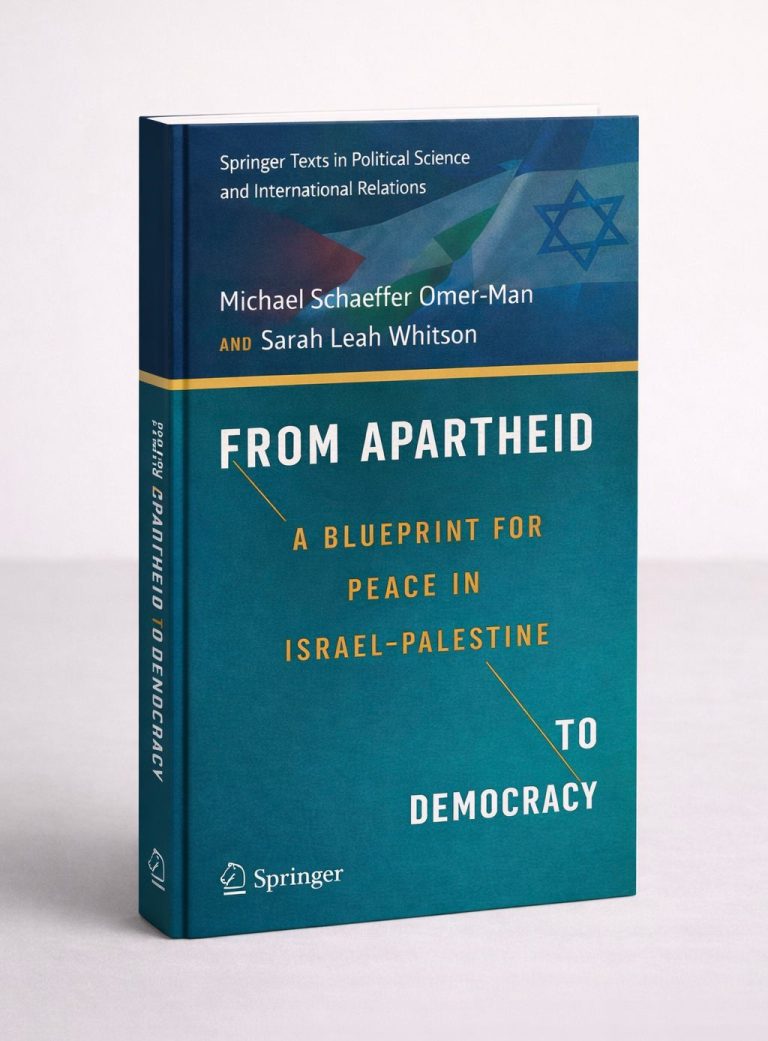تُعد الأزمة السياسية والأمنية في ميانمار إحدى أكثر الأزمات تعقيدًا في جنوب شرق آسيا خلال العقد الأخير، نظرًا لتشابك أبعادها العرقية والسياسية والمؤسساتية، وتعدد الفاعلين المنخرطين فيها محليًا وإقليميًا ودوليًا. فمنذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش في فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي، دخلت البلاد في مرحلة من الفوضى المزمنة، تجلت في تصاعد أعمال العنف، وانهيار مؤسسات الدولة، واتساع رقعة المقاومة الشعبية والجماعات المسلحة ضد سلطة المجلس العسكري الحاكم[1]، لقد أعاد هذا التحول السياسي البلاد إلى نقطة البداية مُحبطًا المسار الديمقراطي الهش الذي بدأ في العقد الثاني من الألفية وآثار موجة واسعة من الاحتجاجات السلمية التي سرعان ما واجهت قمعًا دمويًا دفع بالكثيرين إلى حمل السلاح أو الانخراط في جبهات المعارضة المسلحة. ومقابل ذلك، دخلت الجماعات العرقية المسلحة التي تحمل مطالب تاريخية بالاستقلال الذاتي على خط المواجهة مما وسع دائرة النزاع وجعل فرص التوصل إلى تسوية شاملة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.[2]
وفي ظل هذا السياق المأزوم، ظهرت مبادرات عدة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول سياسية، سواء من جانب الأمم المتحدة أو من خلال الوساطات الإقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان). غير أن هذه الجهود ما زالت تصطدم بجملة من التحديات الجوهرية تتعلق بعدم اعتراف الأطراف ببعضها البعض وغياب الإرادة السياسية وتضارب الأجندات بين القوى الدولية ذات التأثير داخل ميانمار.[3]
انطلاقًا من ذلك، يسعى هذا المقال إلى تحليل المشهد الراهن في ميانمار، من خلال تتبع جذور الأزمة، ورصد تطوراتها الميدانية والسياسية، والوقوف على مواقف الأطراف الداخلية والخارجية، بهدف تقييم فرص نجاح اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية والعرقية، في ضوء تعقيدات الواقع الداخلي والتوازنات الإقليمية والدولية المؤثرة في مستقبل البلاد.
أولًا: الخلفية السياسية للأزمة الراهنة في ميانمار
تمتد جذور الصراع السياسي في ميانمار إلى عقود طويلة من الحكم العسكري والاستبداد السياسي، حيث سيطر الجيش على مقاليد الحكم منذ عام 1962 عقب انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية آنذاك. ومنذ ذلك الحين، عاشت البلاد تحت أنظمة عسكرية مغلقة عزلت ميانمار عن العالم الخارجي وأقصت القوى المدنية والمعارضة السياسية من المشهد العام، كما قمعت التعددية السياسية والعرقية وفرضت رقابة صارمة على الحريات العامة. وفي هذا السياق، نشأت المعارضة المدنية بقيادة “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” التي ترأستها أونغ سان سو تشي، والتي أصبحت رمزًا للمقاومة السلمية والدعوة إلى الانتقال الديمقراطي، خاصة بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية عام 1990، وهو الفوز الذي لم يعترف به المجلس العسكري في حينه.[4]
ظل الجيش الميانماري يحتفظ بنفوذ واسع داخل بنية الدولة حتى بعد بدء الانتقال السياسي النسبي في عام 2011، حين سمح بإجراء انتخابات تعددية أسفرت عن صعود الرابطة الوطنية من جديد، ثم تولي أونغ سان سو تشي منصب مستشارة الدولة في 2016. إلا أن هذا التحول لم يكن انتقالًا ديمقراطيًا حقيقيًا، بل كان محكومًا بتوازنات دقيقة أبقت للجيش دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية، حيث يسيطر دستوريًا على ثلاث وزارات سيادية (الدفاع، والداخلية، وشؤون الحدود)، كما يملك ربع مقاعد البرلمان بحكم القانون، مما جعله قادرًا على تعطيل أي تعديل دستوري قد يقلص من نفوذه.[5]
في فبراير 2021، أقدم الجيش على تنفيذ انقلاب عسكري جديد أطاح بالحكومة المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي، مبررًا ذلك بوجود “تزوير في الانتخابات العامة” التي جرت أواخر 2020، وهي الذريعة التي رفضها المجتمع الدولي واعتبرها وسيلة لتكريس سلطة الجيش وإفشال المسار الديمقراطي. قطعت بذلك المرحلة الانتقالية التي كانت تسعى إلى بناء نظام مدني، ودخلت البلاد في موجة من الاضطرابات السياسية والأمنية الحادة، وسط احتجاجات شعبية واسعة ترافقت مع قمع دموي خلف آلاف القتلى والمعتقلين، وأدى إلى تصاعد حركات المقاومة المسلحة في مناطق متعددة.[6]
أما بالنسبة لموقف المجتمع الدولي، فقد قوبل الانقلاب العسكري بإدانات واسعة من دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللتين فرضتا عقوبات اقتصادية وسياسية على قادة الجيش وبعض مؤسساته. كما دعمت الأمم المتحدة جهود الوساطة السياسية، دون أن تتمكن من فرض ضغوط فاعلة بسبب الانقسامات في مجلس الأمن، ولا سيما موقف الصين وروسيا اللتين اعترضتا على اتخاذ خطوات حاسمة ضد الجيش. في المقابل، تبنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) خطة من خمس نقاط تهدف إلى وقف العنف وبدء حوار سياسي شامل، لكن التنفيذ الفعلي لهذه الخطة ظل محدودًا بسبب غياب التوافق بين أعضاء المنظمة من جهة، ورفض المجلس العسكري الامتثال لشروط الحوار من جهة أخرى[7]، وهكذا شكل الانقلاب العسكري محطة مفصلية أعادت البلاد إلى المربع الأول، وأدخلت ميانمار في أزمة مركبة لا تقتصر على التنافس بين السلطة والمعارضة، بل تتشابك فيها الأبعاد السياسية والعرقية والإنسانية، ما يجعل من تسويتها تحديًا معقدًا في ظل المعادلات المحلية والدولية الراهنة.[8]
ويُفسر تباين المواقف الدولية من الأزمة في ميانمار في ضوء المصالح الاستراتيجية والتوازنات الجيوسياسية التي تحكم علاقات القوى الكبرى بالمنطقة. إذ دعمت كل من روسيا والصين المجلس العسكري، انطلاقًا من مواقف مبدئية ترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، لكنها في الوقت ذاته تنطلق من حسابات تتعلق بالمصالح الاقتصادية والعسكرية. فالصين ترى في جيش ميانمار شريكًا ضامنًا لمشاريعها الحيوية ضمن مبادرة الحزام والطريق، لا سيما في البنية التحتية والطاقة، وتخشى من صعود حكومة مدنية قد تعيد النظر في الاتفاقيات الموقعة أو تفتح المجال لتقارب أوسع مع الغرب. أما روسيا، فقد وجدت في عزلة ميانمار فرصة لتعزيز نفوذها العسكري، عبر بيع الأسلحة وتوقيع اتفاقات أمنية مع المجلس العسكري، وهو ما يُعزز موقعها في منطقة تواجه فيها منافسة شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها.[9]
في المقابل، تبنت الولايات المتحدة والدول الغربية موقفًا داعمًا للحكومة المدنية المنتخبة، وعبرت عن تضامنها مع الشعب الميانماري من خلال الاعتراف الرمزي بحكومة الوحدة الوطنية المعارضة، وفرض عقوبات اقتصادية على قادة الجيش ومؤسساته التجارية. كما صرحت الإدارة الأمريكية، وكذلك رئيسة مجلس النواب حينها نانسي بيلوسي، عن دعمهم لأونغ سان سو تشي بوصفها رمزًا للديمقراطية والمقاومة السلمية. ويعكس هذا الدعم رغبة أمريكية في احتواء النفوذ الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا، ودفع مسار التحول الديمقراطي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز نموذج الحكم الليبرالي في مواجهة النماذج السلطوية المدعومة من بكين وموسكو.[10]
ثانيًا: خارطة القوى المتصارعة داخل ميانمار
يشهد الوضع الداخلي في ميانمار حالة من الانقسام الحاد والتعدد في الفاعلين السياسيين والعسكريين، حيث لم يعد الصراع مقتصرًا على ثنائية تقليدية بين سلطة ومعارضة، بل اتسع ليشمل مجموعة من الأطراف ذات المصالح المتباينة، ما يجعل من الأزمة أكثر تعقيدًا وانقسامًا، ويقلل من فرص الوصول إلى توافق سياسي شامل.[11] في مقدمة هذه القوى يأتي المجلس العسكري الحاكم، الذي يمثل امتدادًا للمؤسسة العسكرية التاريخية في البلاد، والمعروفة محليًا باسم “تاتماداو”. يتكون هذا المجلس من كبار الجنرالات الذين تولوا زمام السلطة عقب الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وعلى رأسهم الجنرال “مين أونغ هلاينغ”، الذي أصبح فعليًا رئيس الدولة وقائدًا أعلى للقوات المسلحة. يبرر المجلس العسكري استيلائه على السلطة بحجج تتعلق بحماية الاستقرار والتصدي لتزوير انتخابي، لكنه في الواقع يسعى إلى الحفاظ على الامتيازات السياسية والاقتصادية التي راكمها الجيش طيلة العقود الماضية، بما في ذلك سيطرته على عدد من الشركات الكبرى، واحتفاظه بنفوذ واسع في مؤسسات الدولة. ورغم محاولاته إضفاء شرعية سياسية عبر تعيين حكومة مدنية موالية، فإن المجلس يفتقر إلى القبول الشعبي الواسع، ويُتهم داخليًا وخارجيًا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم قتل جماعي واعتقال تعسفي وقصف مناطق مدنية.[12]
ويتركز الدعم الخارجي للمجلس العسكري في شقين رئيسيين:
- دعم عسكري روسي مباشر يوفر للمجلس أدوات القوة اللازمة لمواصلة القمع والسيطرة.
- دعم صيني اقتصادي سياسي غير مباشر يحمي المصالح الصينية ويمنع عزلة كاملة للجيش.
هذا الدعم، وإن كان لا يمنح المجلس شرعية دولية، إلا أنه يطيل من عمره السياسي والعسكري، ويُضعف فعالية العقوبات الغربية، ويعقد فرص التوصل إلى حل سياسي شامل.
في الجهة المقابلة، تشكلت حكومة الوحدة الوطنية (NUG) ككيان معارض يعتبر نفسه الممثل الشرعي للشعب الميانماري. أعلنت هذه الحكومة في أبريل 2021 من قبل نواب منتخبين تم إقصاؤهم من قبل المجلس العسكري، بالتعاون مع نشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن الأقليات العرقية. تضم NUG مزيجًا من السياسيين المحسوبين على الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالإضافة إلى شخصيات تمثل جماعات عرقية مختلفة. وقد لاقت هذه الحكومة دعمًا شعبيًا واسعًا داخل ميانمار، خاصة بين فئات الشباب والناشطين المناهضين للانقلاب، كما حصلت على اعتراف رمزي من بعض الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، رغم أنها لا تسيطر على مؤسسات رسمية أو أراضي واسعة. وتسعى NUG إلى بناء تحالفات ميدانية مع الجماعات المسلحة العرقية، وتدير ذراعًا عسكريًا يُعرف باسم قوة الدفاع الشعبي (PDF) التي تنشط في العديد من المناطق وتخوض عمليات ضد الجيش النظامي.[13] وتحظى حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار بدعم سياسي وإعلامي من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، إضافة إلى تأييد رمزي من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
أما الطرف الثالث في خارطة الصراع، فيتمثل في الجماعات المسلحة العرقية، وهي مجموعات عسكرية تنتمي إلى أقليات قومية تعيش في المناطق الحدودية، مثل “الكاشين”، و”الشان”، و”الراخين”، و”الكارين”، وغيرها. وهذه الجماعات لها تاريخ طويل من التمرد على السلطة المركزية، يعود في بعض الأحيان إلى عقود ماضية، وكانت في كثير من الفترات تخوض مفاوضات سلام متقطعة مع الحكومات المختلفة دون نتائج دائمة. أبرز هذه الجماعات تشمل جيش استقلال كاشين (KIA) في الشمال، وجيش أراكان (AA) في الغرب، واتحاد كارين الوطني (KNU) في الشرق، وهي جماعات تمتلك تسليحًا جيدًا، وتسيطر على أراضي واسعة، ولها إدارات محلية وشبكات دعم لوجستي. منذ الانقلاب العسكري، ازداد التنسيق بين هذه الجماعات وحكومة الوحدة الوطنية، حيث شكلت نوعًا من التحالف الميداني ضد المجلس العسكري، وشاركت في عمليات مسلحة متزامنة شملت كمائن، وهجمات على قواعد عسكرية، وقطع خطوط الإمداد، ما أضعف من سيطرة الجيش في بعض المناطق.[14] كما تحصل الجماعات المسلحة العرقية في ميانمار على دعم متنوع يشمل مصادر محلية وإقليمية غير رسمية، وتحديدًا من الصين عبر قنوات غير حكومية، كما يُقال أن بعض هذه الجماعات تتلقى تمويلًا من تجارة الموارد الطبيعية (كالذهب والأخشاب والمخدرات) وتبرعات من الشتات العرقي، إضافة إلى تنسيق ميداني ودعم لوجستي من حكومة الوحدة الوطنية منذ الانقلاب.
ويُفهم دور الجماعات المسلحة العرقية بشكل أعمق من خلال النظر إلى التركيبة العرقية المعقدة في ميانمار، حيث يتكون المجتمع من أكثر من 135 مجموعة عرقية معترف بها رسميًا. وتُشكل مجموعة البامار (Bamar) الأغلبية السكانية، إذ تمثل نحو 68% من السكان، وتتركز بشكل رئيسي في وسط البلاد، وهي الجماعة التي ينتمي إليها معظم قادة الجيش والنخبة الحاكمة. في المقابل، تنتشر الأقليات العرقية في المناطق الطرفية والحدودية، وتتمتع بعضها بهوية ثقافية ولغوية ودينية مميزة، ما عمق شعورها بالتهميش السياسي والاقتصادي من قبل الدولة المركزية.
من أبرز هذه الأقليات:
- الكاشين في شمال البلاد، وتُعد من أقدم الجماعات المسلحة، ويمثلها جيش استقلال كاشين (KIA).
- الراخين (أراكان) غربًا، ويمثلهم جيش أراكان (AA)، وهو من أكثر الجماعات تطورًا عسكريًا.
- الكارين في الشرق والجنوب الشرقي، الذين ينشطون ضمن اتحاد كارين الوطني (KNU).
- الشان في الشمال الشرقي، ويمثلهم عدد من الفصائل أبرزها جيش ولاية شان الجنوبية.
- الكايا والمون وتشين، وهم أيضًا جزء من الشبكة المسلحة العرقية، وإن كانت مشاركتهم في القتال متفاوتة من حيث الحجم والتأثير.
تُطالب معظم هذه الجماعات منذ عقود بحكم ذاتي أو بنظام فيدرالي يضمن لها حقوقًا سياسية وثقافية واقتصادية، وقد تعززت هذه المطالب بعد الانقلاب، في ظل شعورها بأن عودة الحكم العسكري تعني استمرار السياسات التمييزية والإقصائية. ولهذا، فإن كثيرًا من هذه الجماعات لا تنظر إلى الصراع الحالي على أنه فقط مواجهة مع الجيش، بل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل طبيعة الدولة الميانمارية على أسس أكثر عدالة وتوازنًا بين المركز والأطراف.[15]
إن تشابك أدوار هذه القوى المختلفة داخل ميانمار لا يعكس فقط تعقيد المشهد الداخلي، بل يُظهر أيضًا صعوبة الوصول إلى حل سياسي شامل، فكل طرف يمتلك أجندته الخاصة، وقاعدته الداعمة، ومستوى معينًا من القوة والتأثير. وبينما يسعى المجلس العسكري إلى الحفاظ على وحدة الدولة وفق مفهومه الخاص، تطرح الجماعات العرقية مطالب بالحكم الذاتي الفيدرالي، وتعمل حكومة NUG على بناء نموذج بديل للدولة يعتمد على التعددية والديمقراطية. هذا التعدد في الفاعلين، واختلاف الرؤى حول شكل الدولة المستقبلية، يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود التفاوض ووقف إطلاق النار في ميانمار.[16]
ثالثًا: التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة
تسببت الأزمة السياسية والصراع المسلح في ميانمار منذ انقلاب فبراير 2021 في كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة، انعكست آثارها العميقة على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين، وتدهورت معها أوضاع حقوق الإنسان ومستوى المعيشة والخدمات العامة بشكل غير مسبوق منذ عقود. فقد تحولت البلاد إلى ساحة نزاع داخلي مفتوح، أدت فيه المواجهات العسكرية والانفلات الأمني إلى تقويض البنية الاجتماعية والاقتصادية وخلق أزمات مركبة تهدد استقرار الدولة وتضعف فرص التعافي في المدى القريب والمتوسط.[17]
في الجانب الإنساني، أدت حملة القمع التي شنها المجلس العسكري ضد المعارضين، والمواجهات المسلحة المتواصلة مع قوات الدفاع الشعبي والجماعات العرقية المسلحة، إلى ارتفاع حاد في أعداد القتلى والنازحين. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 5000 مدني منذ بدء الأزمة، بينهم مئات من النساء والأطفال، بينما يتجاوز عدد المعتقلين السياسيين 20 ألفًا، كثير منهم في ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية. وعلى صعيد النزوح، تشير التقديرات إلى أن نحو 2.8 مليون شخص قد أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب القتال والقصف الجوي، وقد لجأ معظمهم إلى المناطق الجبلية أو الحدودية، حيث تنعدم الخدمات الأساسية. كما فر عشرات الآلاف عبر الحدود إلى الدول المجاورة، خاصة تايلاند والهند وبنغلاديش، مما زاد من الضغط الإنساني في تلك الدول وأثار مخاوف أمنية إقليمية.[18]
إلى جانب الأزمة الإنسانية، يواجه الاقتصاد الميانماري انهيارًا متسارعًا، نتيجة تعدد عوامل داخلية وخارجية، أبرزها حالة عدم الاستقرار السياسي، وفرض العقوبات الدولية، وتوقف الاستثمارات الأجنبية، وانهيار العملة المحلية. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا حادًا منذ عام 2021، بينما ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل لافت. وأغلقت آلاف المصانع والشركات، خاصة في قطاعات النسيج والتصنيع والزراعة، وهي من القطاعات التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من السكان. كما تأثرت حركة التجارة الخارجية بسبب تعليق عدد من الاتفاقيات التجارية وفرض قيود مصرفية على التحويلات المالية، ما أدى إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل كبير. أما البنية التحتية، فقد تضررت بشكل مباشر في العديد من المناطق نتيجة العمليات العسكرية، حيث استهدفت الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمياه، وأصبح الوصول إلى المناطق الريفية محفوفًا بالمخاطر بسبب الألغام والصراعات.[19]
وتُعد أزمة الغذاء والصحة والتعليم من أخطر التداعيات التي مست المواطن العادي في حياته اليومية. فقد أدى القتال وانهيار سلاسل الإمداد إلى نقص حاد في المواد الغذائية، خاصة في المناطق النائية والحدودية، حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة أو سوء التغذية، وخصوصًا بين الأطفال والنساء الحوامل. كما تراجعت الخدمات الصحية بشكل ملحوظ، مع توقف الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل بسبب استهدافها أو انسحاب العاملين منها احتجاجًا على الحكم العسكري، إضافة إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. أما القطاع التعليمي، فقد شهد تراجعًا واسعًا، حيث تم إغلاق آلاف المدارس والجامعات، إما بسبب القصف أو لدوافع سياسية، كما امتنع كثير من الطلاب والمعلمين عن الالتحاق بالمؤسسات الخاضعة لإدارة المجلس العسكري، في إطار حملة العصيان المدني.[20]
إن هذه التداعيات المتشابكة لا تمثل مجرد مظاهر للأزمة، بل تعكس عمقها الهيكلي وخطورتها على حاضر البلاد ومستقبلها. فكلما طال أمد الصراع، كلما تعمقت الفجوة بين مكونات المجتمع، وتآكلت قدرة الدولة على التعافي، وأصبح المجتمع الدولي أمام مسؤولية أكبر لتقديم الدعم الإنساني والضغط من أجل حل سياسي يضع حدًا للمعاناة المتزايدة.[21]
رابعًا: مبادرات وقف إطلاق النار وفرص نجاحها
منذ الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021، تتابعت المبادرات الدولية والإقليمية لمحاولة وقف العنف واستعادة المسار السياسي، إلا أن هذه المساعي لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن. ويُعزى ذلك إلى تعقيدات المشهد الداخلي، وتباين مواقف الأطراف المتصارعة، فضلًا عن التوازنات الدولية الدقيقة التي تحكم الموقف من الأزمة. ومع أن ميانمار ليست في قلب الاهتمام الدولي مثل أزمات أخرى، فإن موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية جعلا بعض القوى الإقليمية والدولية تسعى للعب دور في احتواء النزاع.[22]
في مقدمة الجهود الإقليمية تأتي رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، التي تبنت منذ الأشهر الأولى للانقلاب دورًا دبلوماسيًا في محاولة لحل الأزمة، استنادًا إلى اعتبار ميانمار عضوًا في المنظمة، وحرصًا على عدم زعزعة استقرار المنطقة. في أبريل 2021، تم التوافق على ما يُعرف بخطة النقاط الخمس، والتي تضمنت: الوقف الفوري للعنف، وبدء حوار شامل بين الأطراف، وتعيين مبعوث خاص من الآسيان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وزيارة مبعوث المنظمة إلى البلاد للقاء كافة الأطراف. غير أن هذه الخطة واجهت عقبات جدية، أبرزها رفض المجلس العسكري التعاون الكامل مع المبعوث الخاص، ورفضه الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية أو إشراكها في أي حوار رسمي، إلى جانب غياب آلية ملزمة لتنفيذ الخطة داخل إطار الآسيان، ما جعلها أقرب إلى إعلان نوايا من كونها مبادرة فعلية للوساطة.[23]
على الصعيد الدولي، لعبت الأمم المتحدة دورًا تقليديًا في الإدانة وتقديم المساعدات الإنسانية، لكنها واجهت صعوبات كبيرة في التدخل السياسي المباشر، بسبب الانقسامات داخل مجلس الأمن. فقد استخدمت الصين وروسيا نفوذهما داخل المجلس لعرقلة إصدار قرارات قوية ضد المجلس العسكري، انطلاقًا من مواقف ثابتة تعارض التدخل الخارجي في شؤون الدول، وتخشى من أن تتحول الأزمة في ميانمار إلى سابقة قد تُستخدم ضد حلفائهما في المستقبل. ومع ذلك، عينت الأمم المتحدة مبعوثًا خاصًا لمتابعة الأزمة، وعقدت عدة جلسات مغلقة لمناقشة تطوراتها، لكنها لم تنجح في إنتاج مسار تفاوضي جاد بسبب غياب التوافق الدولي حول طبيعة الحل المطلوب.[24]
أما الصين والهند، فتلعبان دورًا مزدوجًا بين الوساطة والتأثير غير المباشر، نظرًا لمصالحهما الجغرافية والاقتصادية في ميانمار. فالصين تُعد أحد أبرز المستثمرين في مشاريع البنية التحتية والطاقة داخل البلاد، وتحتفظ بعلاقات جيدة مع المجلس العسكري وكذلك مع بعض الجماعات المسلحة العرقية، خصوصًا تلك القريبة من حدودها الجنوبية. وقد دعت بكين في أكثر من مناسبة إلى حل سلمي للأزمة، لكنها تجنبت توجيه انتقادات حادة للمجلس العسكري. بالمثل، تسعى الهند إلى الحفاظ على استقرار الحدود الشرقية مع ميانمار، وتخشى من تدفق اللاجئين وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة بالقرب من ولاياتها الشمالية الشرقية، ما يجعلها تميل إلى تبني سياسة براغماتية تقوم على الحوار وتجنب التصعيد. كلا الدولتين، رغم تواصلهما مع الأطراف المختلفة، لم تتقدما بمبادرات وساطة حقيقية، واكتفتا بتصريحات عامة ومواقف توازن بين المصالح الأمنية والاقتصادية.[25]
من جهة أخرى، يظل موقف الأطراف الداخلية من جهود التفاوض أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق تقدم حقيقي. فالمجلس العسكري يرفض الاعتراف بشرعية حكومة الوحدة الوطنية أو الجماعات المسلحة التي تقاتله، ويصر على التعامل مع منظمات دولية وفق شروطه الخاصة. كما يرفض أي تدخل أجنبي يرى فيه تهديدًا لسيادته أو شرعيته. بالمقابل، ترفض حكومة الوحدة الوطنية الدخول في مفاوضات مع الجيش دون شروط واضحة، أبرزها إطلاق سراح المعتقلين، والاعتراف بنتائج الانتخابات السابقة، وانسحاب الجيش من المشهد السياسي. كما تتمسك الجماعات العرقية المسلحة بمطالب قديمة تتعلق بالحكم الذاتي أو الفيدرالية، وترى أن أي تسوية يجب أن تتضمن ضمانات دستورية لحماية حقوقها.[26]
رغم استمرار الأزمة السياسية والأمنية في ميانمار، شهدت الأشهر الأخيرة ظهور مؤشرات محدودة على إمكانية التهدئة، تمثلت في اتفاقات وقف إطلاق نار مؤقتة بين المجلس العسكري وبعض الجماعات المسلحة العرقية، لكنها لم ترق بعد إلى مستوى اتفاق وطني شامل. ففي يناير 2025، نجحت وساطة صينية في التوصل إلى هدنة رسمية بين الجيش الميانماري وجيش التحالف الديمقراطي الوطني (MNDAA) التابع لأقلية الكوكانغ، وهو اتفاق عكس قدرة بكين على لعب دور مباشر في إدارة النزاع الحدودي، وحماية مصالحها الإقليمية. كما أعلن تحالف الإخوة الثلاثة الذي يضم جماعات مثل جيش أراكان وجيش تانغ، عن هدنة إنسانية مؤقتة في أبريل ومايو 2025، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب مناطق شمال ووسط البلاد، وذلك لتسهيل جهود الإغاثة والوصول إلى المتضررين. ومع أن هذه التفاهمات مثلت نوافذ محدودة لخفض التصعيد، فإنها بقيت محصورة جغرافيًا وزمنيًا، وتعرضت للخرق المتكرر، ما يُظهر غياب إطار تفاوضي ملزم أو مراقبة دولية فعالة. وفي ظل غياب اتفاق شامل يشمل حكومة الوحدة الوطنية وقوات الدفاع الشعبي، فإن هذه التفاهمات تبقى هشة، وتُعبر أكثر عن ضرورات إنسانية أو ميدانية مؤقتة، وليس عن إرادة سياسية حقيقية لحل الأزمة بصورة مستدامة.[27]
إن هذه الفجوة الواسعة بين مواقف الأطراف، إلى جانب غياب ضغوط دولية فعالة أو وسيط موثوق يحظى بقبول الجميع، جعلت من جهود الوساطة حتى الآن غير قادرة على إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمة. ويبدو أن أي تقدم في مسار وقف إطلاق النار سيظل مرهونًا بتغير موازين القوى على الأرض، أو بتدخل خارجي أكثر حسمًا، وهو ما لا يبدو قريبًا في ظل تردد المجتمع الدولي وتباين أولويات الفاعلين الإقليميين.[28]
يُعد تقييم فرص نجاح اتفاق لوقف إطلاق النار في ميانمار مسألة معقدة تتداخل فيها عوامل سياسية وأمنية ونفسية، داخلية وخارجية. فبينما تبدو الحاجة إلى تهدئة النزاع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، إلا أن الوقائع الميدانية ومواقف الأطراف لا تزال تشير إلى مسار طويل وشاق قبل التوصل إلى اتفاق مستقر وشامل. ومن هنا، يتطلب فهم فرص التهدئة تحليل جملة من المعوقات الأساسية، إلى جانب المحددات الإيجابية التي قد تفتح نافذة للحل، ثم استعراض السيناريوهات الممكنة لمآلات الوضع في المستقبل القريب.[29]
- المحددات الإيجابية لنجاح وقف إطلاق النار
هناك محددات إيجابية يمكن أن تسهم في فتح المجال أمام اتفاق تهدئة جزئي أو شامل، في حال استثمارها بشكل فعال. أول هذه المحددات يتمثل في الضغوط الدولية المتزايدة، خاصة من جانب الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، التي بدأت تلوح بفرض مزيد من العقوبات، ومحاصرة النظام العسكري سياسيًا واقتصاديًا، فضلًا عن سحب اعتراف بعض الدول بالمجلس العسكري كممثل شرعي للدولة. كذلك، فإن الخسائر الميدانية المتبادلة بين الجيش والمعارضة المسلحة، وتصاعد وتيرة الاستنزاف في الأرواح والمعدات، قد يدفع الأطراف إلى التفكير في حلول سياسية لتجنب الانهيار أو الدخول في حرب طويلة الأمد لا تحقق انتصارًا حاسمًا لأي طرف.[30]
إلى جانب ذلك، يُعد الاستنزاف الاقتصادي الحاد أحد العوامل التي قد تغير حسابات المجلس العسكري، خاصة في ظل تدهور العملة المحلية، وانخفاض الاستثمارات، وتصاعد الاحتياجات المالية لتسيير شؤون الدولة. فمع طول أمد النزاع، تصبح كلفة الاستمرار في الصراع أكبر من كلفة الدخول في تسوية، لا سيما إذا كانت التسوية تضمن للجيش بعض المكاسب الرمزية أو المؤسسية دون الإضرار الكلي بموقعه داخل الدولة.[31]
- تحديات نجاح وقف إطلاق النار
- تعدد الفاعلين داخل كل طرف
إلى جانب تباين الأهداف بين الفصائل المختلفة، تعاني كل من حكومة الوحدة الوطنية والجماعات المسلحة من غياب وحدة القرار الداخلي. فهناك تعدد في القيادات، واختلاف في الأساليب، وأحيانًا تنافس على الشرعية والتمثيل داخل نفس المعسكر. هذا التعدد يُضعف من القدرة على ضبط الجبهات، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام جميع القوى المعارضة بأي اتفاق يتم توقيعه مستقبلًا، ما يزيد من قلق الطرف الآخر ويقلل من جدية التفاوض. [32]
- انعدام الثقة التاريخي بين الأطراف
يُشكل انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار في ميانمار. ويعود هذا الانعدام إلى جذور تاريخية عميقة، حيث لطالما ارتبط الجيش بسلوك قمعي تجاه القوى السياسية والمدنية والجماعات العرقية. فعلى مدى عقود قام المجلس العسكري بخرق العديد من التعهدات والاتفاقات السابقة، مما رسخ لدى المعارضة، بشقيها السياسي والعسكري، قناعة بأن أي دعوة للحوار أو التهدئة ما هي إلا محاولة لكسب الوقت، أو لإضفاء شرعية على سلطة لا تمتلك قاعدة ديمقراطية. ولذلك، لا يُنظر إلى مبادرات التفاوض بجدية، بل يُقابلها كثير من الريبة والتوجس.
- غياب الضمانات والوساطة المتوازنة
يفتقر المشهد السياسي في ميانمار إلى أي آلية قانونية أو سياسية موثوقة يمكن أن تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه. فلا توجد جهة دولية محايدة يمكنها لعب دور الوسيط الضامن بين الأطراف، خاصة في ظل انقسام الموقف الدولي، وامتناع مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات حاسمة بسبب الفيتو الروسي والصيني. هذا الغياب للضمانات يجعل القوى المعارضة خصوصًا الجماعات المسلحة تتردد في الانخراط بأي اتفاق لا يتضمن إشرافًا محايدًا وضمانات صريحة تضمن عدم تكرار سيناريوهات سابقة من الانقلاب على التفاهمات. [33]
- تشتت المعارضة واختلاف أولوياتها
يمثل تشتت قوى المعارضة أحد أبرز التحديات أمام تشكيل جبهة تفاوضية موحدة. فالمعارضة السياسية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى استعادة النظام الديمقراطي والدستور المدني، بينما ترتكز مطالب الجماعات المسلحة العرقية على قضايا الحكم الذاتي والفيدرالية، استنادًا إلى مظالم تاريخية تعود إلى عقود. هذا الاختلاف في الأولويات والرؤى يجعل التنسيق بين الطرفين معقدًا، ويضعف من قدرتهم على صياغة موقف موحد يعكس جميع مطالب المكونات المتنوعة داخل المعارضة.
خامسًا: الانعكاسات الإقليمية والدولية لاستمرار أو إنهاء الصراع
لا تقتصر آثار الأزمة المشتعلة في ميانمار على حدودها الداخلية فحسب، بل تمتد انعكاساتها إلى المحيطين الإقليمي والدولي، نظرًا لموقع الدولة الجغرافي الحيوي، وارتباطها بشبكات المصالح التجارية والأمنية والسياسية في جنوب شرق آسيا. ولهذا، فإن استمرار الصراع أو التوصل إلى تسوية سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي، وعلى مصالح القوى الكبرى المتداخلة في المشهد الميانماري.[34]
أول وأهم هذه الانعكاسات يظهر في تهديد الأمن الإقليمي في جنوب شرق آسيا. فميانمار تشترك بحدود طويلة ومعقدة مع خمس دول هي: الصين، الهند، تايلاند، بنغلاديش، ولاوس، ما يجعل أي اضطراب داخلي فيها مصدر قلق مباشر لجيرانها. وقد أدى تصاعد القتال بين الجيش والمعارضة المسلحة إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين نحو الدول الحدودية، مما تسبب في توترات أمنية وإنسانية، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الهشة أمنيًا مثل شمال شرق الهند وشمال تايلاند. كما أن استمرار الصراع المسلح يزيد من احتمال تهريب الأسلحة والمخدرات، ويشجع بعض الجماعات المسلحة العرقية على تعزيز وجودها عبر الحدود، وهو ما يهدد بانفلات أمني قد يتجاوز حدود ميانمار.[35]
من جانب آخر، فإن للأزمة تأثيرًا مباشرًا على تجارة الطاقة وطرق النقل الإقليمية والدولية. فميانمار تُعد نقطة مرور استراتيجية ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وتضم مشاريع حيوية كميناء “كياوكفيو” وخطوط أنابيب الغاز والنفط التي تربط الساحل الميانماري بمقاطعة “يونان” الصينية. كما تلعب البلاد دورًا مهمًا في تأمين طرق النقل البحري في خليج البنغال والمحيط الهندي، خاصة في ظل التنافس المتزايد بين الصين والهند على النفوذ البحري. واستمرار الصراع يعني تهديد هذه المشاريع وتعطيل مسارات الشحن والاستثمار، ما يدفع الشركات الدولية والدول المعنية إلى إعادة تقييم جدوى استمرار أعمالها في البلاد. كذلك، فإن تدهور الاستقرار في ميانمار قد يُربك عمليات التجارة الإقليمية، ويُحدث خللًا في سلاسل التوريد التي تمر عبرها، لا سيما في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة.[36]
أما على المستوى الدولي، فإن موقف القوى الكبرى من الأزمة في ميانمار يعكس توازنات جيوسياسية مركبة تتجاوز الأبعاد المبدئية المعلنة. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتخذان موقفًا معلنًا رافضًا للانقلاب العسكري، ويطالبان بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما فرضتا سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على قادة الجيش ومؤسساته المرتبطة. ورغم أن هذا الموقف يتسق ظاهريًا مع الخطاب الديمقراطي الغربي، إلا أنه يُقرأ أيضًا في إطار محاولات احتواء النفوذ الصيني المتصاعد في جنوب شرق آسيا، وهو هدف استراتيجي أمريكي معلن، يندرج ضمن سياسات الحرب الباردة الجديدة مع بكين، خاصة في المناطق القريبة من مبادرة الحزام والطريق. [37]
وبهذا المعنى، فإن الدعم الغربي لحكومة الوحدة الوطنية والمعارضة المدنية لا يقوم فقط على أساس قيمي ديمقراطي، بل يخدم أيضًا مصالح جيواستراتيجية تتعلق بتقليص مساحة التمدد الصيني في ميانمار، التي تمثل نقطة عبور حيوية للطاقة والبنية التحتية الصينية باتجاه المحيط الهندي. كما تسعى واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، وتقديم نفسها كبديل سياسي واقتصادي عن الصين.
في المقابل، تتبنى الصين وروسيا مواقف أكثر تحفظًا، وتعارضان أي تدخل خارجي حاد في الشؤون الداخلية لميانمار. ترى الصين في المجلس العسكري شريكًا مستقرًا نسبيًا يضمن استمرار مصالحها الاقتصادية ومشاريعها في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تُبقي على علاقات مرنة مع بعض الجماعات العرقية المسلحة، لتستخدمها كورقة ضغط عند الحاجة. أما روسيا، فقد استغلت عزلة ميانمار الدولية لتعزيز علاقاتها مع المجلس العسكري، من خلال بيع الأسلحة وتوسيع التعاون العسكري، خاصة بعد أن أصبح كلا البلدين هدفًا للعقوبات الغربية. هذا التباين في مواقف القوى الكبرى يُضعف من قدرة المجتمع الدولي على تقديم مبادرة موحدة وفعالة لحل الأزمة، ويمنح الجيش هامشًا أوسع للمناورة داخليًا وخارجيًا.[38]
في ظل هذا التداخل المعقد بين العوامل المحلية والدولية، يصبح من الواضح أن إنهاء الصراع في ميانمار لا يرتبط فقط بإرادة الأطراف الداخلية، بل يتطلب أيضًا توافقًا دوليًا حقيقيًا، وضغطًا متوازنًا من القوى الإقليمية والدولية لإجبار جميع الأطراف على تقديم تنازلات تؤسس لحل سياسي شامل ومستدام. أما في حال استمرار الانقسام الدولي واللامبالاة الإقليمية، فإن الأزمة مرشحة للاستمرار، مع مزيد من التأثير السلبي على الأمن الإقليمي والتوازنات الجيوسياسية في منطقة جنوب شرق آسيا.[39]
سيناريوهات الأزمة
بناءً على ما سبق، يمكن استعراض ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل وقف إطلاق النار في ميانمار:
- السيناريو الأول: سيناريو الهدنة الجزئية، يمثل هذا السيناريو خيارًا واقعيًا في ظل التوازنات الميدانية والسياسية الحالية، ويتمثل في التوصل إلى اتفاقات موضعية ومحدودة لوقف إطلاق النار بين الجيش وبعض الجماعات المسلحة العرقية في مناطق بعينها، خاصة تلك المتأثرة بالكوارث الطبيعية أو الضغوط الإنسانية، كما حدث بعد زلزال مارس 2025. وتدفع هذه الهدن غالبًا باعتبارات إنسانية، أو نتيجة ضغوط إقليمية (مثل الوساطات الصينية)، أو بسبب الحاجة إلى إعادة التموضع الميداني من قبل أحد الطرفين، ورغم أهمية هذه الهدن في تقليل التصعيد العسكري وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلا أنها تبقى مؤقتة وهشة، لأنها لا تنبع من إرادة سياسية شاملة، ولا تُعالج جذور الأزمة. كما أن غياب اتفاق سياسي جامع واستمرار العداء بين الجيش وحكومة الوحدة الوطنية، وعدم مشاركة جميع الفصائل العرقية فيها، يجعل هذه الهدن عُرضة للانهيار السريع، وتُبقي على حالة عدم الاستقرار البنيوي.
- السيناريو الثاني: سيناريو الاتفاق الشامل، هذا السيناريو يُمثل المخرج المثالي للأزمة، ويقوم على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار على المستوى الوطني، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبدء حوار جامع بين جميع مكونات المشهد، بما يشمل المجلس العسكري، حكومة الوحدة الوطنية، والجماعات العرقية المسلحة. يتطلب هذا السيناريو توافقًا داخليًا نادرًا وتدخلًا دوليًا فعالًا سواء من قبل الأمم المتحدة أو من خلال دول فاعلة مثل الصين والهند والولايات المتحدة، مع توفير ضمانات قانونية وأمنية تُطمئن الأطراف، خصوصًا المعارضة، إلى جدية الجيش في الالتزام بالاتفاق، لكن في ظل غياب الإرادة السياسية لدى القيادة العسكرية، وافتقار المجتمع الدولي إلى أدوات الضغط الموحدة، يبقى تحقيق هذا السيناريو مؤجلًا إلى حين تغير موازين القوى أو تصاعد كلفة الحرب إلى مستويات لا يمكن للجيش تحملها. ورغم صعوبته، فإن هذا السيناريو هو الوحيد القادر على إنهاء الأزمة جذريًا، وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وشاملة.
- السيناريو الثالث: سيناريو انهيار المفاوضات وتصاعد النزاع، في حال استمرار تعنت الجيش، وتزايد الانقسامات داخل المعارضة، وفشل المساعي الإقليمية والدولية في إنتاج مسار تفاوضي حقيقي، فإن ميانمار قد تتجه نحو مزيد من الفوضى والانهيار المؤسسي، ويُحتمل في هذا السيناريو أن تنزلق البلاد نحو حرب أهلية طويلة الأمد تتعدد فيها الجبهات وتضعف فيها سلطة الدولة المركزية، خاصة مع استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق واسعة وازدياد ظاهرة الإدارة الذاتية خارج سلطة نايبيداو. هذا قد يؤدي إلى تقسيم فعلي وغير معلن للبلاد، حيث تصبح بعض المناطق تحت سيطرة الفصائل العرقية أو المعارضة، وأخرى تحت سلطة الجيش، ما يكرس واقعًا انفصاليًا ويمهد لحالة من التفتت السياسي والجغرافي، في هذا السياق، ستتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكل أكبر، وسترتفع أعداد النازحين واللاجئين، ما يُهدد أمن دول الجوار ويُحول الأزمة إلى ملف إقليمي معقد، يتداخل فيه الأمن والهجرة والتطرف والانهيار البيئي والاجتماعي.
وبالتالي، فإن فرص نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في ميانمار تظل رهينة لإرادة الأطراف، ومدى الضغط الدولي، وفعالية الوساطات، واستعداد الجميع لتقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد. وما لم تتغير موازين القوى أو تتدخل جهة دولية قادرة على فرض مسار سياسي ملزم، فإن الأزمة ستظل في مكانها، مع مخاطر متزايدة على الاستقرار الإقليمي والإنساني.
مجمل القول، إن الأزمة المتفاقمة في ميانمار لا يمكن اختزالها في مجرد صراع بين سلطة ومعارضة، بل هي نتاج تاريخ طويل من التوترات البنيوية بين المؤسسة العسكرية، والمجتمع المدني، والمكونات العرقية التي ظلت لعقود مهمشة ومحرومة من المشاركة في صياغة مستقبل الدولة. وقد عمق الانقلاب العسكري في فبراير 2021 هذه التناقضات، ليس فقط من خلال عودة الحكم الشمولي، بل عبر تعطيل عملية سياسية كانت رغم بطئها تمثل بارقة أمل للانتقال الديمقراطي، لقد بينت المحاور السابقة أن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإن لم تكن منعدمة، لا تزال تواجه تحديات كبيرة. فغياب الثقة، وتفرق المعارضة، وغياب الضمانات الدولية الفعلية، تُعد معوقات جوهرية في مسار التسوية. ورغم وجود ضغوط اقتصادية وخسائر ميدانية يمكن أن تدفع الأطراف نحو التهدئة، إلا أن غياب توافق إقليمي ودولي، خاصة بين القوى الكبرى، يُضعف من فعالية أي مبادرة للحل، كما أن استمرار الصراع لن يقتصر تأثيره على الداخل الميانماري، بل سيفضي إلى اضطرابات إقليمية قد تضر باستقرار جنوب شرق آسيا، وتعطل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتفتح المجال أمام تهديدات أمنية عابرة للحدود. وفي المقابل، فإن إنهاء الصراع بشكل تفاوضي سيُمثل فرصة لبناء دولة أكثر شمولًا وتماسكًا، تُعيد الاعتبار للمسار الديمقراطي، وتفتح أفقًا جديدًا نحو دولة قادرة على احترام تنوعها الداخلي، والانخراط بفاعلية في محيطها الإقليمي والدولي.
وعليه، فإن مستقبل الأزمة في ميانمار سيظل مرهونًا بثلاثة محددات أساسية: أولًا، قدرة المعارضة على توحيد صفوفها وتقديم رؤية سياسية جامعة. ثانيًا، استعداد المجلس العسكري للتراجع النسبي وقبول حل سياسي يضمن له مخرجًا آمنًا من السلطة. وثالثًا، وجود توافق دولي حقيقي للضغط على الأطراف، وتقديم ضمانات سياسية وإنسانية يمكن البناء عليها. بدون ذلك، فإن الصراع سيظل مفتوحًا على سيناريوهات غير محسوبة، قد تكون كلفتها أكبر بكثير من حسابات أي طرف بمفرده.
المصادر:
[1] الإجراءات العسكرية المُعتَمَدة في ميانمار عقب الزلزال تؤدّي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا في البلاد، نُشر في 4 أبريل 2025. الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
[2] الحالة في ميانمار، نُشر في 4 أبريل 2024، مجلس الأمن.
file:///C:/Users/DELL/Downloads/S_PV.9595-AR.pdf
[3] عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر يتجاوز 3 آلاف، نُشر في 3 أبريل 2025، الجزيرة نت.
[4] أزمة الروهينغا.. محطات وتطورات، نُشر في 12 سبتمبر 2017، الجزيرة نت.
[5] مهديد سعيد، أزمة الأقلية المسلمة في ميانمار، نُشر في 15 يناير 2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقايد بالجزائر.
[6] الثورة القادمة في ميانمار.. هل تحرر البلاد من فوضى الحكم العسكري؟، نُشر في 6 أغسطس 2021، الجزيرة نت.
[7] حميدة بعوني، أزمة الروهينغا في الحسابات الجيواستراتيجية الصينية والأمريكية، نُشر في 31 ديسمبر 2023، مجلة مدارات سياسية جامعة بليدة بالجزائر.
[8] محمود عاشور مؤمن، مسلمو الروهينجا وعصر الانقلاب العسكري في ميانمار، نُشر في 26 يوليو 2022، مركز الحضارة للدراسات والبحوث.
[9] قوات “المقاومة” تُضيّق الخناق على النظام العسكري في ميانمار، نُشر في 29 أكتوبر 2024، euro news.
https://arabic.euronews.com/2024/10/29/resistance-forces-tighten-noose-myanmar-military-regime
[10] أميركا تعاقب رئيس وجيش ميانمار.. والجنرالات يلوحون بالعفو والتعاون، نُشر في 12 فبراير 2021، العربية.
[11] ميانمار.. خريطة الصراع وأسباب تصاعده، نُشر في 20 أبريل 2024، الجزيرة نت.
[12] ميانمار.. ساحة الحرب الباردة الجديدة بين الصين وأميركا، نُشر في 14 يوليو 2023، الجزيرة نت.
[13] الصراعات الملتهبة… تحاصر خريطة العرب، نُشر في 12 أكتوبر 2022، صحيفة الشرق الأوسط.
[14] الجغرافيا السياسية، نُشر في 2024، المركز الديمقراطي العربي.
[15] التهديد الجهادي في ميانمار، نُشر في 17 يونيو 2021، مركز سمت للدراسات.
[16] مأساة مسلمي الروهينغا في ميانمار، نُشر في 2017، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق.
https://dirasat.net/uploads/research/9467290.pdf
[17] أزمة ذات أبعاد متعددة و”غير مسبوقة” تواجه شعب ميانمار في عام 2022، نُشر في 31 ديسمبر 2021، الأمم المتحدة.
https://news.un.org/ar/story/2021/12/1090812
[18] زلزال ميانمار.. مأساة إنسانية بامتداد سياسي واقتصادي في قمة بانكوك، نُشر في 3 أبريل 2025، سي ان ان الاقتصادية.
[19] ميانمار: ربع السكان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وسط تعمّق الأزمة، نُشر في 13 يونيو 2022، الأمم المتحدة.
https://news.un.org/ar/story/2022/06/1104612
[20] تقرير أممي: سكان ميانمار يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة في 2022، نُشر في 1 يناير 2022، جسور بوست.
https://jusoorpost.com/ar/posts/177/tkryr-ammy-skan-myanmar-yoaghon-azm-ansany-ghyr-msbok-fy-2022
[21] مؤرخ بورمي: ميانمار دولة فاشلة والثورة قادمة، نُشر في 14 يونيو 2021، الجزيرة نت.
[22] ميانمار تعلن وقف إطلاق النار لتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال، نُشر في 2 أبريل 2025، بي بي سي نيوز عربية.
https://www.bbc.com/arabic/articles/c2lz9k0kdp0o
[23] قمة آسيان تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في ميانمار وتبني الحوار الوطني، نُشر في 27 مايو 2025، نيوز زووم.
[24] الأمم المتحدة تدعو إلى دعم ميانمار بعد الزلزال المدمر، نُشر في 5 أبريل 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[25] الدروس المستفادة من عمل MPSI في دعم عملية السلام في ميانمار، نُشر في 27 أبريل 2022.
[26] حكومة ميانمار تعلن وقف إطلاق النار لتسهيل جهود الإغاثة، نُشر في 2 أبريل 2025، بوابة الشروق.
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042025&id=434bd026-375d-4c96-a820-8089280ad1e2
[27] بوساطة الصين …اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار وجيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار، نُشر في 20 يناير 2025، Arabic.News.CN.
https://arabic.news.cn/20250120/6487f24a37134aa285d0fa7525b7ede1/c.html
[28] زلزال ميانمار.. الأعمال العسكرية تعرقل الإغاثة بعد رفض الحكومة وقف النار مع المتمردين، نُشر في 1 أبريل 2025، الشرق.
[29] غوتيريش: ميانمار اليوم مسرح للدمار واليأس ويجب تحويل المأساة إلى فرصة، نُشر في 3 أبريل 2025، الأمم المتحدة.
https://news.un.org/ar/story/2025/04/1140441
[30] ميانمار… إنهيار وقف اطلاق النار وتجدد المواجهات الدامية، نُشر في 25 أبريل 2025، إرم نيوز.
https://www.eremnews.com/news/world/so3aqmn
[31] ميانمار: بقاء الوضع الراهن يخدم مصالح اللاعبين الدوليين الكبار، نُشر في أبريل 2023، صحيفة الشرق الأوسط.
[32] حركة المقاومة في ميانمار تعلن وقف الاق نار جزئي، نُشر في 30 مارس 2025.
[33] ميانمار: ثلاث جماعات متمرِّدة تعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، نُشر في 1 أبريل 2025، الإيطالية نيوز.
[34] ميانمار: النزاع الدامي مستمر ولا حلّ في الأفق، نُشر في 1 فبراير 2024، الجزيرة نت.
[35] انقلاب ميانمار: كيف تحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية؟، نُشر في 1 فبراير 2022، بي بي سي نيوز عربية.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60221638
[36] مصطفى أحمد، الآسيان نموذج محنمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، نُشر في 22 مايو 2024، مركز الحبتور للأبحاث.
[37] ميانمار: بعد مرور أربع سنوات على الانقلاب، يواصل القادة ارتكاب الانتهاكات بكثافة غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة، نُشر في 31 يناير 2025،الأمم المتحدة.
[38] منظمات روهينغية تدعو ماليزيا لتغيير ميثاق “آسيان” والتدخل لوقف “إبادتهم”، نُشر في 23 نوفمبر 2024، الجزيرة نت.
[39] سارة النيادي، الشركات الأمنية الخاصة الصينية في ميانمار: الآفاق والتحديات، نُشر في 21 يناير 2025، تريندز للبحوث والاستشارات.
باحث في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب