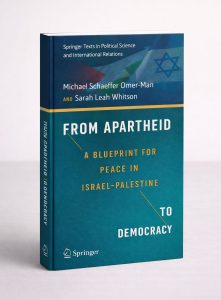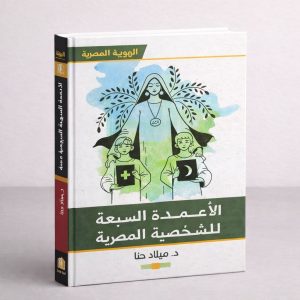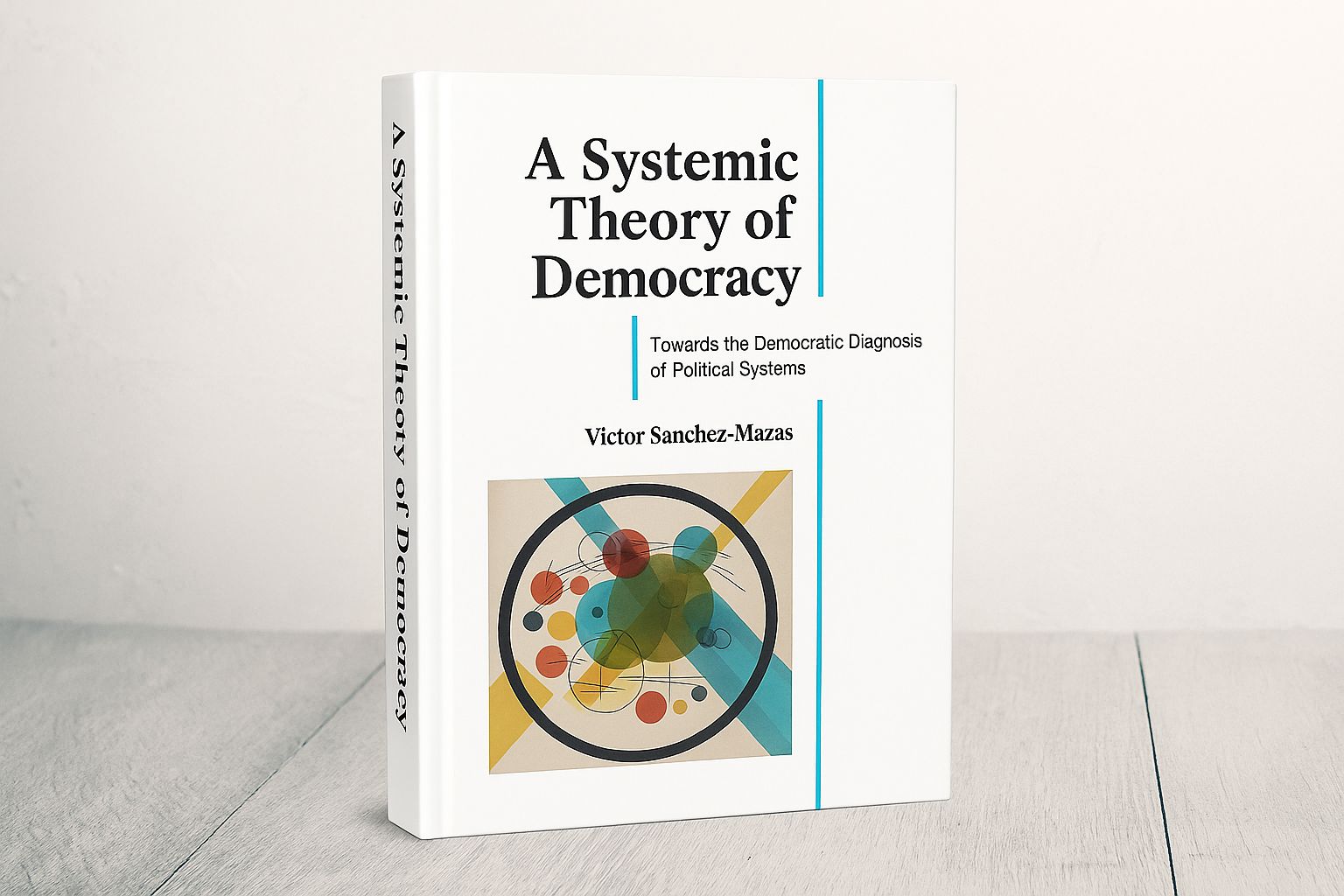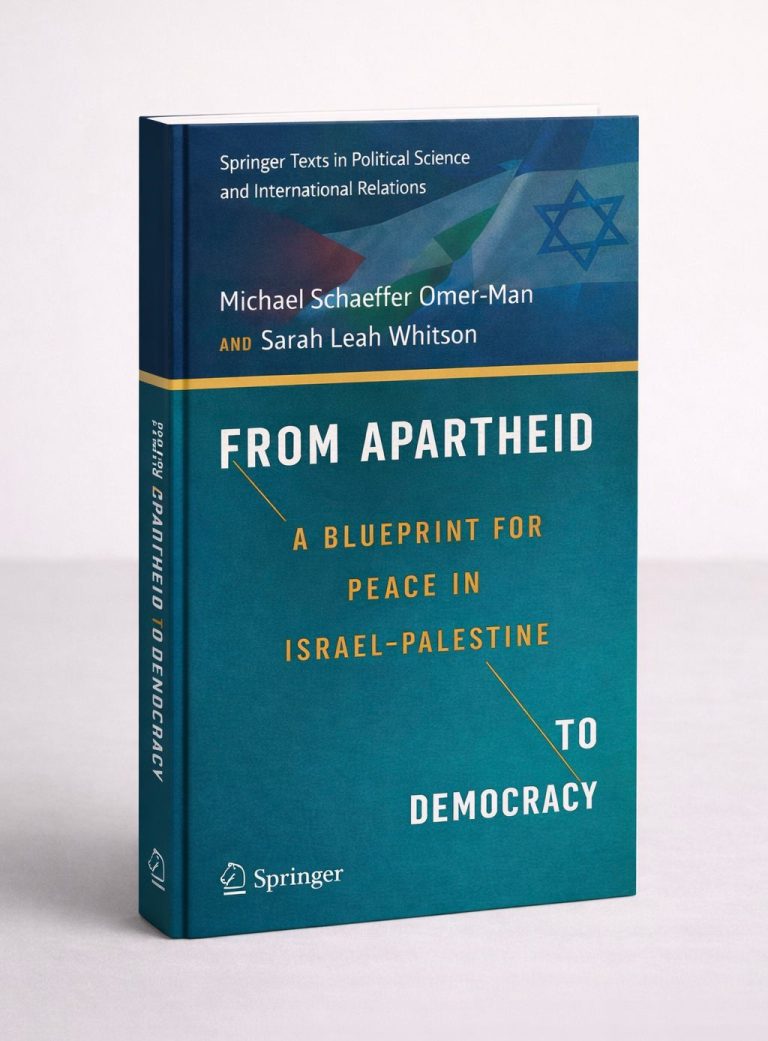يستعرض كتاب “النظرية النظامية للديمقراطية: نحو التشخيص الديمقراطي للأنظمة السياسية”(A Systemic Theory of Democracy: Towards the Democratic Diagnosis of Political Systems ) للباحث فيكتور سانشيز-ماساس، والصادر في طبعته الأولى في ديسمبر 2024 عن Press ( l’École polytechnique fédérale de Lausanne)، رؤية جديدة لفهم الأنظمة الديمقراطية بوصفها نظامًا اجتماعيًا معقدًا يتفاعل باستمرار مع بيئته. ويقدّم الكتاب “النظرية النظامية للديمقراطية” كإطار شامل لتحليل الوظائف السياسية والممارسات الاجتماعية والمبادئ المعيارية للنظم الديمقراطية، بما يكشف أوجه القصور التي تعاني منها تلك الأنظمة. كما يطرح مفهوم “التشخيص الديمقراطي” كأداة تمكّن المواطنين من تقييم ديمقراطياتهم وأنظمتهم السياسية بشكل عام بصورة جماعية وتجديدها بشكل مستمر.
فيكتور سانشيز-ماساس هو باحث سياسي في جامعة جنيف، وعضو في معهد دراسات المواطنة وقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة نفسها. تركّز اهتماماته البحثية على قضايا الديمقراطية والنظرية السياسية والاجتماعية. وتتناول أطروحته في النظرية السياسية بناء نظرية نظامية للديمقراطية، والتي تقع عند التقاطع بين النظرية والبحث التطبيقي. وهو ويعمل حاليًا على تطوير الجانب العملي لهذا المشروع الفكري، إلى جانب سعيه لتأسيس هيئات ديمقراطية مبتكرة في جنيف وخارجها.
وأنطلاقًا من ذلك، ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول وهم: الفصل الأول: الأنظمة في النظرية الديمقراطية، والفصل الثاني: فتح الصندوق الأسود للأنظمة الديمقراطية، والفصل الثالث: نظرية النظم: إعادة قراءة نقدية، والفصل الرابع: الحدود الاجتماعية للأنظمة السياسية، والفصل الخامس: من القوة إلى التبرير: معيارية الأنظمة الديمقراطية، والفصل السادس: الأنظمة الديمقراطية: رسم ملامح التعقيد، والفصل السابع: نحو تشخيص ديمقراطي للأنظمة السياسية.
الفصل الأول: الأنظمة في النظرية الديمقراطية
يستعرض الفصل الأول من الكتاب النماذج والنظريات الكلاسيكية والتقليدية لفهم الأنظمة الديمقراطية، ويبيّن أنها لم تعد كافية لتفسير آلية عمل النظام الديمقراطي بصورته الحالية. ويجادل الكاتب بأن الأنظمة الديمقراطية هي أنظمة اجتماعية معقدة ومتكاملة، ولا ينبغي اختزالها في آلياتها الانتخابية أو في جانب واحد فقط، إذ إنها تتفاعل مع محيطها بشكل مستمر، وهو ما يجعلها حيوية دائمًا.
الفصل الثاني: فتح الصندوق الأسود للأنظمة الديمقراطية
يحاول الكاتب في الفصل الثاني الجمع بين المكوّن الوصفي لفهم كيفية عمل الأنظمة الديمقراطية في الواقع فعليًا، والمكوّن المعياري الذي يتناول الكيفية التي ينبغي أن تعمل بها تلك الأنظمة. ومن خلال هذين المكوّنين يمكن التعرف على آليات عمل الأنظمة الديمقراطية وتشخيص أزماتها. ويستطرد بأن معظم المحللين يقومون بالفصل بين هذين المكوّنين، ويوضح أنه يجب الجمع بينهما حتى يتم فهم النظام الديمقراطي بشكل صحيح.
الفصل الثالث: نظرية النظم: إعادة قراءة نقدية
يركز الفصل الثالث على المراجعة النقدية للنظريات التي تناولت الأنظمة الاجتماعية، وخصوصًا أعمال المفكّرين “نيكلاس لوهمان” و”يورغن هابرماس”. ويرى الكاتب أنه بالرغم من قوة أطروحاتهما في تفسير العديد من الجوانب الاجتماعية والسياسية، إلا أنه يجب تجاوز أطروحاتهما وإدخال العديد من التعديلات والتطويرات عليهما لفهم الديمقراطية بصيغتها الحالية. يهدف الكاتب من خلال هذا الفصل إلى استخدام أدوات نظرية لفهم طبيعة عمل الأنظمة، لكن بعد تعديلها بحيث تخدم فهم الديمقراطية كنظام اجتماعي معقّد، ويمهّد بذلك الطريق للانتقال إلى تعريف أوضح للنظام السياسي وحدوده.
الفصل الرابع: الحدود الاجتماعية للأنظمة السياسية
يُجيب الفصل الرابع عن السؤال الذي طرحه الكاتب مرارًا وتكرارًا، ألا وهو: “ما هو النظام السياسي؟”. ففي هذا الفصل، يستعرض الكاتب الحدود والوظائف التي يجب أن تتوافر في النظام السياسي، ويعرض أهم الوظائف الأساسية له، ويُعرّفه بوصفه منظومة تتعامل مع السلطة الاجتماعية، كما يتناول حدوده وتقاطعاته، والأبعاد الرمزية والمعيارية له. فهو في هذا الفصل يحدد الإطار الفعلي الذي يجب النظر إليه لفهم النظام السياسي.
الفصل الخامس: من القوة إلى التبرير: معيارية الأنظمة الديمقراطية
يستعرض الفصل الخامس فكرة جوهرية في الكتاب، وهي أن الأنظمة الديمقراطية لا تمارس سلطتها وقوتها لمجرّد امتلاكها الحق الشرعي في ذلك، بل تمارسها عبر التبرير؛ أي أن استعمال السلطة يجب أن يترافق مع آليات محددة لتبرير السياسات أمام المواطنين. ومن هذا المنطلق، يوضح الكاتب الفرق بين ممارسة القوة والسلطة في الأنظمة الديمقراطية مقارنة بالأنظمة الاستبدادية، كما يتناول المبادئ المعيارية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية مثل المعاملة بالمثل والشفافية، ثم ينتقل إلى بيان الكيفية التي تتحقق بها الشرعية الديمقراطية عبر العملية التبريرية والقيم المعيارية الأخرى.
الفصل السادس: الأنظمة الديمقراطية: رسم ملامح التعقيد
يحاول الكاتب في الفصل السادس رسم خرائط نظامية لفهم المكوّنات المعقّدة والأزمات التي تعاني منها الأنظمة الديمقراطية. ومن خلال هذه الخرائط يدرس الكاتب عناصر النظام الديمقراطي ومكوّناته، ثم ينظر إلى العلاقات التفاعلية الشاملة بينها كوحدة واحدة، لا كمكونات منفصلة. وتساعد هذه الخرائط على الكشف عن أوجه الضعف والقصور في مكوّنات النظام، بما يساهم في تشخيص الخلل في هذه الأنظمة ومحاولة معالجته.
الفصل السابع: نحو تشخيص ديمقراطي للأنظمة السياسية
يقدّم الفصل السابع والأخير مفهوم “التشخيص الديمقراطي” كأداة جديدة لتقييم الأنظمة السياسية. وتقوم هذه الآلية على القدرة الجماعية للمواطنين على تشخيص الأزمات والمشكلات التي تعاني منها أنظمتهم، إذ إن الديمقراطية دائمًا ما تواجه مشكلات متكرّرة نتيجة لعدم اكتمالها أو لعدم وجودها بشكل كامل، مما يجعلها في حاجة إلى آلية تشخيصية مستمرة لتحديد أوجه القصور ومعالجتها. وتتسم هذه العملية التشخيصية بخصائص محددة، مثل كونها تشاركية بين المواطنين، ومستمرّة، وحسّاسة للسياق، ومزدوجة تجمع بين المكوّن الوصفي والمعياري. أما آلياتها، تشمل مجالس المواطنين، والمشاورات العمومية، ورسم الخرائط النظامية، بما يتيح تشخيصًا دقيقًا لمشكلات النظام والعمل على تصحيحها.
رؤية نقدية الكتاب
بالرغم من أن الكتاب يقدّم أطروحات قوية لفهم طبيعة عمل الأنظمة السياسية وآليات الديمقراطية، فإنه يعاني من بعض أوجه القصور. يتمثل أولًا في إعطائه أولوية كبيرة للجانب النظري على حساب الجانب التطبيقي، مما يجعله يجرّد الواقع ويغفل تحدياته. وثانيًا في أنه لم يقدّم أمثلة كافية على مفهومه “التشخيص الديمقراطي” أو تجارب عملية لاختبار مدى قدرة المفهوم أو الآلية على التغلب على تحديات الأنظمة. وثالثًا وأخيرًا في أنه لم يُعطي أهمية كبيرة للجانب الاقتصادي وتأثيره الكبير على السياسة، إذ أن رأس المال يمتلك قدرة فائقة على توجيه أولويات النظام وتحديد توجهاته، وهو ما يحدد آلية عمله.
وفي الختام، يمكن القول إن الكتاب قدّم تحليلًا شاملًا ومراجعة نقدية معمّقة للنظريات التي تناولت الأنظمة الديمقراطية، كما وصف مشكلاتها وتحدياتها بدقة ووضوح، حتى ولو عانى من بعض القصور. ومع ذلك، يظل الكتاب مرجعًا مهمًا لفهم طبيعة الأنظمة الديمقراطية وآليات عملها، ويمهّد الطريق أمام أبحاث وممارسات أوسع لتطوير أطروحاته وتجديدها.
باحث مساعد في النظم و النظرية السياسية بمركز ترو للدراسات والتدريب