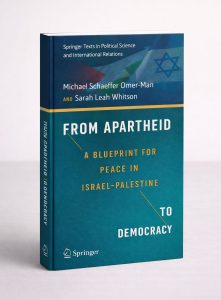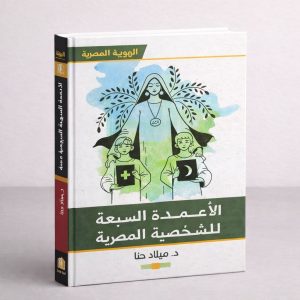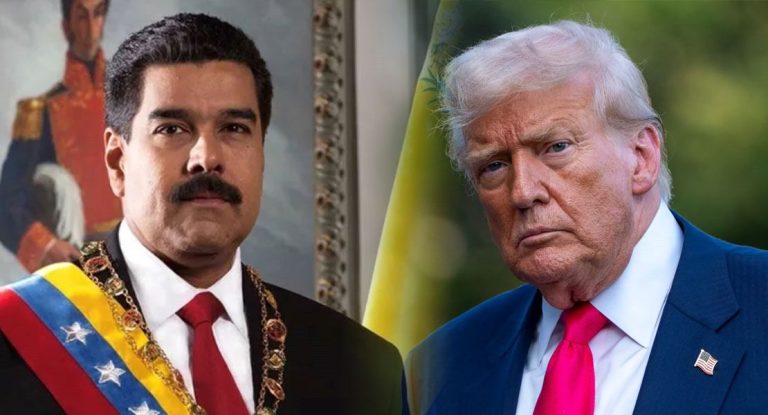شهد قطاع غزة خلال الفترة الماضية واحدة من أكبر المجازر الإنسانية التي شهدها التاريخ الحديث؛ إذ تعرض الشعب الفلسطيني لعمليات قتل ممنهج، وتجويع، وإبادة جماعية منظمة، شكلت تحديًا صارخًا للقانون الدولي، وانتهاكًا فاضحًا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وعند النظر بتمعّن في حالة قطاع غزة وآليات القتل الممنهج والتجويع الممارس بحق سكانه، يتضح أنها تُنفَّذ بدرجة عالية من الدقة والتنظيم، وهو ما يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي قد طوّر منظومة معقّدة ومركّبة لإدارة حياة وموت الفلسطينيين في القطاع، والتي تتجلى بوضوح في ملف الغذاء والمساعدات. وتقوم هذه المنظومة بشكل رئيسي على الدمج بين أدوات الضبط الحيوي، التي تُعنى بتنظيم الحياة اليومية للسكان والتحكم في تفاصيلها الدقيقة — من الغذاء والدواء إلى الحركة والتنقل — وبين القدرة السيادية المطلقة على الإقصاء والإبادة، والتي تسمح للسلطة باتخاذ القرار النهائي بشأن من يُسمح له بالبقاء والحياة ومن يُترك للموت أو القتل.
ومن هنا، فإن هذا الواقع يستدعي قراءته في ضوء الأطر النظرية والمفاهيم التي تناولت مسألة التحكم في الحياة والموت، وتنظيم وضبط المجال الحيوي للإنسان، والتي كان من أبرزها مفهوم “السياسة الحيوية” للمفكر الفرنسي ميشيل فوكو[1]، ومفهوم “حالة الاستثناء” للفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين[2]، وهو مفهوم طوّره أغامبين انطلاقًا من الإطار الفوكوي للسياسة الحيوية. وبناءً عليه، يسعى هذا المقال إلى تحليل واقع الحرب في غزة والأزمة الإنسانية الحاصلة هناك، انطلاقًا من الأدوات التحليلية التي قدمها كل من ميشيل فوكو وجورجيو أغامبين، والتي سوف نستعرضها بالتفصيل في الجزء القادم.
أولًا: مفهوم السياسية الحيوية بين ميشيل فوكو وجورجيو أجامبين
ظهر مفهوم السياسة الحيوية لأول مرة على يد المفكر ميشيل فوكو في مؤتمر له بعنوان “المراقبة الرأسمالية للجسد” بجامعة ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1974، ثم توسّع في طرحه للمصطلح في سلسلة محاضراته التي ألقاها في “الكوليج دو فرانس” خلال الفترة ما بين 1975 و1976 والتي كانت بعنوان “يجب الدفاع عن المجتمع”، وعمّق معالجته لهذا المفهوم أكثر في محاضراته التي قدّمها في المعهد نفسه بين عامي 1978 و1979، والتي حملت عنوان “مولد السياسة الحيوية”.[3]
ويقصد بالسياسة الحيوية، كما صاغها فوكو، أنها نمط من أنماط ممارسة السلطة يركّز على إدارة الحياة البشرية وضبطها وتنظيمها على مستوى السكان، وذلك من خلال التحكم في حركة الجسد وتنظيمه عبر سياسات الصحة، وتنظيم الولادات، وإدارة الوفيات، وحركة السكان، وإدارة المدن، وغيرها من التدابير، فهو مفهوم يوصف بأنه تعبير عن علاقة متلازمة بين السياسية والحياة.[4] والجسد هنا في تلك الحالة يشكّل موضع التحكم ومجال ممارسة السلطة وضبطة، ومن خلاله تنظم الحياة كاملة. فعلى سبيل المثال، نجد أن بعض الدول تضع سياسات محدده لغرض تقليل أو زيادة أعداد الولادات لدى مواطنيها، وهو بذلك يُعد عملية ضبط للحياة ولجسد الفرد، وهذا ما نعنيه بالسياسة الحيوية. ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا الاهتمام الزائد بالحياة البيولوجية وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية لم يحدث في لحظة استثنائية، بل هو نتاج متراكم للتطورات المختلفة التي حدثت في هذه المجالات، أي مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية. فمع تطوّر العلوم الطبية وهيمنة المصطلحات والنظريات البيولوجية على العالم، مثل النظرية الداروينية وغيرها، أصبح من المهم النظر إلى المساحات البينية التي تلاقت فيها العلوم الطبية والطبيعية مع العلوم الاجتماعية، وهو ما أولاه فوكو اهتمامًا خاصةً وركز عليه في تحليلاته، والتي توصّل من خلالها إلى مفهوم “السياسة الحيوية” أو “السلطة الحيوية”.[5]
ميز ميشيل فوكو في تحليله لظهور السياسة الحيوية بين مرحلتين تاريخيتين أساسيتين؛ تتمثل المرحلة الأولى في الفترة التي سبقت القرن السابع عشر، حيث سادت أنماط السلطة السيادية التقليدية التي ارتكزت على حق الحاكم في منح الحياة أو إزهاقها، أي التحكم في سلطة . ومن ثم حدثت العديد من التحولات في مفاهيم السلطة وتنظيم الأفراد والحياة خلال القرن السابع عشر، والتي نقلتنا إلى المرحلة الثانية، وهي الفترة التي أعقبت القرن الثامن عشر، حيث ظهرت آليات السياسة الحيوية أو السلطة الحيوية بشكلها الحديث، والتي تركز على إدارة الحياة وتنظيمها على مستوى السكان، وجعل الحياة نفسها موضوعًا للسياسة والسلطة.
فوكو كان يرى أن السلطة السياسية الحديثة أصبحت تعتمد على آليات ضبط الجسد وتحسينه أكثر من اعتمادها على آليات الإماتة والحياة. قديمًا، كانت السلطة تعتمد على ثنائية الموت والحياة في السيطرة على أجساد الأفراد، أو ما يُعرف بـ”سلطة الملك” التي تقرر من يعيش ومن يموت. أما حديثًا، وفي ظل النظام الرأسمالي الحديث، أصبحت السلطة تهتم بتنظيم وتحريك جسد الفرد من أجل الاستفادة منه والحفاظ عليه، وذلك لاستغلال أقصى طاقاته الكامنة وعدم إهدارها. السلطة هنا تمارس سيطرتها على الفرد من خلال تنظيم حياته اليومية وتغلغلها في مختلف شؤون المجتمع، حيث بدأت تتعامل مع السكان بإعتبارهم “جسدًا أو كيانًا جماعيًا” يجب تنظيمه وإدارته بيولوجيًا، على خلاف السلطة التقليدية التي كانت تعتمد فقط على ثنائية الموت والحياة في آلية السيطرة على الأجساد.[6]
يرى فوكو أن ثنائية الموت والحياة قد تعود مرة أخرى في بعض الحالات؛ إذ اعتبر أن السلطة الحديثة قد تعتمد في أستخدامها لهذه الثنائية على الحالة البيولوجية أو العنصرية أو العرقية للإنسان، فتعود السلطة في هذه الحالة إلى استخدام آليات الموت في السيطرة، وهو ما يتحقق على سبيل المثال في الحالة النازية في إبادتها للأعراق الأخرى الأدنى من العرق الاري أو الجرماني. وعلى الرغم من أن فوكو لم يذكر صراحةً أن هذه السياسات قد تعود في السياقات الاستعمارية، إلا أن المفكر والكاتب الجزائري الزواوي بغورة أشار في كتابه “معاينة منزلة السياسة الحيوية في الفلسفة السياسية المعاصرة” إلى أن هذه السياسات قد تُشكّل منهجية أساسية يُمارسها المستعمِر ضد الشعوب المستعمَرة، وهو ما يتجلّى بوضوح في الحالة الفلسطينية على سبيل المثال.[7]
وبناءًا على ذلك، يصبح من الضروري تجاوز الطرح الفوكوي والنظر إلى التطويرات التي شهدها مصطلح ” السياسية الحيوية”، وكان من أشهر من طوروا هذا المصطلح هو المفكر الإيطالي جورجيو أغامبين، الذي تجاوز الطرح الفوكوي في تحليلة للعلاقة بين السلطة والحياة، وذلك من خلال مفهومه عن “الحياة العارية” و”حالة الاستثناء”.
بينما ركز فوكو على آليات تنظيم الحياة، سلط أغامبين الضوء على على الكيفية التي تُنتج بها السلطة الحديثة أشكالاً من الحياة تُستثنى من الحماية القانونية، ويشرعن من خلالها القتل، وتُترك عرضة للموت، دون أن تُعد قتلاً بالمعنى القانوني. حيث رأى أغامبين أن السلطة لا تعتمد بشكل كامل على تنظيم وتنمية حياة كافة الأفراد، بل رأى إن ثنائية الحياة و الموت في فلسفة السلطة ما زالت قائمة وأن السلطة الحيوية ما هي إلا شكل من أشكال سلطة سيادية ولكن بتكوين جديد، على عكس ما طرحه فوكو بشأن تحول السلطة من شكلها السيادي إلى شكلها الحيوي وحدوث تحول نوعي في شكل السلطة، وأن السلطة تعيد إنتاج تلك الثنائية وتستدعيها في الزمان والمكان اللذين تراهما مناسبين، وفي خلقها لحالة الإستثناء.[8]
وبناءًا على ذلك، نجد أن هذا الإطار الجامع بين السياسية الحيوية عند فوكو، وحالة الإستثناء عند أجامبين، أكثر قدرة على تفسير الأوضاع الاستعمارية والاحتلالية، كما في السياق الفلسطيني، حيث تُمارَس السيادة من خلال تحويل الحياة إلى حالة دائمة من الطوارئ، ومن الفصل بين من يُسمَح له بالحياة ومن يُترك للموت. فالإنسان في هذا السياق يتحوّل إلى ما يمكن وصفه بـ”الإنسان المستباح”، أي الإنسان الذي تُسلب منه إنسانيته وتُختزل وجوديته في بعدٍ بيولوجي صرف، مجرد من المعنى والتاريخ والحقوق. ويجسد الاحتلال الإسرائيلي هذا النمط من الاستباحة عبر سياساته وممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، يمكن إعادة تأويل مفهوم السياسة الحيوية بوصفه فعلًا إيجابيًا يقوم على تنظيم وإدارة الجسد لتحقيق أقصى استفادة منه، ليصبح فعلًا سلبيًا يقوم على تنظيم وقتل الجسد بشكل احترافي، وهو ما يمكن تسميته بـ “السياسة الحيوية السوداء” وهي الأقرب لفكرة “سياسات الموت” التي صاغها المفكر الكاميروني أشيل مبيمبي. وهذه السياسة تُمارَس عادةً من قِبل الدول الاستعمارية لتصفية خصومها من الشعوب المستعمَرة، وهو ما يتجلّى بوضوح في ما يحدث في غزة منذ أكتوبر 2023، من قتل ممنهج وإبادة منظمة، باستخدام وسائل مختلفة من تنظيم وإدارة للموت، والتي سوف نتعرف عليها بشكل أعمق في الجزء التالي.
ثانيًا: غزة مختبر للسياسية الحيوية الاستثنائية
تجسّد غزة حاليًا مختبرًا للتجارب البشرية الدموية، إذ بات من الواضح أن ما يحدث فيها الآن من قتل ممنهج وتجويع مستمر أمر غير معقول. فقد أصبح تنظيم الجسد الفلسطيني متمحورًا حول الفناء الإنساني، وصار جسده موضع تحكّم وسيطرة وقتل. فالسلطة الإسرائيلية تحاول، من خلال سياساتها الحالية، خلق حالة استثنائية للجانب الفلسطيني، تُنكر من خلالها ذاته الموجودة في حيّزه المكاني، وتمحو من خلالها هويته الفلسطينية، بدايةً من إنتاج خطاب معرفي يحمل في طيّاته دلالات محددة لشرعنة العنف الممارَس في غزة، مثل اتهام الجانب الفلسطيني بالوحشية ووجوب تصفيته، والترويج لفكرة أن إسرائيل تقوم بكل تلك العمليات من أجل حماية شعبها وأمنها وبغرض تحقيق السلام، ووصولًا إلى تحويل الجسد الفلسطيني إلى موضوع دائم للعنف والسيطرة، وإبقائه في حالة وجود استثنائي على هامش الحياة.
فهي بذلك تحوّل الإنسان الفلسطيني إلى الإنسان الZoe[9]، وهو مفهوم أرسطي أعاد أجامبين صياغته في مفهوم جديد، ليشير إلى الإنسان العاري المستثنى من كل القوانين، والمختزل في مجرد تكوين بيولوجي منزوع المعنى.
ومن خلال تلك العملية، يصبح قتل الفلسطينيين أمرًا مباحًا ومُبرَّرًا في نظر المنظومة الصهيونية وبالطبع، فإن هذه العملية تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة، ضمن إطار سياسات مدروسة تجمع بين العنف المادي والإبادة المعنوية، بما يضمن استمرار حالة الاستثناء وإطالة أمد السيطرة، حيث تُستهدف المراكز الحيوية والصحية باستمرار، في إطار عملية منظمة لضرب منظومة الصحة واستهداف الأجساد. وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية على الاستهداف الدائم والمستمر للمجمعات الطبية والمستشفيات، مثل مستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة وغيرها، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بمحاصرة المستشفيات بالدبابات وقصفها، مدّعية أنها تُستخدم لأغراض عسكرية، وهو ما يُشكّل حالة استثناء تُنزَع من خلالها الصفة القانونية عن تدمير المنظومة الصحية الفلسطينية. كما يعمد الاحتلال إلى قصف منشآت الطاقة، وتدمير الأفران والمخابز، وبالطبع المساكن والابراج الرئيسية في قطاع غزة، وقصف البنية التحتية في غزة مثل الصرف الصحي، ومناطق تحلية المياة، وتحويل الممرات الآمنة إلى ممرات للموت والقنص، وجعل كل وسائل الحياة والسبل إلى البقاء شبه مستحيلة، مما يدل على أن الاحتلال يستخدم سياسات حيوية سوداء من أجل القضاء على الحياة في قطاع غزة، وتدمير كافة المؤسسات التي تساهم في تنظيم الحياة وتنميتها.[10] وبذلك، نجد أن الاحتلال الإسرائيلي جعل من حالة الاستثناء في غزة هي الحالة الأساسية والدائمة، ولم تعد مجرد حالة مؤقتة كما يفترض أن تكون.
وفي السياق ذاته، يتجلّى هذا النهج بوضوح في مسألة توزيع المساعدات في غزة، والتي تتم بطريقة مدروسة تُحدِّد مسار الفلسطينيين وتوجّههم نحو حتفهم. وتُنفَّذ هذه الآلية عبر ما يُعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية” التي أعلنت عنها إسرائيل كبديل “لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)”، والتي حظرت الحكومة الإسرائيلية عملها في يناير الماضي. ولقد أُنشئت هذه المؤسسة في فبراير 2025 تحت رعاية أمريكية وبالتعاون مع السلطات الإسرائيلية لغرض توزيع الغذاء والمساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أنها وُصفت بعدم الحياد بسبب الأساليب والآليات التي تعتمدها في عملية التوزيع.[11]
حيث أن هذه الآليات تعكس الخلفية السياسية والغرض التي تقف وراءها بوضوح، ففي بداية عمل المؤسسة، أنشأت مركزين لتوزيع المساعدات في تل السلطان وممر موراغ جنوب قطاع غزة، ثم أُعلن لاحقًا عن منطقتين إضافيتين في رفح ومخيم البريج وسط القطاع، إلا أنها أغلقت فيما بعد اثنين من هذه المراكز. غير أن القضية الجوهرية هنا لا تكمن في عدد المراكز أو توقيت افتتاحها وإغلاقها، بل في أماكن توزيع المساعدات وسبل الوصول إليها.
جميع هذه المراكز تقع في مناطق مدمَّرة ومسيطر عليها بشكل كامل من قبل الجيش الإسرائيلي، وتتمركز داخل مناطق تُعرف بـ”الدائرة الحمراء” التي تعد في الأساس مناطق شديدة الخطورة. وللوصول إليها، يتعيَّن على الفلسطينيين عبور مناطق تشهد اشتباكات فعلية وإطلاق نار، والسير لمسافات طويلة وسط أنقاض وركام، مع انعدام وسائل النقل الآمنة التي أصبحت شبهه معدومة في غزة، والتعرض المباشر لخطر القصف أو الاستهداف من القناصة الإسرائيلية، وهو ما يجعل عملية الحصول على المساعدات في حد ذاتها رحلة محفوفة بالموت والمخاطر، تفرضها سياسة مدروسة تُحوِّل الإغاثة إلى أداة للسيطرة والإذلال للجسد الفلسطيني.[12]
الجدير بالذكر أن هذه المراكز صُممت لتكون أشبه بالمنشآت العسكرية، إذ تفرض طرق محدده بممرات طويلة وضيقة لتتحكم في حركة الجسد الفلسطيني، وهو ما يسهل عملية الاستهداف والقتل. وفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل نحو 1400 فلسطينيًا أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة أو محاولة الحصول عليها منذ أواخر مايو. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذه المراكز بدلًا من أن تكون نقاط إنقاذ وإغاثة، تحوّلت إلى فضاءات قاتلة.[13] ولكن ليس من المدهش أن تكون حالات القتل أثناء عملية توزيع المساعدات استثنائية، فغزة كلها أصبحت في حالة استثناء دائمة، حيث تمارس عمليات القتل بشكل يومي، مع استهداف متكرر لنفس المناطق، الأمر الذي ينزع تمامًا ذريعة الخطأ التي يدّعيها الاحتلال الإسرائيلي. على سبيل المثال، تعرّضت مناطق مثل حي الشجاعية ومحيط مستشفى الشفاء ورفح الشرقية لقصف متكرر خلال فترات زمنية قصيرة، رغم خلو بعضها من أي تغيّر في الواقع الميداني، ما يؤكد أن الاستهداف يتم بشكل مقصود لغرض القتل وليس أكثر.[14]
كما أن عمليات استهداف المواطن الفلسطيني نفسها تثبت أنها لا تحدث بالخطأ أو بشكل عشوائي، بل تُمارس بشكل ممنهج مع تركيز على إصابة واستهداف أجزاء محددة من الجسد. ففي تحقيق أجرته صحيفة The Guardian، تبيّن وجود نمط واضح في هذه الاستهدافات. وفي مقابلة أُجريت مع البروفيسور نيك ماينارد، الجراح الاستشاري في مستشفى جامعة أكسفورد، لاحظ أن هناك تراكمًا واضحًا لإصابات متشابهة في الأيام التي تجري فيها توزيع المساعدات والطعام على الفلسطينيين، مثل الطلقات التي تصيب الرقبة أو الرأس أو الذراعين أو الأطراف عمومًا. وهو ما يهدف إما إلى القتل بشكل كامل ومباشر، أو إلى إعاقة الجسد وتخريبه وإفساده بحيث يصبح غير قادر على المقاومة أو العيش بشكل طبيعي مرة أخرى.[15] وفي ذلك يتحقق ما يسعى إليه الإحتلال الإسرائيلي من خلق مجتمع فلسطيني غير قادر جسديًا. غير أن الاحتلال الإسرائيلي، بالطبع يتحكّم في مواقيت ومواعيد دخول وخروج المساعدات، وفي حركة القوافل الإنسانية، وكذلك في الممرات التي تتحرك فيها هذه القوافل، الأمر الذي يعكس حجم السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الشرايين الحيوية لغزة ويجعل هذا التحكم الزمني والمكاني للمساعدات أداة إضافية لفرض الحصار قاتل على قطاع غزة.
مما سبق يمكن القول، إن ما يجري على أرض غزة، من قتلٍ ممنهج، وتجويعٍ متعمد، واستهدافٍ متكرر للمراكز الحيوية والمستشفيات ومرافق البنية التحتية، وصولًا إلى تحويل المساعدات الإنسانية ذاتها إلى مصيدة للموت، يكشف وبحق لنا عن منظومة استعمارية لا تكتفي بإدارة الحياة أو ضبطها، بل تتعمد إنتاج الموت كجوهر أساسي لسياساتها. ولقد أظهرت المشاهد المؤلمة سالفة الذكر، ان الجسد الفلسطيني يُختزل إلى مجرد وجود بيولوجي خالص منزوع المعنى، خاضع للتحكم والسيطرة والإبادة المادية والمعنوية.
وختامًا، سعى هذا المقال إلى تحليل ما يحدث في غزة من قتل وإبادة باستخدام أدوات ميشيل فوكو وجورجيو أغامبين في تفسير السياسة الحيوية وفهم حالة الاستثناء التي يعيشها الشعب الفلسطيني. لكن يبدو أن ما يجري على أرض غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 يتجاوز كل الأطر النظرية المعتادة في التحليل؛ فهذه المجازر المستمرة لا يمكن الإحاطة بها من خلال منظور مفكر أو اثنين، بل تستلزم بناء منظومة فكرية متكاملة قادرة على استيعاب وفهم الآليات المختلفة التي يوظفها الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين، وهو ما قد يتضح بصورة أعمق بعد انتهاء الحرب.
[1] ميشيل فوكو هو فيلسوف ومؤرخ أفكار فرنسي، يُعد من أبرز مفكري القرن العشرين، اشتهر بتحليله للعلاقة بين السلطة والمعرفة، ودراساته حول أنظمة المراقبة والانضباط والسياسة الحيوية. ركز في أعماله على كيفية تشكّل الحقيقة عبر الخطابات والمؤسسات مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، ومن أبرز كتبه “المراقبة والعقاب” و”تاريخ الجنسانية” و”مولد السياسة الحيوية”.
ألمصدر: وسف الصمعان، “ميشيل فوكو”، حكمة، 5 نوفمبر 2017، https://hekmah.org/فوكو/
[2] جورجيو أغامبين هو فيلسوف إيطالي معاصر، عُرف بأعماله في الفلسفة السياسية والنظرية النقدية، وتأثره بمدرسة الفكر القاري وبخاصة هايدغر وبنيامين وفوكو. يشتهر بتحليله لمفهوم “حالة الاستثناء” وكيف تتحول من إجراء قانوني مؤقت إلى أداة دائمة للحكم، وبفكرته عن ‘الحياة العارية’ التي تشير إلى الإنسان الذي يُستبعد من الحماية القانونية ويصبح عرضة للإقصاء أو التجريد من حقوقه الأساسية أو القتل دون أن تُعتبر هذه الأفعال جريمة أو تضحية. تناول أغامبين أيضًا قضايا السيادة، واللغة، واللاهوت السياسي، وأثر بشكل واضح في مختلف الدراسات التني تناولت مفاهيم السلطة والقانون.
Source: “Giorgio Agamben.” Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/agamben
[3] د.نيرة محمد علوان، “السياسية الحيوية وحالة الاستثناء-دراسة اجتماعية تطبيقية على الحرب في غزة: مابين الحياة والموت”، المجلة العربية لعلم الاجتماع، مج 18، ع36، 2025، ص78. السياسات الحيوية وحالة الاستثناء “دراسة اجتماعية تطبيقية على الحرب في غزة : ما بين الحياة والموت”
[4] عامر شطارة، دعاء نصر، “مفهوم السياسات الحيوية بين ميشيل فوكو وجورجيو أغامبين”، مجلة تبين للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، مج 10، ع 40، 2022، ص97-98. tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue040/pages/art05.aspx
5 Leonard D’Cruz, “Foucault’s Naturalism: The Importance of Scientific Epistemology for the Genealogical Method,” Philosophy & Social Criticism, 2024, https://doi.org/10.1177/01914537241235571.
[6] عامر شطارة، دعاء نصر، مرجع سبق ذكره، ص97-99.
[7] د.الزواوي بغورة، “منزلة السياسية الحيوية في الفلسفة السياسية المعاصرة: دراسة تحليلية نقدية”، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مج 35، الرسالة 351، 2012، ص45-48. منزلة السياسة الحيوية في الفلسفة السياسية المعاصرة – دراسة تحليلية نقدية. | حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية
8 Amy O’Donoghue, “Sovereign Exception: Notes on the Thought of Giorgio Agamben,” Critical Legal Thinking, July 2, 2015, accessed August 9, 2025. Sovereign Exception: Notes on the Thought of Giorgio Agamben
[9] يشير مصطلح Zoe في اللمفهوم الأرسطي، أي في فلسفة أرسطو، إلى الحياة البيولوجية المحضة، وهي التي تتمثل في مجرد الوجود الحي والوظائف الطبيعية المشتركة بين جميع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وبشر، مثل الأكل والنوم والتكاثر وغيرها من الوظائف.. وقد ميّز أرسطو بين هذا النوع من الحياة وبين النوع الأخر وهو الBios، الذي يدل على الحياة الإنسانية المؤهلة للنشاط البشري المميز، حيث ينخرط الإنسان في النشاط السياسي والأخلاقي والفكري داخل المجتمع. وبذلك، يمثّل الإنسان كـZoe كائنًا حيًا فقط، بينما كـBios يصبح كائنًا عاقلًا يحقق غايته من خلال حياة راقية قائمة على القيم والمعايير الأخلاقية.
[10] د.نيرة محمد علوان، مرجع سبق ذكره، ص93-98.
[11] “ما هي مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل”، BBC بالعربي، 30 مايو 2025، تاريخ الوصول 10 أغسطس 2025. ما هي مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل؟ – BBC News عربي
[12] “مراكز توزيع المساعدات ساحات قتل جماعي للمجموعين في غزة”، الجزيرة، 4 أغسطس 2025، تاريخ الوصول 10 أغسطس 2025. “مراكز توزيع المساعدات” ساحات قتل جماعي للمجوّعين في غزة | الموسوعة | الجزيرة نت
13 Wafaa Shurafa, Fatma Khaled and Natalie Melzer, “Dozens killed seeking aid in Gaza as Israel weighs further military action”, August 6, 2025, accessed August 9, 2025. Dozens killed seeking aid in Gaza as Israel weighs further military action | AP News
[14] “مستشفى الشفاء بعد 22 شهرًا من الحرب: غرف مدمّرة وطبابة معدومة وطاقم يصارع للبقاء”، euro news، 6 أغسطس 2025، تاريخ الوصول 10 أغسطس 2025. مستشفى الشفاء بعد 22 شهرًا من الحرب: غرف مدمّرة وطبابة معدومة وطاقم يصارع للبقاء | يورونيوز
15 Manisha Ganguly, “’A Deadly Scheme’: Palestinians Face Indiscriminate Gunfire at Food Sites,” The Guardian, August 9, 2025, accessed August 10, 2025, ‘A deadly scheme’: Palestinians face indiscriminate gunfire at food sites | Gaza | The Guardian
باحث مساعد في النظم و النظرية السياسية بمركز ترو للدراسات والتدريب